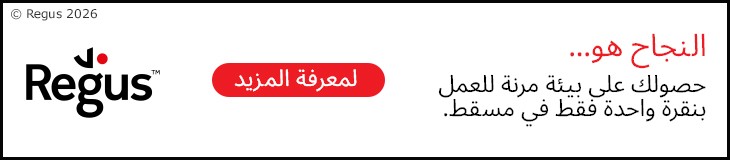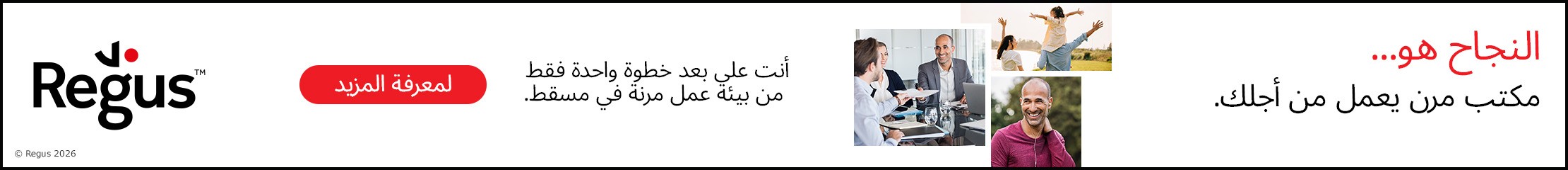خالد بن حمد الرواحي
غيَّرت جائحة "كوفيد-19" قبل 5 سنوات ملامح حياتنا؛ ففتحت الباب أمام تجربة غير مألوفة، وهي العمل عن بُعد. لم يكن أحدٌ يتصور أن يتحوّل بيته إلى مكتب، وأن يؤدِّي مهامه بين ضحكات أطفاله أو صخب المطبخ، مرتديًا ملابس بسيطة بعيدًا عن الرسميات. واليوم، وبعد زوال الظروف الاستثنائية، يظل السؤال قائمًا: هل انتهت التجربة بانتهاء الجائحة، أم أنها بداية لمرحلة جديدة في عالم الإدارة؟
لقد حملت التجربة وجوهًا مُتباينة؛ فبعض الموظفين وجدوا فيها فرصة للاقتراب من أسرهم ومشاركة أبنائهم تفاصيل يومهم، بينما رأت الأمهات فيها مُتنفسًا يجمع بين رعاية الأسرة والعمل بمرونة. لكن في المقابل، واجه آخرون جانبها المُرهِق؛ إذ اختفت الحدود بين العمل والراحة، وتحول البيت إلى مكتب لا ينطفئ. يقول أحد الموظفين: "كنت أفتح حاسوبي منذ الصباح ولا أغلقه إلا بعد منتصف الليل، شعرت أنني أعمل أكثر مما لو كنت في المكتب".
ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التباين على النقاش الإداري؛ فلم يعد الحضور إلى المكتب معيارًا وحيدًا للإنتاجية؛ إذ أظهرت بعض المؤسسات تحسنًا في الأداء رغم غياب الموظفين، بينما برزت مخاوف من ضعف الرقابة وصعوبة بناء روح الفريق. وهنا ظهر مفهوم «الإدارة الهجينة»، التي تجمع بين العمل من المنزل والحضور الجزئي، لكنها لن تنجح ما لم تُبنَ على الثقة والنتائج، لا على مؤشرات الحضور والانصراف.
وفي هذا السياق، جاءت خطوة وزارة العمل لتمنح التجربة إطارًا مُنظَّمًا؛ فقد أصدرت الوزارة ضوابط واضحة للعمل عن بُعد، وحدَّدت نسب التطبيق وربطتها بطبيعة الوظيفة، مع إعطاء الأولوية للحالات الصحية والاجتماعية. كما شددت على أن التجربة ليست حقًا مُكتسبًا؛ بل تخضع للتقييم والرقابة. وتُحسَب للوزارة هذه المبادرة التي تعكس وعيها بضرورة الموازنة بين راحة الموظف ومصلحة العمل، وضمان أن تسير التجربة وفق معايير مؤسسية مدروسة.
ومع انتقال النقاش من أروقة المكاتب إلى واقع الناس، برزت معاناة بعض المراجعين الذين واجهوا تأخرًا في إنجاز معاملاتهم بسبب غياب موظف أو انتظار توقيع مدير. هذه المواقف أبرزت الحاجة إلى تفويض الصلاحيات، حتى لا تتوقف مصالح المواطنين على شخص واحد، وإلى تطوير الخدمات الإلكترونية بما يتيح إنجاز المعاملات في أي وقت ومن أي مكان؛ فنجاح أي تجربة إدارية لا يُقاس براحة الموظف وحدها؛ بل بمدى سلاسة الخدمة التي تصل إلى المجتمع.
وإلى جانب البُعد الإداري والخدمي، ظهر أثر التجربة على الاقتصاد بشكل أوضح؛ فقد ساعد العمل عن بُعد على خفض النفقات التشغيلية للمؤسسات الخاصة والجهات الحكومية؛ مما ساهم في تقليل الضغط على البنية التحتية وترشيد استهلاك الطاقة. أما المواطن، فقد لمس الأثر المباشر في تراجع تكاليف التنقل والمواصلات؛ مما منحه قدرة أكبر على تلبية احتياجات أسرته أو تطوير نفسه.
كما فتحت التجربة أبوابًا جديدة أمام الأفراد أنفسهم؛ فقد استغل كثيرون مرونتهم لإطلاق مشروعات صغيرة عبر الإنترنت، أو دخول مجالات العمل الحر، أو حتى تحويل هواياتهم إلى مصدر دخل. وهذا الحراك عزّز روح ريادة الأعمال، وفتح للشباب آفاقًا أوسع للتوظيف الذاتي؛ بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
وتزداد أهمية العمل عن بُعد حين نضعه في سياق رؤية "عُمان 2040"، التي جعلت من التحول الرقمي ركيزة أساسية؛ فالعمل المرن لم يعد مجرد استجابة لطارئ عابر؛ بل أصبح جزءًا من مسار وطني نحو حكومة رقمية أكثر كفاءة، ومدنٍ ذكية تُدار خدماتها إلكترونيًا وتصل بسهولة إلى كل مواطن. وهنا لا يقتصر المكسب على خفض التكاليف أو تقليل الازدحام، بل يمتد ليعزز العدالة في توزيع الفرص وجودة الحياة في مختلف المحافظات.
وعلى المستوى الدولي، تباينت التجارب؛ فبعض الدول اعتمدت النظام الهجين كخيار دائم، بينما عادت أخرى بسرعة إلى المكاتب، معتبرة أن التواصل المباشر لا غنى عنه لبناء فرق متماسكة. وهذا التباين يوضح أن العمل عن بُعد ليس وصفة عامة، بل خيار يتشكل وفق خصوصية كل مجتمع، وما يناسب عُمان لا يشبه بالضرورة ما يناسب غيرها.
ويبقى السؤال مفتوحًا: الموظف الذي بدأ يومه أمام شاشة في منزله بدلًا من مكتبه التقليدي، هل سيواصل هذه التجربة مستقبلًا، أم يعود إلى رحلته الصباحية اليومية بين البيت والمكتب؟ ربما لا تكمن الإجابة في أين يعمل الإنسان، وإنما في كيف يعمل، وفي القيمة التي يتركها في حياته وحياة من حوله. وما بين المكتب الواقعي والمكتب الافتراضي، تبقى الحقيقة واحدة: أن الإنسان هو جوهر العمل، وأن أي نظام إداري ناجح لا بُد أن يضع راحة هذا الإنسان وإبداعه في قلب المعادلة.