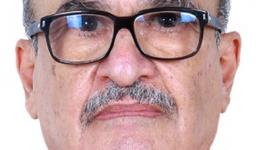بدر بن خميس الظفري
@waladjameel
يُعد النظام الطبقي في الهند، المعروف باسم "الفارنا"، أحد أقدم أشكال التراتب الاجتماعي المُنظم في التاريخ. يقوم هذا النظام العنصري على تقسيم المجتمع إلى فئات محددة تُورث بالولادة، ولا يُمكن للإنسان أن يتنقل بين الطبقات طوال حياته.
ويتحدَّد موقع الفرد في هذا النظام بناءً على طبقته الأصلية التي يولد فيها، وليس وفق كفاءته أو جهده. وهذا النظام ما يزال أثره ممتدًا في الواقع الهندي حتى اليوم، رغم التغييرات السياسية والدستورية التي عرفتها البلاد.
يرى الدكتور أحمد شلبي في كتابه "أديان الهند الكبرى" أنَّ هذا النظام يتكوّن من أربع طبقات رئيسية: البراهمة، وهم طبقة الكهنة والعلماء، يليهم الكشاتريا، وهم الملوك والمحاربون. ثم الفيشيا، طبقة التجار والمزارعين. وأخيرًا الشودرا، وهم طبقة الخدم والعمال. ويوجد خارج هذه المنظومة من يُعرفون بـ"المنبوذين" أو "الداليت"، وهم فئة لا يُعترف لها بمكانة في هذا البناء الاجتماعي، وتُقصى من كافة مظاهر الحياة العامة. يُمنعون من دخول المعابد، ويُحظر عليهم لمس أواني الطعام الخاصة بالطبقات الأخرى، ويُجبرون على العيش في أطراف القرى، ولا يُسمح لهم بالمشاركة في أي فضاء مشترك.
يذكر شلبي أن شريعة "منو" تعد المصدر التشريعي الأهم لهذا الترتيب، ويورد نصوصا عنصرية منها؛ فعلى سبيل المثال، تنص "منو" على أنّ "كُلّ ما في العالم ملك للبرهمي، وله حق في كل موجود"، وورد فيها أن "البرهمي لا يُدنّس ولو قتل العوالم الثلاثة"، بينما يخضع أبناء الطبقات الدنيا لعقوبات قاسية إن خالفوا مواضعهم. أحد نصوص هذه الشريعة يقرر أنَّ من ينطق باسم طبقة عليا دون إذن "يُدخل إلى فمه خنجر مُحَمّى"، ومن يعترض على مرتبته "يُصب الزيت الحار في فمه وتُفقأ أذناه". الأسماء نفسها تَحمِلُ دلالات طبقية، فيُطلب أن يُسمّى البراهمة بأسماء تدل على السعادة والسكينة، بينما يُعطى الشودرا أسماء تحمل معاني العبودية. هذا الإطار لم يُطرح كتوصية أخلاقية، بل شُرِّع كقانون يُنظّم المجتمع ويضبط حدوده الطبقية بدقة.
وتُبيّن الباحثة زينب رحمت الله في رسالتها "الآخر في الفكر الهندوسي وآفاق الحوار" أن الأساس الفلسفي لهذا النظام يتمثّل في مفهوم "الدارما"، أي الواجب الطبقي؛ حيث يُلزم كل فرد بأداء وظيفة محددة سلفًا وفق طبقته. فالبرهمي يُدرِّس ويُفتي، والكشاتريا يحكم ويحارب، والفيشيا يتاجر ويزرع، أما الشودرا فيخدم الجميع. ويُربّى الإنسان على قَبول هذه الأدوار بوصفها قدَرًا مكتوبًا، ويُمنع من الطموح خارجها، ويُعدُّ التعديَ عليها مخالفة للتوازن الكوني.
وتؤكد رحمت الله من خلال شهادات ووقائع أن هذا النظام تجاوز الكتب والشرائع إلى الحياة اليومية؛ فالداليت يُجبرون على مسح آثار أقدامهم، ويُعلَّق على أعناقهم أوعية لجمع بصاقهم، ويُمنعون من ارتداء الأحذية في بعض القرى، أو من استخدام الآبار المشتركة. وتُسجَّل حالات لفتيات حُرمن من الدراسة بسبب لمس زهرة في حديقة تابعة لطبقة أعلى، وأخرى لرجال ضُربوا لأنهم لمسوا ممتلكات لا تليق بموقعهم الاجتماعي. هذه المظاهر ما زالت حاضرة في مناطق ريفية، رغم التحديث والدستور والقوانين التي ترفضها نظريًا.
حاول المهاتما غاندي أن يُعالِج هذه الفجوة الاجتماعية من خلال إطلاق اسم "هاريجان" على المنبوذين، ودعا إلى تحسين معاملتهم، غير أن مشروعه ظل ضمن حدود الدعوة الأخلاقية. على الجانب الآخر، قاد أمبيدكار، وهو من أبناء هذه الفئة، حركة فكرية احتجاجية أكثر حدة، ودعا إلى تمزيق شريعة "منو"، واعتنق البوذية تعبيرًا عن خروجه من المنظومة الهندوسية التي كرّست التمييز، ودعا إلى بناء دولة عادلة تساوي بين المواطنين دون النظر إلى أصولهم الطبقية.
ورغم إلغاء النظام الطبقي رسميًا في الدستور الهندي، ما تزال البنية الثقافية للمجتمع تحتفظ به في عمقها؛ فالحصص التعليمية والوظيفية التي خصصتها الحكومة للداليت لم تُلغِ النظرة المجتمعية المتجذرة. وتقوم حركات مثل "الهندوتوا" بإعادة إنتاج التراتب الطبقي ضمن مشروع قومي ديني، يضع الداليت، والمسلمين، والمسيحيين، خارج إطار الهوية النقية للهندوسية.
وتُظهر التجربة الهندية كيف أنّ النصوص القديمة يمكن أن تتحول إلى مرجعية تُشرعن التفوق الاجتماعي، تترسخ من خلال نصوص وطقوس وتفسيرات تُقنع الأفراد أن مواقعهم الطبيعية محددة من الخالق. وتكمن خطورة هذا النوع من البناء في أن التمييز يترسّخ في الضمير، ويُقدَّم في ثوب ديني وتاريخي يصعب مقاومته.
في مجتمعات أخرى، وضمنها مجتمعات مسلمة، استُخدمت تفسيرات دينية لخدمة التمايز الطبقي أو القبلي. وجرى تأويل بعض النصوص أو اقتطاعها من سياقها لتبرير الهيمنة والنفوذ، واحتقار من لا ينتمون إلى الأسر أو القبائل ذات الحضور الاجتماعي. وحين تستحضر النصوص الإسلاميّة لتبرير الحصول على امتيازات طبقيّة، تتحول الرسالة الإسلاميّة من دعوة إلى المساواة إلى غطاء ثقافي للتفاوت والاستعلاء. ومن ذلك ما ورد في مسند الربيع بن حبيب من رواية تنسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها: "الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة: المولى والحجّام والنسّاج والبقّال". ونحن ننزه رسول الإنسانية والرحمة من أن يتفوه بهذا الكلام العنصري، لأنه لا يمكن أن يناقض كلامه وهو القائل: "يَا أَيها النَّاس، أَلا إنَّ ربكم واحد، وإِنّ أَباكم واحد، أَلَا لا فضْل لِعرَبِي على أعجمِي، ولا لِعَجمي على عربِي، ولا لأَحمرَ على أَسود، ولا أسود على أحمرَ إلّا بِالتقوى".
في حضرة هذه الأفكار العنصريّة، يتوارى المعنى الإنساني، ويعلو صوت الطبقيّة الذي يجعل من الإنسان رقمًا في سجل النسب، لا كائنًا واعيًا له إرادة وقدرة ومقام.
إنّ الكرامة لا تُولد مع الدم، ولا تسكن في الاسم؛ بل تُكتسب بالصبر والسعي والعدل. والمجتمعات التي ترهن الاحترام للقبيلة، وتُقيم الحواجز بين الناس على أساس الأصول، تمضي نحو الظُلَمِ مهما رفعت شعارات العدالة والحرية.