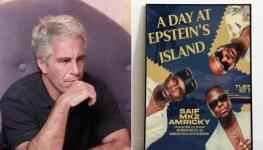عبدالرحمن السالمي
يُمثِّل كتاب "الاستشراق" لإدوارد سعيد علامة فارقة في دراسة الإسلام والشرق داخل الأكاديميا الغربية منذ صدوره قبل قرابة نصف قرن عام 1978؛ إذ أحدث تحولًا جذريًا في فهم العلاقة بين المعرفة والسلطة، ولم يقتصر تأثيره على نقد الدراسات الاستشراقية التقليدية فحسب، بل امتد ليشمل أسس إنتاج المعرفة نفسها وعلاقتها بالسياق الاستعماري.
ومع ذلك، كان انتقال أفكار سعيد إلى الجامعات العربية عملية غير مباشرة وغير متجانسة، متأثرة بخصوصيات معرفية وثقافية ومؤسسية، ما جعل حضور سعيد في العالم العربي حضورًا إشكاليًا ومركبًا، إذ بينما استُقبل مشروعه في الغرب كجزء من دراسات ما بعد الاستعمار وأسهم في إعادة تفكيك الأكاديميات الغربية، استُخدم في السياق العربي أساسًا كأداة نقد للمعرفة الغربية عن الإسلام دون أن يتحول إلى إطار منهجي شامل لإعادة النظر في تدريس الإسلام نفسه. وينطلق مشروع سعيد من أطروحة مركزية مفادها أن الاستشراق ليس مجرد حقل معرفي محايد، بل هو خطاب تشكّل تاريخيًا في سياق الهيمنة الاستعمارية وأسهم في إنتاج صورة نمطية عن الإسلام بوصفه دينًا جامدًا وغير عقلاني ومضادًا للحداثة، وقد استند سعيد في تحليله إلى مفاهيم ميشيل فوكو حول الخطاب والسلطة، معتبرًا أن المعرفة لا تُنتَج في فراغ، بل داخل شبكات قوة تحدد ما يُقال وكيف يُقال ولأي غاية، وفي هذا الإطار لم يكن الإسلام موضوعًا للدراسة فحسب، بل كان موضوعًا للتمثيل؛ حيث تحدد معناه من خارج سياقه التاريخي والاجتماعي، ما جعله أحد أبرز المنعطفات الفكرية في النقد المعاصر، عربيًا وعالميًا؛ إذ أعاد النظر جذريًا في العلاقة بين المعرفة والسلطة وبين الخطاب الثقافي والمشروع الإمبريالي.
وقد لاقى مشروعه صدى واسعًا في العالم العربي، غير أن هذا التلقي لم يكن موحدًا أو متجانسًا، بل تعدد بين التبني الكامل؛ حيث وجد بعض النقاد العرب في أفكاره إطارًا تحليليًا جديدًا لربط الأدب بالسلطة والتاريخ والسياسة، وبين التفاعل النقدي؛ حيث أُقر بالأهمية الكبرى للكتاب مع تقديم تحفظات منهجية أو أيديولوجية، وبين الرفض أو التحفّظ الأيديولوجي، ويعد هذا النموذج الأخير من أكثر نماذج التلقي إثارة للجدل؛ إذ لم يرفض سعيد لأسباب معرفية فحسب، بل لأسباب فكرية وإيديولوجية متباينة شملت المرجعيات الماركسية والقومية والإسلامية بالإضافة إلى بعض الاتجاهات النقدية التقليدية.
وأحدثت أفكار سعيد تأثيرًا إيجابيًا وتحويليًا في النقد الأدبي العربي؛ إذ ساعدت على ربط الأدب بالسلطة والسياسة والتاريخ بدل عزله كنص جمالي مستقل، وكشفت عن دور الأدب في إنتاج الصور النمطية عن الآخر، وأعادت قراءة الأدب الغربي الكلاسيكي مثل الرواية والشعر والسفر بوصفه جزءًا من مشروع ثقافي إمبريالي، ما شجع النقاد العرب على دراسة تمثيل “الذات” و“الآخر” في الأدب العربي وفحص حضور الاستعمار والهيمنة في الرواية العربية، بما ساهم في بروز ما يُعرف بالنقد ما بعد الكولونيالي العربي.
ومع ذلك، انطلقت كثير من التحفظات الأيديولوجية على مشروع سعيد من أن تركيزه على تحليل الخطاب الثقافي والتمثيل الرمزي مستندًا إلى أعمال فوكو وغرامشي أدى إلى إغفال البنى المادية والاقتصادية التي تحكم علاقة الغرب بالشرق. فقد رأى المفكر المصري أنور عبد الملك، على سبيل المثال، أن سعيد قدّم تحليلًا ثقافيًا أكثر منه تاريخيًا-اقتصاديًا؛ إذ ركّز على النصوص والخطابات الغربية دون الاهتمام الكافي بعلاقات الإنتاج والصراع الطبقي بوصفها أساس الهيمنة الاستعمارية. ورأى حسين مروة ومن سار في فلكه، أن نقد سعيد مهم ثقافيًا، لكنه يظل نقدًا غير ثوري لأنه يحيل الاستعمار إلى مستوى الخطاب أكثر من البنية الاقتصادية الصلبة، ما يجعل مشروعه النقدي غير مكتمل. ومن جهة أخرى، اعتبر عبد الله العروي أن الانشغال بنقد تمثيلات الغرب للشرق قد يؤدي إلى الدوران في فلك الآخر بدل الانخراط في مشروع تاريخي لتبنّي الحداثة، وبحسب تصوره فإن نقد الاستشراق وحده لا يُغني عن مواجهة مشكلات التخلف البنيوي في المجتمعات العربية. بينما بيّن صادق جلال العظم على أهمية الكتاب في فضح تحيزات الاستشراق الغربي لكنه نقد أطروحته باعتبارها قد تنطوي على نزعة تعميمية، محذرًا من أن رفض الاستشراق جملةً واحدة قد يؤدي إلى ما وصفه بـ"الاستشراق المعكوس" الذي يحوّل الشرق إلى كيان نقي من النقد.
أما في السياق الإسلامي، فقد اعتبر بعض المفكرين الإسلاميين مثل محمد عمارة أن سعيد، رغم نقده العميق للغرب، ظل أسيرًا للمرجعية الغربية العلمانية، ولم يقدم رؤية معرفية إسلامية مستقلة؛ بل اكتفى بتفكيك الخطاب الغربي من داخله دون البناء على التراث الإسلامي بوصفه مرجعية حضارية مستقلة. وإلى جانب هذه المواقف الفكرية الكبرى ظهرت تحفّظات في الوسط النقدي الأدبي التقليدي؛ حيث رفض بعض النقاد العرب الأكاديميين إخضاع النص الأدبي للتحليل السياسي والثقافي الذي دعا إليه سعيد، معتبرين أن ربط الأدب بالسلطة والاستعمار يُفقده خصوصيته الجمالية ويحوّله إلى وثيقة أيديولوجية، وهو ما يتعارض مع جوهر العمل الأدبي القائم على البلاغة والتخيل، ومع ذلك فإن جميع هذه المواقف تتفق على الإقرار بأهمية مشروع سعيد وتأثيره، فحتى حين تختلف المواقف أو تتحفظ، يبقى رفضه الأيديولوجي غالبًا تعبيرًا عن اختلاف المرجعيات الفكرية وأولويات المشروع النقدي.
وفي الجامعات الغربية، أدى طرح سعيد إلى إعادة هيكلة مناهج تدريس الإسلام، بالانتقال من دراسة النصوص الدينية بمعزل عن سياقها إلى تحليل شروط إنتاج المعرفة عنها، ومن التعامل مع الإسلام ككيان متجانس إلى الاعتراف بتعدديته التاريخية والثقافية، وأُدرج نقد الاستشراق ضمن المقررات الدراسية بحيث أصبح الطالب مُطالَبًا بفهم العلاقة بين المعرفة والسياسة لا بمجرد استيعاب المحتوى الديني أو التاريخي.
أما في الجامعات العربية، فكان استقبال أفكاره مختلفًا من حيث الدوافع والنتائج، فقد دخلت أطروحته أساسًا عبر الترجمة وأقسام الأدب المقارن والدراسات الثقافية غالبًا خارج كليات الشريعة، واستُقبل سعيد بوصفه مفكرًا "يفضح" تحيُّزات الاستشراق الغربي؛ الأمر الذي جعله يحظى بقبول واسع في الخطاب الأكاديمي والثقافي العربي، خاصة في سياق ما بعد الاستقلال، غير أن هذا القبول ظل في معظمه قبولًا انتقائيًا ركّز على البُعد الجدلي في نقد الغرب وتجاهل البُعد المنهجي المُتعلق بنقد آليات إنتاج المعرفة. وقد انعكس هذا الاستقبال الانتقائي على مناهج تدريس الإسلام في الجامعات العربية، فمن جهة أسهم في إضعاف الخطاب الدفاعي التقليدي الذي كان يهيمن على تدريس الاستشراق، ومن جهة أخرى لم يؤدِّ هذا التحول إلى مراجعة جذرية لطريقة تدريس الإسلام نفسه؛ إذ بقيت المعرفة الإسلامية التقليدية في كثير من الأحيان خارج دائرة النقد المنهجي الذي طُبِّق على المعرفة الغربية.
ويبرُز هذا التناقض بشكل أوضح في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية؛ حيث تقوم المناهج على مرجعيات نصية ومذهبية محددة وتفترض وجود حقيقة دينية مستقِرة يُراد نقلها وضبطها لا مساءلتها بوصفها خطابًا تاريخيًا. ومن هنا نشأ توتر بنيوي بين مشروع سعيد القائم على تفكيك السلطة المعرفية وبين طبيعة التعليم الشرعي، الذي يستمد شرعيته من سلطة النص والتقليد، وقد أدى هذا التوتر إلى تباين المواقف من سعيد داخل الجامعات العربية تراوح بين الرفض الصريح والتوظيف الانتقائي ومحاولات محدودة للتفاعل النقدي المتوازن.
وفي سياق دراسات ما بعد الاستعمار، يكشف هذا الواقع عن مفارقة أساسية، تتمثل في أن الجامعات العربية، رغم كونها جزءًا من العالم الذي خضع للاستعمار، لم تطوِّر بعد مقاربةً ما بعد استعماريةٍ متكاملةً لتدريس الإسلام، فقد جرى استخدام نقد الاستشراق لتفكيك صورة الإسلام في الخطاب الغربي دون استخدام الأدوات نفسها لتحليل كيفية تشكُّل المعرفة الدينية محليًا وعلاقتها بالسلطة السياسية والاجتماعية. ويُعزى ذلك إلى ضعف الحرية الأكاديمية والخوف من الخلط بين النقد المنهجي والطعن في الدين، إضافة إلى غياب التقاليد البحثية البينية التي تسمح بدمج الدراسات الإسلامية بالعلوم الاجتماعية والنقد الثقافي.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إن تأثير سعيد في مناهج تدريس الإسلام في الجامعات العربية كان مهمًا من حيث الوعي الخطابي، لكنه محدود من حيث التحول المنهجي، فقد أسهم في زعزعة الثقة المطلقة بالمعرفة الغربية عن الإسلام وربطها بسياقها الاستعماري، لكنه لم يُفضِ إلى إعادة بناء شاملة للمناهج الدراسية على أسس نقدية ما بعد استعمارية. ومن ثم يبقى التحدي الأساسي أمام الجامعات العربية هو الانتقال من توظيف سعيد بوصفه ناقدًا للآخر إلى استيعابه بوصفه مفكرًا يقدم أدوات لفهم الذات وإعادة التفكير في كيفية تدريس الإسلام بوصفه ظاهرة دينية وتاريخية حية لا مجرد منظومة مغلقة أو موضوع دفاعي، وهو ما يضمن استمرار حضوره في النقد الأدبي والدراسات المقارنة العربية والعالمية ويُبرِز قدرته على إثارة الأسئلة الكبرى المتعلقة بالمعرفة والهوية والسلطة.