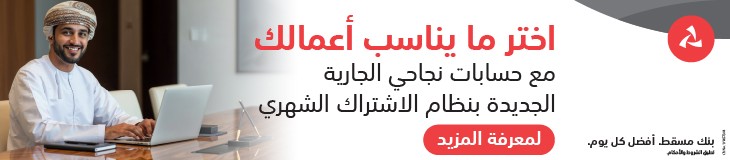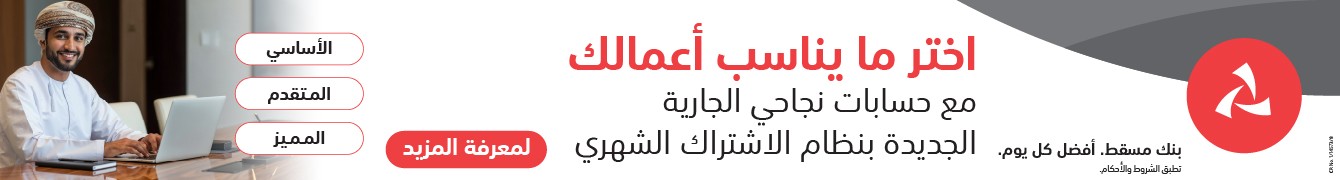د. صالح الفهدي
في جولتي بمعرض "كومكس" التقيتُ بمجموعةٍ من الشبابِ في إحدى المؤسسات الخاصَّة، ودار بيننا حديثٌ قصيرٌ إلَّا أنَّه يعبِّرُ عن فكرٍ نُريدهُ، وندعو إليه؛ إذ أكَّدَوا على أنَّهم يمنحون الفرص لِمَنْ التحقَ بالعمَلِ بعدهم، ويتيحون المجالَ أمامهم لتحسين العمل، وتجويد الأداء، ولا يتدخَّلون إلا قليلًا؛ حيث يقتضي الحالُ منهم التدخل، إنَّما يسعون إلى رفع مستوى الثقة بمن يليهم من الملتحقين بالعمل، ومن يملكُ قدرة على الإبداعِ والابتكار والتحديث دون أن يفرضوا عليهم ما يجب أن يفعلوه، وما لا يجب.
هذا الفكرُ هو الذي نريدهُ كفكرٍ يعمُّ مؤسساتنا الحكومية والخاصَّةِ ومؤسسات المجتمع المدني؛ أن يُمنح كلَّ موهوب، كلَّ صاحبِ قدرةٍ، وكلَّ من يجدُ في نفسه الكفاءة، لكي يُبدعَ، ويبتكرَ، ويحسِّنَ، في كلِّ جانبٍ من جوانبِ العمل، فما أبطأَ السَّيرَ إلا فكرٌ جامدٌ لا يتطوَّر، ولا يمنح الثقة في غيرهِ كي يطوِّر؛ بل السير على منهج عقيمٍ، بليد "إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ" (الزخرف-22)، ولا تبحثُ- أمام ذلك الفكرُ الآسنُ- عن سبب مشكلات المؤسسات، فتسأل: لماذا هذه البيروقراطية التعيسة ما زالت جاثمةً في إجراءات العمل؟ لماذا لا تتجدَّدُ طرقُ ووسائل الأداء؟ لماذا لا نشهدُ استخدامًا واسعًا وعميقًا للتقنية وهي متاحة لخدمة الأعمال؟ لماذا لا نعيدُ النظر في كثيرٍ من المؤسسات حتى نجعلها أكثرُ كفاءةً وفاعلية؟
حينَ يسودُ الفكرُ الذي أباحَ به الشبابُ؛ فكرُ إتاحة المجال لكلِّ صاحبِ كفاءةٍ كي يُبرهنَ عن قدراته في تحسين أداءِ العمل، والإرتقاءِ بالخدمات، فإِنَّ كل مؤسسةٍ ستجدُّ خُطاها نحو المنافسة في تقديمِ الخدماتِ، وتحسينِ الأداء، وبالمناسبة فالمؤسسةِ التي دار الحديثُ فيها لم تكن تتبوأ صدارة المؤسسات في قِطاعها، ولكنها كانت تقدِّم من الخدمات عبر منافذها الالكترونية أكثرُ مما تقدِّمهُ المؤسسة المتصدِّرة للقطاع والتي تفوقها في الحجم والعوائدِ المالية، وهذه نتيجة لإتاحة الفرص أمام المبدعين في المؤسسة كي يبدعوا ويحسِّنوا من طرقِ الأداء المؤسَّسي.
هذا الفكرُ هو الذي نريدُ أن يعمَّ مؤسساتنا لأننا في عالمٍ سريعِ المتغيرات، شرس المنافسات يحتاجُ إلى العقول المتوقدة، والهمم المتوثِّبة، لتتفاعل مع متغيراته، وتتعاطى مع مستجدَّاته. في إحدى المؤسسات وجدتُهم يعرضون بعض التطبيقات التقنية لكنني وجدتُ أنَّ هناك بونًا شاسعًا بين من يقومُ بالشرحِ وبين التطبيقِ ذاته، هذا فضلًا على أنَّ التطبيقَ ينتمي لسنواتٍ خاليةٍ، أما اليوم فنحنُ في عصرِ الذكاء الاصطناعي الذي يجب أن تستفيد فيه كلُّ مؤسسة.
هذا الفكرُ الذي نريدُ أن يعمَّ في مؤسساتنا حتى لا نظلَّ معتمدين على الشركات الأجنبية التي تمدُّنا بالتقنيةِ، والتطبيقات، فتكون بياناتنا مقيَّدةً في أجهزتها التي لا يُعلم عن ارتباطها شيئًا!، ولقد رأيتُ ذلك في إحدى المؤسسات التي أَدركتُ أنها تسحبُ البساطَ من شركةٍ عالميَّةٍ كُبرى بعد استنتاجي من عدَّةِ أسئلةٍ طرحتها عليهم، حتى قُلتُ لهم: أنَّ السيادةَ الوطنية لأيَّة دولة تقتضي احتفاظها ببياناتها في إطارها وليس في يد الآخر، فالمعرفةُ قوة، بيدَ أن المعرفة لا تكون إلا بمعلوماتٍ وبياناتٍ حتى تُصبحَ معرفةً وبالتالي قوة، فإِن مكَّنا الآخر من الاستحواذ على معلوماتنا وبياناتنا فقد جعلنا لهم القوةَ والمكنة علينا، وإن نحنُ احتفظنا بها وأنشأنا إطارًا مؤسسيًا شبيهًا بها استطعنا أن نقدِّم نفس الخدمةِ ولكن في إطار السيادة الوطنيةِ.
إنني لأستبشرُ خيرًا حينَ أَجدُ شبابًا يتبنون فكرًا معارضًا للاستحواذِ على المعلومةِ، والسلطةِ، والقرار، منفتحونَ لإتاحة الفرص لكل من جاءَ بعدهم ممن يحملُ فكرًا متجددًا أو من يملكُ عقلية متقدمةً ومتنبهة لما يحدثُ من متغيرات ومستجدات، فهؤلاءِ الشباب هم الذين نعوِّلُ عليهم التغيير الذي ننشده، وهم الذين يتبنُّونَ "الفكر الذي نُريد".