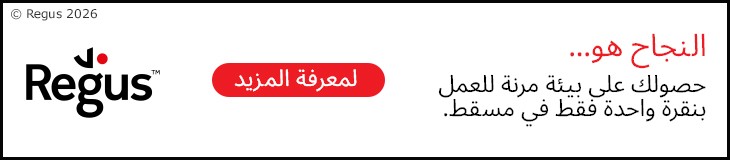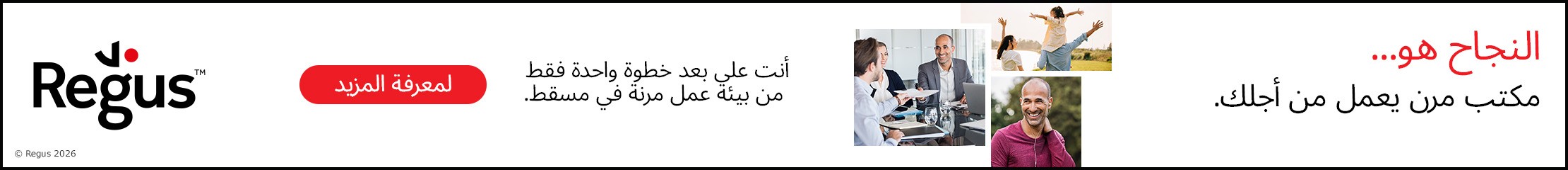خالد بن حمد الرواحي
في بيتٍ عُماني بسيط، يجلس أبٌ شابٌّ يحسب الأيام المتبقية لانتهاء عقده، بينما تنظر زوجته بقلقٍ إلى التزامات البيت وأقساطه ومستقبل أطفالهما. يعيش على أمل أن تصله رسالة تجديد، لكنه في الوقت نفسه يخشى أن يكون غدًا بلا وظيفة. هو ليس حالةً فردية، بل صورةٌ لجيلٍ كامل وجد نفسه يواجه الحياة بعقودٍ مؤقتة لا تمنحه إلا قلق الغد.
هذا الجيل تعلّم أن يحلم بحذر؛ فالزواج مؤجّل، وشراء منزل مؤجّل، وحتى قرارات الحياة اليومية تُدار على قاعدة: «لننتظر، هل سيُجدَّد العقد أم لا؟». وهنا يبرز السؤال المؤلم: كيف يخطّط شابٌّ لمستقبله وهو لا يعرف إن كان سيحصل على راتب الشهر القادم؟ صحيحٌ أن بعض المؤسسات ترى في العقود المؤقتة وسيلةً لتقليل التكاليف وتجنّب الالتزامات الطويلة، غير أنّ هذه المقاربة تزرع القلق في نفوس الموظفين، وتضعف الولاء، وتدفعهم إلى البحث عن بدائل عوضًا عن أن يمنحوا أعمالهم أفضل ما لديهم.
ومع أن العقود المؤقتة مقبولة عالميًا في وظائف موسمية أو مهام قصيرة المدى، كالزراعة والسياحة، لانسجامها مع طبيعة العمل؛ إلّا أنّ الاستغراب يتضاعف حين تمتد هذه السياسة إلى بعض الجهات الحكومية في وظائف دائمة وأساسية لا علاقة لها بالموسمية. كيف يقنع موظفٌ حكومي نفسه بأن عقده «مؤقّت»، بينما طبيعة عمله يومية ومستمرّة ولا يمكن الاستغناء عنها؟ إن هذا التناقض يضعف الثقة ويثير تساؤلاتٍ مشروعة حول منطق هذه السياسات وعدالتها.
ويتسع سؤال العدالة حين ننظر إلى بعض منشآت القطاع الخاص الكبيرة التي تحظى بعقودٍ ومناقصاتٍ بملايين الريالات ويمتد تنفيذ مشاريعها لعشرات السنين، ثم تُعيَّن فيها الكفاءات الوطنية بعقود عملٍ لعامٍ واحد يُجدَّد سنويًا. أليس من المنطقي أن تُقارِب مدةُ عقد الموظف مدةَ المشروع الذي يعمل فيه؟ وكيف يشعر الشاب العُماني بالاستقرار وهو يرى المشروع مضمونًا لسنواتٍ طويلة، فيما يرتبط مستقبله بمزاجية تجديدٍ سنوي؟ إن هذه المفارقة تكشف خللًا في فلسفة التوظيف، وتؤثر مباشرةً في استقرار الأسر وتستنزف طاقات الشباب.
وما يزيد المفارقة وضوحًا أن بعض منشآت القطاع الخاص أعمالها دائمة بطبيعتها؛ فالمصانع بمختلف أنواعها لا تتوقف، والمجمّعات التجارية الكبرى تفتح أبوابها على مدار العام، وشركات النفط العملاقة مشاريعها ممتدة بلا انقطاع. ومع ذلك، يُعيَّن المواطن العُماني في هذه القطاعات الحيوية بعقدٍ مؤقت، بينما المهنة التي يشغلها بطبيعتها دائمة ومستقرة. أي منطق يجعل طبيعة العمل دائمة لكن عقد العامل العُماني فيها مؤقتًا؟ هذه الصورة تضيف طبقة أخرى من الأسئلة حول العدالة في إدارة عقود العمل.
وعند هذه النقطة تتضح حقيقةٌ بسيطة: الأمان الوظيفي ليس ترفًا ولا مطلبًا ثانويًا؛ بل حقًا أساسيًا للحياة الكريمة؛ لأن هذا الأمان هو الذي يمنح الموظف القدرة على التخطيط، والثقة لبناء أسرة، والطمأنينة التي تُطلق طاقته للإبداع. وغيابه -أي الأمان الوظيفي- يعني قلقًا دائمًا ينهك الروح ويستهلك الطاقة. صحيحٌ أن هناك مبادراتٍ إيجابية كمنح المسرحين وبدل الأمان الوظيفي ومنظومات الحماية الاجتماعية، وهي جهود تستحق الإشادة، غير أنها تبقى غير كافية إذا استمرت عقود العمل المؤقتة قاعدةً عامة بدل أن تكون استثناءً محدودًا تُبرّره طبيعة العمل.
وتُظهر تجارب العالم أن المرونة يمكن أن تتعايش مع الحماية حين تتوازن الحقوق والواجبات؛ ففي أوروبا، مثلًا، تُرافق العقود المؤقتة شبكاتٌ قوية للتأمين ضد البطالة، فلا يُترك الموظف لمصيره. وفي بعض الدول الآسيوية، تُلزِم القوانين الشركات التي تعتمد على التوظيف المؤقت بتقديم برامج تدريبٍ وتأهيلٍ حقيقية، حتى لا يخرج الموظف خالي الوفاض عند انتهاء العقد. والرسالة واضحة: إذا فُرضت المرونة بحكم السوق، فيجب أن تُقابَل بأنظمةِ حمايةٍ تصون الاستقرار.
ويبقى جوهر القضية أن جيل اليوم لا يطلب المستحيل؛ يريد فقط أن يشعر أن حياته ليست مؤقتة، وأن أحلامه ليست معلّقة على ورقة عقد قد لا يُجدَّد. فكيف نطالبه بالصبر وهو يرى مشاريع بملايين الريالات تمتد لعشرات السنين، بينما عقده لا يتجاوز عامًا واحدًا؟ إن الأمان الوظيفي ليس مجرد بندٍ قانوني؛ بل صمّام أمانٍ للأسَر، وضمانةٌ لاستقرار المجتمع، وركيزةٌ تمنح الوطن طاقات شبابه بثقةٍ وولاء.
وربما الأجمل أنّ بوادر الحلول قد بدأت بالفعل مع منظومة الحماية الاجتماعية وجهود الإصلاح في سوق العمل؛ ما يعني أن الطريق إلى المعالجة ليس بعيدًا. إنَّ الشباب يريدون المساواة بين استمرارية المشاريع وتحقيق أحلامهم، وفق منظومة عمل قادرة على تحويل المؤقّت إلى استقرارٍ دائم، والقلق إلى طمأنينة، والأحلام المؤجَّلة إلى واقعٍ يتحقق.