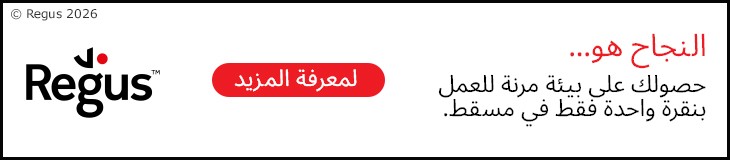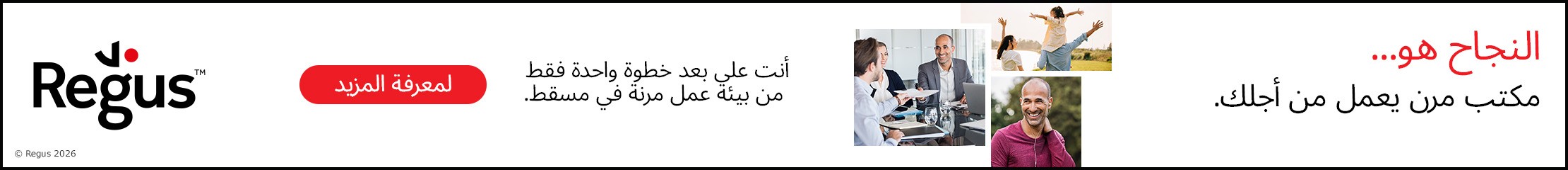خالد بن حمد الرواحي
في كل مرحلة مفصلية من تاريخ أي أمة، تظهر أسئلة مصيرية تفرضها التحديات، وتحركها طموحات الناس. وفي هذا السياق، لم يكن السؤال عن "فرص العمل" مجرد هاجس شبابي، بل تحوّل إلى أولوية وطنية مُلحّة، خصوصًا بعد أن تجاوز عدد الباحثين عن عمل -وفق ما أُعلن مؤخرًا- 100 ألف باحث عن عمل.
هذا الرقم لا يعبّر فقط عن تحدٍّ اقتصادي، بل يعكس حجم التطلعات المجتمعية لإحداث تغيير حقيقي في سياسات التشغيل. وهو ما يجعل رؤية 2040 أكثر من مجرد وثيقة طموحة؛ بل اختبارًا لقدرتها على التحوّل من الخطة إلى الأثر، ومن الورق إلى الواقع الذي يلمسه المواطن ويشعر به، خصوصًا أولئك الذين ينتظرون فرصة للاندماج في الحياة الاقتصادية بكرامة واستقرار.
وما يميز هذا التوجّه أنه لم يأتِ كردّ فعل ظرفي، بل كمشروع استراتيجي وطني شامل يعيد تشكيل سوق العمل من جذوره. سوق لا يُبنى على الأقدمية أو المجاملات، بل على الكفاءة، والاستحقاق، والإنتاجية، وبنية مؤسسية مرنة تضمن التمكين، لا التوظيف فقط.
لهذا، لم تكتفِ الرؤية بتشخيص المشكلات، بل بادرت بتقديم إجابات ملموسة. فجاءت مجموعة البرامج الاستراتيجية، البالغ عددها 19 برنامجًا، كخريطة طريق عملية لإصلاح سوق العمل، وتكييفه مع تطلعات الشباب، ومع المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة.
وكان لا بد أن تبدأ الخطوة من المستقبل نفسه؛ فكان تأسيس المركز الوطني للدراسات الاستشرافية بمثابة العين التي تراقب تحولات المهن والمهارات عالميًّا، وتقدم قراءات دقيقة تسترشد بها المؤسسات التعليمية وجهات التوظيف معًا، لضمان أن يكون إعداد الأفراد متوافقًا مع واقع السوق، لا مع توقعات عشوائية.
وانطلاقًا من الحاجة إلى توحيد المسارات وتحديث منظومة المؤهلات، تأسست وحدة المؤهلات الوطنية لتكون المرجعية في تصنيف المهارات، وربطها بمعايير المهن، وإعادة الاعتبار للجدارة، بدلًا من الاعتماد الأعمى على الشهادات.
ثم جاء إطار مهارات المستقبل ليأخذ زمام المبادرة في تحديث فلسفة التأهيل. فلم يعُد السؤال: "ما الذي درسته؟"، بل أصبح: "ما الذي يمكنك أن تقدمه؟". المهارات الرقمية، والتفكير النقدي، وريادة الأعمال، والأمن السيبراني، تحوّلت من كماليات إلى مكونات أساسية ضمن المناهج، والبرامج التدريبية، وخطط الإعداد الوظيفي.
ولكي تتحول الخطط إلى نتائج قابلة للقياس، كان لا بُد من أدوات دقيقة. وهنا جاءت قاعدة بيانات رأس المال البشري، لتمثل نقلة نوعية في فهم واقع التعليم، والتدريب، والتوظيف، وربطها بسوق العمل، من خلال منصة موحدة تدعم اتخاذ القرار، وتُغلق فجوات التقدير والانطباع.
لكن النية وحدها لا تكفي، ما لم ترتبط بخطوات تنفيذية تستجيب للواقع. ولهذا، شملت برامج الرؤية مجموعة من المبادرات المباشرة لتمكين الباحثين عن عمل، أبرزها برامج التدريب المقرون بالإحلال، التي تستهدف تجهيز الكوادر الوطنية لشغل وظائف تشغلها قوى عاملة وافدة، وفق متطلبات وظيفية دقيقة، وتدريب عملي فعّال.
وفي مواجهة التخصصات غير المطلوبة، وُضعت برامج لإعادة التأهيل، وإدخال الخريجين إلى مسارات جديدة تتقاطع مع مهاراتهم الأصلية. حتى الانضباط المهني لم يُغفل؛ إذ أُدرجت برامج تدريب عسكري وتأهيل شخصي، تعزز المسؤولية والالتزام، وتؤهل الشباب لحياة مهنية ناضجة.
ولأن العمل لم يعُد محصورًا في الوظائف التقليدية، كانت الرؤية أكثر واقعية حين فتحت الباب أمام العمل الحر والمبادرات الفردية، واعتبرته مسارًا اقتصاديًّا موازيًا للتوظيف المؤسسي. تم تخصيص برامج تمويل، وإرشاد، وتدريب، لتأهيل رواد الأعمال، وتشجيعهم على دخول السوق بثقة.
لكن النجاح في هذا المسار يتطلب أكثر من التدريب. لذلك، برزت الحاجة إلى دعم بيئة العمل الحر، من خلال خفض الضرائب والرسوم، وتبسيط الإجراءات، وتوفير حاضنات مرنة، تزيل العوائق من طريق المبادرين، وتمنحهم فرصة واقعية للنمو والاستمرار.
على الجانب الآخر، كان لا بد من تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي؛ فتم تأسيس صندوق الأمان الوظيفي، ليحمي من فقدوا وظائفهم بشكل مفاجئ، مع التأكيد على أهمية تسريع صرف الإعانات الشهرية للباحثين عن عمل، لتقليل الضغط النفسي والمعيشي خلال فترة الانتقال، وضمان عدم تحوّلها إلى مرحلة إحباط أو انسحاب.
ولضمان أن يكون السوق منصفًا وفعّالًا، بدأت مراجعة شاملة للتشريعات، شملت تطوير قانون العمل، وضبط سياسات التوظيف، وإنهاء الخدمة، وتنظيم العقود. كما تعالت الدعوات المجتمعية لضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، ويجعل القطاع الخاص بيئة جاذبة، لا طاردة للكفاءات الوطنية.
ولم يغب جانب التحفيز عن المشهد؛ إذ أصبح الترقي قائمًا على الكفاءة، لا الأقدمية، وتُبنى الحوافز على الأداء، لا الولاء. كما جرى اعتماد أنماط عمل أكثر مرونة مثل: العمل عن بُعد، والجزئي، والمرن، مع دعم ثقافة التدوير والتبادل الوظيفي بين القطاعات، لإثراء المهارات والتجارب.
كل هذه التحولات ما كانت لتتحقق دون طرف أساسي في المعادلة: القطاع الخاص. فالرؤية لا تريده تابعًا، بل شريكًا فاعلًا. ولهذا، جاء تمكينه عبر تسهيلات ضريبية، وتشريعية، وتمويلية، ليتحوّل من مجرد "مستفيد" إلى "صانع للفرص".
وفي المقابل، تخاطب الرؤية الشباب بوضوح وصدق: الفرص لا تُنتظر، بل تُقتنص. والتمكين لا يُمنح، بل يُصنع بالتأهيل، والاجتهاد، واستثمار ما هو متاح من أدوات دعم وخيارات.
وهكذا، لم تعُد "الوظيفة" مجرد غاية؛ بل تحوّلت إلى بداية لمسار إنتاجي ناضج، ومسؤول، ومستدام.. وفي زمن يتغير فيه كل شيء، اختير أن يكون مستقبل الشباب قرارًا وطنيًّا... لا مجرد مصادفة.