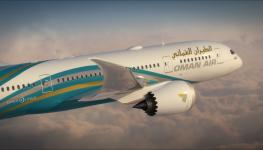جميلة بنت عبدالله الهنائي
في الحقول المفتوحة، حيث لا شيء يحجب الأفق، تقف زهرة دوّار الشمس مرفوعة الرأس، كأنها تعرف وجهتها منذ البداية، لا تنشغل بما حولها، ولا تلتفت لاختلاف الأزهار، بل يشغلها سؤال يتجدد كل صباح: أين الشمس؟ ومن شروق النهار حتى ميله إلى الغروب، تدور في هدوء ثابت، تمارس فعلها اليومي البسيط: تتبع الضوء.
هذه الحركة ليست مجرد مشهد جمالي، بل سلوك حيوي دقيق؛ ففي مراحل نموها الأولى تمارس النبتة ما يُعرف علميًا بالانتحاء الضوئي، حيث تنمو خلايا الساق بطريقة تجعلها تميل نحو مسار الشمس لتحصل على أكبر قدر من الضوء. والضوء بالنسبة لها ليس ترفًا، بل شرط للنمو والإزهار. وخلف هذا التفسير العلمي يبرز معنى إنساني عميق: فالكائن الحي يزدهر حين يعرف مصدر طاقته، ويتَّجه نحوه باستمرار.
وليس بعيدًا عن هذا المعنى أن يسمي التراث العُماني زهرة دوّار الشمس "مِقيبلوة الشمس"؛ تسمية شعبية آسرة تصف فعلها قبل شكلها؛ فهي الزهرة التي تُقبل بوجهها نحو الشمس أينما مالت. وكأنَّ الحسّ اللغوي الفطري سبق التفسير العلمي، فالتقط بالملاحظة ما ستكشفه الدراسات لاحقًا، ليغدو الاسم الشعبي شاهدًا على عمق الصلة بين الإنسان العُماني والطبيعة، وقدرة اللغة المحلية على اختزال الظاهرة في صورة حيّة نابضة بالمعنى.
ولم تكن زهرة دوّار الشمس بعيدة عن الوعي الإنساني كذلك؛ فقد ارتبطت في ثقافات قديمة برمز الشمس والحياة والخصب، ثم تحولت في الفنون إلى صورة للأمل المتقد وسط العتمة، ومع الزمن أصبحت الشمس في المخيلة البشرية رمزًا للحقيقة والمعرفة والهداية، وأصبح الالتفات نحوها استعارة للبحث عن المعنى، فغدت حركة دوّار الشمس صورة للكائن الذي يختار النور طريقًا.
ومن هذا التلاقي بين الطبيعة والرمز، تنبثق "نظرية دوّار الشمس"، وهي تصور إنساني تربوي يفترض أن الإنسان يبلغ ذروة نموه النفسي والمهني حين يوجّه طاقته نحو المجالات التي تثير شغفه الحقيقي، كما يوجّه دوّار الشمس بنيته الحيوية نحو الضوء. فالشغف في حياة الإنسان يؤدي دور الضوء في حياة الزهرة، يمنحه الطاقة، ويوقظ الدافعية، ويجعل الجهد طريقًا إلى الإزهار، لا عبئًا مفروضًا.
ورحلة الشغف، مثل رحلة الزهرة مع الشمس، ليست لحظة عابرة، بل مسارًا من البحث والممارسة، في البدايات يجرّب الإنسان مجالات متعددة، يقترب ويبتعد، حتى يلمح ما يوقظ داخله الحماسة، ثم تأتي مرحلة المواظبة، حيث يتحول الميل إلى ممارسة يومية، فالشغف الذي لا يُعاش يذبل، كما تذبل الزهرة إن حُجبت عن الضوء، ومع الاستمرار يتحقق النمو، فيتحسن الأداء ويزداد الأثر، حتى يصل الإنسان إلى درجة من النضج يستقر فيها على مساره، كما تستقر الزهرة في اتجاهها بعد اكتمال نموها.
وحين تُقرأ هذه الرؤية في ضوء التربية، فإنها تفضي إلى فلسفة واضحة: فالتعلم الحقيقي لا يُبنى على الإكراه، بل على الاكتشاف. فالمتعلم كالنبتة، لا يبدع في الظل، بل حين يُتاح له أن يتجه نحو ما يرى فيه معنى، ودور المربي هنا ليس فرض الطريق، بل مساعدة المتعلم على التعرف إلى ميوله، وتهيئة بيئات تعليمية متنوعة تسمح بالتجربة والاختيار. إن التعليم المتصل بالشغف يدوم أثره، بينما التعليم المفروض يبهت بزوال الدافع الخارجي.
وهكذا تعيدنا زهرة دوّار الشمس إلى حكمة بسيطة وعميقة في آن واحد: ليست قيمة الحركة في كثرتها، بل في اتجاهها، فهي لا تقارن نفسها بغيرها، ولا تنشغل بالظلال، بل تركّز وجودها على مواجهة الشمس، وكذلك الإنسان، حين يكفّ عن الدوران حول توقعات الآخرين، ويتجه بثبات نحو شغفه، لا ينمو فحسب، بل يزهر، ويصبح حضوره في الحياة أكثر إشراقًا وأبقى أثرًا.