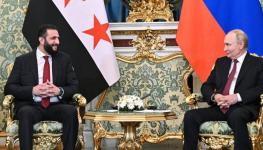بدر بن خميس الظفري
@waladjameel
العقل في الإسلام أصل الوعي ومصدر النور، وهو القوة التي تفتح للإنسان أبواب المعرفة والتمييز. بهذا العقل يسمو الإنسان على الغريزة، ويتصل بالعالم اتصال فهمٍ وتأملٍ واكتشاف. وكل نداءٍ في القرآن إلى الذين يعقلون ويتفكرون ويتدبرون هو إعلانٌ لقيمة الفكر، ودعوةٌ إلى النظر في آيات الكون والإنسان. فالإيمان الذي لا يقوم على العقل إيمانٌ ناقص، والعقل الذي لا يستضيء بالهداية عقلٌ تائه، وبينهما تتكوَّن إنسانية المسلم الكاملة.
في ضوء هذا الفهم نشأ علم أصول الفقه، الذي جمع بين صفاء العقيدة ودقة الاستنباط. فالعلماء الذين قرأوا النصوص التشريعية اكتشفوا من خلالها نظامًا مقصودًا يقوم على المقاصد الكبرى التي لخَّصها الإمام الشاطبي في خمسة مبادئ هي: حفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ المال. هذه المبادئ رسمت خريطةً واضحة للعمران الإنساني، لأنها جعلت التشريع في خدمة الحياة، وربطت العبادة بالسلوك، وقرنت الواجب بالكرامة. ومن خلالها يتضح أن الدين وُضع لتقويم الحياة لا لتقييدها، ولإطلاق الطاقات لا لإخمادها.
العقل عند المسلم أداةٌ لفهم سنن الله في الخلق، ومفتاحٌ لمعرفة النظام الذي أودعه الخالق في الوجود. وكلما تعمَّق الإنسان في التأمل ازداد يقينًا بحكمة هذا النظام وعدله. فالفكر الصادق طريقٌ إلى الإيمان، والإيمان الواعي سبيلٌ إلى مزيدٍ من التفكير. وهكذا تتحد المعرفة الدينية والمعرفة الكونية في غايةٍ واحدة، وهي بناء الإنسان على صورةٍ من التوازن والانسجام.
إن المقاصد الكبرى للشريعة تقوم على فهمٍ تفاعلي بين الجزئيات والكليات. والنصوص تتكامل في بيان المعنى، ويستمد بعضها من بعض قوته ودلالته. وما أُجمِل في موضع فُصِّل في موضعٍ آخر، وما تدرج في التشريع يعبّر عن مرونةٍ أصيلةٍ تراعي تغيّر الأحوال والظروف. وهنا تتجلّى عبقرية المنهج الإسلامي الذي يجمع بين الثبات والمرونة، فيبقى صالحًا لكل زمانٍ ومكان.
العقل في هذا الإطار شريكٌ للدين في صناعة الفهم، يكمّله كما يكمل الضوء البصر، ويمنحه عمق الرؤية في دروب الحياة. العقل الديني متصل بالواقع، متفاعلٌ مع أحداثه، يوجّهها نحو المقاصد العليا ويمنحها معناها الأخلاقي والروحي. ومن هذه الحركة المتبادلة نشأت المبادئ الثلاثة التي تُكوِّن جوهر المشروع الإسلامي وهي: العقل والحرية والعدل. هذه المبادئ هي أركان البناء الحضاري، وهي الطريق إلى استعادة التوازن بين الإيمان والعمل.
العقل هو ميزان الفكر ومرشد السلوك؛ فالجاهلية القديمة قامت على العصبية والانفعال، فجاء الإسلام ليقيم سلوكًا جديدًا أساسه الحلم والرزانة وضبط الغريزة بالعقل. فالمجتمع الراشد هو الذي يحتكم إلى التفكير لا إلى التفاخر، ويقيم روابطه على المساواة لا على النسب أو القبيلة. ومن هذا المبدأ انطلقت رسالة الإسلام إلى الإنسانية كلها، تدعو إلى وحدة الأصل الإنساني وتكامل العقول في سبيل الخير العام.
ومن العقل تنشأ الحرية، لأنها خاصية الوعي الإنساني؛ فالإنسان المكلَّف حرٌّ في اختياره، مسؤولٌ عن فعله، وهو في ذلك شريكٌ في إعمار الأرض. الدعوة إلى الإيمان في الإسلام دعوةٌ إلى الاختيار الطوعي، والعبادة في جوهرها محبةٌ تُعبِّر عن رضا القلب وصفاء الإرادة. وكل نظامٍ اجتماعيٍّ عادلٍ يقوم على تحرير الإنسان من كل قيدٍ يحول بينه وبين وعيه الكامل. الحرية أساس الكرامة الإنسانية، ومن جوهرها تنبثق القدرة على الاختيار والمسؤولية.
وأما العدل فهو المبدأ الذي يربط الأرض بالسماء. عدل الله هو الأساس الذي تنتظم به الحياة، ومنه تستمد الشريعة معناها الإنساني. فالحاكم العادل ظلٌّ للرحمة الإلهية في الأرض، والمجتمع العادل امتدادٌ لقيم السماء في السلوك البشري. بالعدل يحيا العقل والحرية معًا، وبه تزدهر الأمم وتتحقق مقاصد الدين في واقع الناس.
تُشكِّل هذه المبادئ الثلاثة، العقل والحرية والعدل، منظومةً واحدة تُوحِّد مقاصد الشريعة ومناهج التفكير، تنبثق منها القواعد الكبرى كالاستحسان والمصلحة والاستصحاب، ومنها تُستمد روح الاجتهاد في مواجهة قضايا العصر؛ إذ إنَّ كل تطورٍ في العلم والاجتماع والتقنية يظل امتدادًا للعقل، وكل توسعٍ في الحرية يُثري التجربة الإنسانية، وكل عدلٍ يتحقق في الأرض يعمّق صلة الإنسان بربه.
وحين يسير المسلم على هدي هذه المبادئ، يصبح الدين قوةً للبناء والتجديد؛ فالإسلام الذي يفتح للعقل أبوابه، ويكرّم الحرية، ويقيم العدل بين الناس، هو الإسلام الذي يصنع الحضارة. ومن يُفعِّل هذه القيم في واقعه يشارك في تحقيق مراد الوحي في التاريخ؛ إذ إنَّ المعرفة في الإسلام ليست حكرًا على زمن، والاجتهاد لا يتوقف عند عصر. وكل قراءةٍ واعيةٍ للنصّ تُعيد للأمة قدرتها على النهوض؛ لأن النور الذي أشرق أول مرة ما زال في النفس البشرية قابلًا للازدياد.