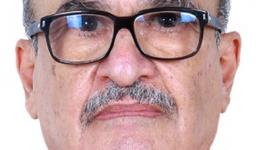مسعود أحمد بيت سعيد
ما زالت اشتراطات إجادة اللغة الإنجليزية في معظم القطاعات الإنتاجية تمنح الشركات والمؤسسات الأجنبية عنصر قوة، ولا يُعقل أن يُطلب من إنسان لغة غير لغته الوطنية كشرط للحصول على وظيفة في مؤسسات تعمل في بلده، ومن المفترض أنها تخضع لقوانينه.
وتثير في الوقت نفسه نقاشًا واسعًا حول جدلية العلاقة بين الهوية الوطنية ومتطلبات سوق العمل. فمن منظور أولي، يبدو هذا الشرط تقويضًا لمكانة اللغة العربية بوصفها الركيزة الأبرز للهوية، كما يشكّل في الوقت ذاته عائقًا أمام فرص توظيف المواطنين، رغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة. وهنا يبرز السؤال: ما جدوى هذا الشرط الذي يعدّ خرقًا دستوريًا؟ وما انعكاسات التمسك به على الهوية الوطنية؟ علمًا بأن الفترة الماضية شهدت صدور قرارات رسمية تؤكد على ضرورة تعريب المعاملات في المؤسسات الحكومية، وهو توجه ذو أبعاد استراتيجية يعكس إدراكًا بخطورة تراجع اللغة العربية. غير أن الإشكال يظل قائمًا، طالما ما تزال اللغة الإنجليزية شرطًا أساسيًا للانخراط في قطاعات عديدة، خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد المعولم.
ومن زاوية ديموغرافية، تزيد التركيبة السكانية لدول الخليج تعقيد هذه المسألة؛ فالمواطنون في أغلبية هذه الدول أقلية قياسًا بالعمالة الوافدة التي تفوقهم في بعض الحالات بأضعاف. وهذه ليست مجرد معضلة إدارية أو اقتصادية؛ بل هي قضية استراتيجية تمسّ الاستقرار الاجتماعي والسياسي على المدى الطويل. ومع ذلك تذهب بعض الرؤى إلى حصر المشكلة في بُعدها القانوني؛ باعتبار أن غياب التجنيس يُبطل دواعي القلق. غير أن هذا المنظور يبقى كذلك قاصرًا؛ إذ إن تدفق ملايين الوافدين إلى حيز جغرافي محدود، واستقرارهم سنوات طويلة وما يتبع ذلك من حاجات معيشية وتعليمية، يترك أثرًا عميقًا في النسيج الاجتماعي عبر أنماط الحياة والثقافة والسلوك. وهذا التداخل يفرز بطبيعته مطالب اجتماعية جديدة وربما حقوقًا سياسية محتملة، كما تؤكد تجارب تاريخية عديدة في مناطق مختلفة من العالم. وتزداد الخطورة حين تكون هذه الكتل الوافدة ذات تجانس عرقي أو قومي يمنحها قدرة على تشكيل نفوذ اقتصادي واجتماعي متنامٍ. عندها يتحول الاقتصاد إلى بوابة للهيمنة، بما يشبه أنماط الاستعمار الحديثة، وإن اختلفت الأدوات والوسائل.
من هذا المنطلق لا يصحّ تجاهل هذه التطلعات وكأنها بلا تبعات لمجرد أنها لا تتخذ صورة استعمار تقليدي؛ فالمصالح الاقتصادية كانت دائمًا المحرك الأساسي للهيمنة، وليس هناك ما يمنع تكرارها في أشكال جديدة. في ضوء هذه المعطيات، تبقى الفرصة متاحة أمام السلطنة وبقية دول الخليج لإعادة صياغة استراتيجياتها المتعلقة بالعمالة واللغة وتجنب مخاطر التقليل من تلك المحاذير؛ إذ يمكن تنويع مصادر العمالة في حدود مدروسة بعناية، لتفادي هيمنة كتلة بشرية متجانسة دون الانجرار نحو مظاهر التنمية الوهمية باستقدام رؤوس الأموال والبشر التي تقصي المواطنين خارج عملية الإنتاج.
ومن الطبيعي أن تتوالى الدعوات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وكثيرًا ما تُربط حلول المشكلات الاجتماعية بهذه الاستثمارات. غير أن من يقف وراء هذه الدعوات في الغالب شرائح طبقية ترى في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، واستقدام اليد العاملة الرخيصة، وسيلة لتحقيق الثراء السريع. لكن، عندما يُقيَّم هذا التوجه وفقًا للمعيار الوطني، يفقد الكثير من وجاهته ومصداقيته. ويعدّ القرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي يُلزم الشركات والمؤسسات الأجنبية بتوظيف عماني واحد على الأقل بعد مرور عام من بدئها نشاطها التجاري، دليلًا واضحًا على إخفاق هذا النهج في تحقيق أهدافه المعلنة.
لا شكّ أن بعض الاستثمارات النوعية ذات الصفة الصناعية وتوطينها مسألة تفرضها دواعي التنمية بالنسبة لعموم البلدان النامية وتصبّ في تقوية الإنتاج والدخل القومي، غير أن هذا شيء وفتح البلد للرأسمال الأجنبي للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحتكار السوق المحلي شيء آخر. وكنا وسنبقى من دعاة إيجاد توازن بين متطلبات الانفتاح على الاقتصاد العالمي والحفاظ على الهوية الوطنية.
وبما أن اعتماد اللغة العربية يمثل قرارًا سياديًا يجسد الهوية الوطنية، فإن الترجمة العملية تتمثل في اعتماد اللغة العربية كمتطلب رئيسي في كل القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يفرض الحاجة العملية إلى توظيف المواطنين. أما إغفال هذا البعد فيحول الأوطان إلى شركات مساهمة عابرة للحدود، ويجعل الحديث عن الهوية فاقدًا للمعنى والقيمة.