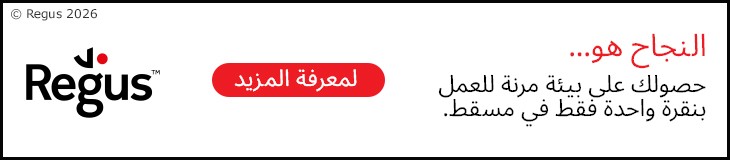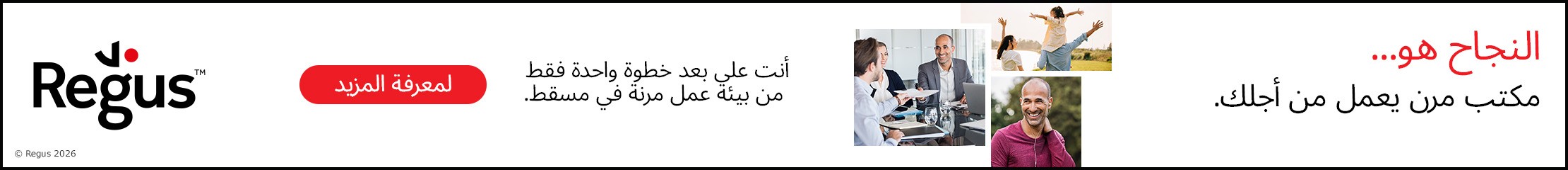عبدالنبي الشعلة **
حين أتذكر محطاتي مع القلم والصحافة، تعود إلى ذاكرتي تجربة عشتها في مطلع الثمانينات. فقد تلقيت عام 1982 دعوة للمشاركة ضمن فريق من عشرة أشخاص في دورة تدريبية تفاعلية عُقدت في جنيف تحت عنوان: «كيف تواجه الصحافة»، نظّمتها إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الاتصال والعلاقات العامة. وكان ضيف الدورة هو راجيف غاندي، نجل السيدة أنديرا غاندي التي تولّت رئاسة وزراء الهند لفترات طويلة، وكانت قد دفعت بابنها الأكبر – الطيار التجاري المحترف – إلى معترك السياسة بعد وفاة شقيقه الأصغر سانجاي في حادث طيران عام 1980.
كان على كل واحد من المشاركين أن يتقمّص دور الصحفي، ويوجّه إلى راجيف أسئلة معدّة مسبقًا، غالبها مثير واستفزازي. ثم تُراجع الإجابات وتُقيّم ردود فعله من قِبل المدربين والخبراء. ولم يكن الهدف ضمان صحة ودقة الإجابة بقدر ما كان القدرة على أن يشعر السائل بثقل شخصية المسؤول، وبثقته بنفسه ورباطة جأشه، وبقدرته على استنهاض ملكاته اللغوية دون تكلف، وأن يوظّف لغة الجسد وحركات اليدين والعينين وتعابير الوجه لزيادة التأثير.
هذه التوجيهات عالقة في ذهني حتى اليوم، وتعود إلى خاطري كلما شاهدت الأكاديمي والمفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي على الشاشات والمنصات؛ فالرجل يمتلك تلك الكاريزما الفطرية والحضور الآسِر، ويجيد فنون المواجهة مع الإعلاميين إجادة تامة؛ فيستحضر لغة واثقة، وإيماءات محسوبة، وروحًا خطابية تجعل المتلقي يتفاعل معه، سواء أحب ما يقول أو كرهه، اتفق معه أو خالفه. وهنا تبدأ الحكاية: أي سر يكمن وراء شخصية النفيسي التي جمعت بين الفكر والسياسة والإعلام، وأثارت حولها كل هذا الجدل، وظلت حاضرة في المشهد الفكري والسياسي لأكثر من خمسة عقود، مؤثرة في النقاش العام، ومرسخًة لنموذج “المثقف المشارك” الذي لا يكتفي بالكتابة؛ بل يخوض في الشأن العام بكل تفاصيله؟
لقد تشكّلت هوية النفيسي الفكرية الأولى في أجواء القومية العربية التي سادت ستينيات القرن الماضي. دراسته في القاهرة وبيروت، وهما من معاقل المد القومي، زرعت فيه حلم النهضة والوحدة العربية، والنضال ضد الاستعمار. لكنه، مثل جيله كله تقريبًا، وجد نفسه أمام صدمة قاسية بعد هزيمة يونيو 1967، فسقط المشروع القومي في وعيه وبدأ رحلة بحث عن بديل فكري قادر على تفسير الإخفاق وتقديم مشروع خلاص جديد.
كان التحول الأبرز في حياة النفيسي انتقاله إلى الفكر الإسلامي الحركي؛ حيث تبنّى خطابًا قريبًا من جماعة الإخوان المسلمين. ومنذ السبعينات وحتى اليوم، لمع النفيسي كأحد أبرز الأصوات الإسلامية في الخليج، ناقدًا للنخب الحاكمة، ومُبشِّرًا بدور الإسلاميين في صياغة مستقبل المنطقة. بالنسبة لمؤيديه كان هذا الانتقال علامة على شجاعة فكرية في مراجعة التجارب الفاشلة؛ أما منتقدوه فيرونه انعطافًا انتهازيًا من تيار خاسر إلى تيار صاعد.
وحين اندلعت الثورة الإيرانية عام 1979، هلّل لها النفيسي واعتبرها فتحًا إسلاميًا. غير أنه سرعان ما غيّر موقفه وأصبح من أشد المنتقدين للمشروع الإيراني، محذرًا من أطماعه التوسعية ومخاطره الطائفية على الخليج. هذا التحول تحديدًا شكّل مادة غنية للنقاش؛ فالبعض اعتبره تقلبًا في المواقف، بينما رآه آخرون مراجعة واعية تكشف قدرة المفكر على التكيف مع الحقائق الجديدة.
وقد ظل النفيسي ناقدًا شرسًا لليبرالية والفكر الغربي، معتبرًا إياهما غزوًا ثقافيًا يهدد هوية الأمة. لكنه، في الوقت ذاته، استفاد كثيرًا من تجربته الأكاديمية في الجامعات الغربية، واستعار أدوات البحث والتحليل من المدرسة الغربية الحديثة. هذا التناقض الظاهري أتاح له أن يجمع بين العمق الفكري والقدرة على مخاطبة الجمهور بخطاب شعبوي قريب إلى الوجدان.
ويقدّم النفيسي نفسه أكاديميًا ومحللًا استراتيجيًا، لكنه لم يحصر نفسه في قاعات الجامعات ومراكز الأبحاث. بل تحوّل إلى نجم إعلامي حاضر على الشاشات والمنابر، يتحدث بلغة قصصية مثيرة، ويخاطب الجمهور بعبارات مباشرة، وإن كانت في بعض الأحيان بعيدة عن الحقيقة والواقع. هذه القدرة على الانتقال بين اللغة الأكاديمية ولغة الشارع جعلته مؤثرًا واسع الحضور، لكنها في الوقت ذاته عرضته للنقد بوصفه أقرب إلى "حكواتي" أو "داعية سياسي" في أحسن الأحوال منه إلى باحث جاد يعتمد على التحليل العلمي الصارم.
ما يميز النفيسي أنه لا يثبت طويلاً على موقف واحد. من القومية إلى الإسلام السياسي، من الحماسة للثورة الإيرانية إلى نقدها، من الانفتاح على الغرب أكاديميًا إلى مواجهته سياسيًا. واليوم نجده يقف مترنحًا أمام "نظرية الإسلام هو الحل" التي آمن بها وهو يراها تتراجع وتفقد متانتها، هذه المواقف والتحولات يمكن أن تُقرأ بطريقتين: الأولى "قراءة نقدية" تعتبرها تقلبات وتناقضات، والثانية "قراءة إيجابية" ترى فيها مرونة فكرية وقدرة على المراجعة وعدم الجمود.
ولا يمكن فهم شخصية النفيسي من دون النظر إلى السياق التاريخي الذي صنعها: هزيمة 1967، الثورة الإيرانية، الغزو السوفييتي لأفغانستان، الغزو العراقي للكويت، أحداث سبتمبر 2001، ثم ما سمي بالربيع العربي. كل محطة من هذه المحطات لم تمر عليه مرور الكرام، بل تركت بصمتها في خطابه ومواقفه، وجعلت من فكره مرآة تعكس أزمات الأمة العربية وتقلباتها.
إن عبدالله النفيسي ليس مجرد اسم في قائمة المفكرين العرب، بل هو صورة لذلك العقل العربي القلق الذي يتنقل بين الأيديولوجيات والتيارات بحثًا عن الحقيقة. قد يراه البعض متقلبًا، وقد يراه آخرون مرنًا، لكن المؤكد أنه لم يستسلم لركود الفكر أو سكون الموقف.
المفكر في زمن الأزمات لا يُقاس بمدى ثباته على موقف واحد، بل بمدى قدرته على أن يظل حاضرًا في قلب النقاش، محاورًا ومجادلًا ومراجعًا لنفسه. وفي عالمنا العربي الذي تعصف به الانكسارات والتحولات، يصبح دور أمثال النفيسي هو أن يوقظ فينا ملكة التساؤل، حتى وإن لم يقدم لنا الجواب النهائي.
الأمم لا تنهض بالأجوبة الجاهزة، بل بالأسئلة التي تحرّك العقول، وبالعقول التي تجرؤ على أن تخوض معركة الفكر، مهما كان ثمنها. وهنا، ربما، تكمن القيمة الحقيقية لعبدالله النفيسي: أنه ظل طوال مسيرته يثير الأسئلة، ويجبرنا – نحن القراء والمستمعين – على أن نفكر، وأن نعيد النظر، وأن نختار بين أن نبقى أسرى الماضي أو نصنع مستقبلًا مختلفًا.
** كاتب بحريني