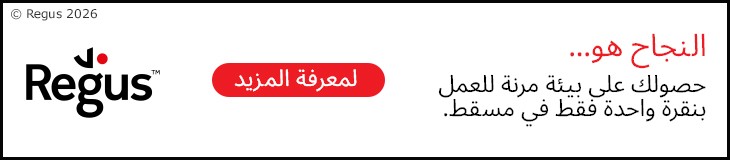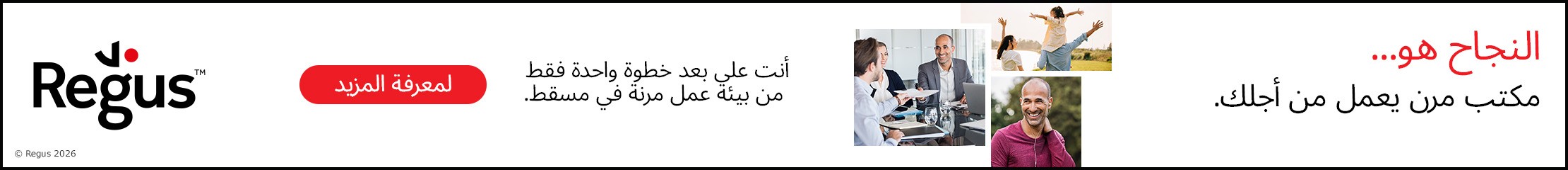خالد بن حمد الرواحي
يدخل مواطن إلى دائرة حكومية لإنجاز مُعاملة بسيطة، فيُطلب منه الانتقال إلى أخرى، ثم ثالثة، لأنَّ كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى. مشهد يومي يلخص غياب التناغم المؤسسي، ويكشف أن القرارات- مهما بدت قوية- تفقد أثرها إذا لم تجد انسجامًا بين منفذيها.
التناغم في المؤسسة يشبه النبض في الجسد؛ فإذا اختل الإيقاع تعطّلت الحركة بأكملها. فالمؤسسات في جوهرها ليست مباني أو هياكل جامدة، بل قلوبٌ وعقول بشر؛ إن انسجمت نبضاتها صنعت حياة، وإن تباينت تحوّلت إلى جسد متعب يرهق الناس بأعبائه.
غياب التناغم لا يعني بطء الإجراءات فحسب، بل يقود أيضًا إلى ازدواجية الجهود وإهدار الموارد. كم من مشروع تعطّل لأن دائرة مضت في اتجاه وأخرى في اتجاه مختلف! المواطن هنا يواجه دوامة من التعقيدات، فيما تُستنزف طاقات الموظفين في متابعة معاملات متكررة بدلًا من ابتكار حلول. على النقيض، حين تسود ثقافة التناغم تُختصر المسافة بين القرار والتنفيذ، وتتحول الموارد المحدودة إلى نتائج ملموسة تخدم الجميع.
ولعل ما نشهده اليوم من توجهات حكومية نحو تعزيز العمل كفريق واحد، يبرهن أن تجاوز البيروقراطية لا يتحقق إلا حين تُوزَّع الأدوار بوضوح وتتكامل الجهود بدل أن تتكرر.
التناغم المؤسسي ليس ترفًا إداريًا؛ بل ضرورة تُجنّب المواطن والموظف معاناة متكررة. فكم من معاملة بسيطة تحولت إلى رحلة شاقة بين أكثر من دائرة، لأن كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى! بينما كان يمكن إنجازها في زيارة واحدة لو وُجدت أنظمة متصلة وأهداف مشتركة.
والأهم أن هذا التناغم لا يقتصر أثره على المعاملات، بل يمتد إلى المشاريع التنموية ذاتها، التي تصبح أسرع وأكثر كفاءة حين تعمل الجهات المختلفة ضمن مسار واحد متكامل.
ثقة المواطن في مؤسساته لا تُبنى بالتصريحات، بل تُقاس بمدى انسجام أجهزتها في تلبية احتياجاته اليومية. فعندما يلمس أن الدوائر تتحدث بلغة واحدة وتعمل لهدف مشترك، تتعزز قناعته بكفاءتها وعدالتها. وهذا ما أكدت عليه رؤية "عُمان 2040"، التي جعلت التكامل المؤسسي والكفاءة الإدارية ركيزتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
لم يعد التناغم خيارًا داخليًا فحسب؛ بل تحوّل إلى ركيزة وطنية؛ فالتنمية، وجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات العامة، كلها أهداف تستحيل إذا ظلت المؤسسات تعمل كجزر معزولة. إن نجاح أي رؤية كبرى مرهون بقدرة مؤسساتها على التكامل، لتتحول من وحدات منفصلة إلى أذرع لجسد وطني واحد يقود التغيير بثبات.
والتحولات الأخيرة نحو بناء فرق حكومية مترابطة تؤكد أن روح "الفريق" بدأت تشق طريقها في الممارسة، بما يجعل القرارات أقرب إلى التنفيذ، ويجعل المواطن شريكًا في ثمارها.
التناغم لا يبقى حبيس اللوائح والهياكل؛ بل ينعكس مباشرة على حياة الناس. الموظف الذي يعرف مهامه بوضوح يعمل بطاقة أكبر بعيدًا عن الإحباط، والمواطن الذي يطرق أبواب المؤسسة يجد خدمته بسرعة ودون وساطات أو مراجعات متكررة. إنها معادلة واضحة: كلما انسجمت الإدارات قلّ الهدر في الوقت والجهد، وتعززت ثقة المجتمع في قدرات الدولة.
"التناغم يبدأ من الذات، وينتهي بمؤسسة تتحرك كجسد واحد لا أطراف مبعثرة."
ولأن التناغم لا يكتمل بلا جذوره الداخلية، فإن الإنسان لا يستطيع الانسجام مع زملائه وهو يعيش صراعًا داخليًا مع نفسه. الموظف المتوازن، الذي يعرف أولوياته ويضبط إيقاع يومه، هو الأقدر على الانسجام مع فريقه. فالتناغم يبدأ من الذات، ثم يمتد إلى بيئة العمل، لينعكس في النهاية على المؤسسة كلها.
ولأنَّ التناغم ممارسة لا شعار، فإنه يحتاج إلى 3 مقومات رئيسة: أولها، معرفة الدوافع وكيفية تحريكها من الداخل، وثانيها إدراك العقبات التي تعيق الانسجام؛ سواء كانت إدارية أو تنظيمية أو ثقافية، أما ثالثها فهو التوزيع الذكي للمهام على فرق العمل قبل الاكتفاء بالمسميات الوظيفية؛ فوضوح الأدوار وبناء فرق متكاملة كفيلان بجعل المؤسسة تتحرك كجسد واحد.
وهنا تبرز أهمية وجود شخصية مؤثرة داخل المؤسسة، تمتلك ذكاءً مشاعريًا وحكمةً إدارية تمكّنها من إدارة هذه الجوانب الثلاثة: تقرأ دوافع الأفراد، وتزيل العقبات، وتعيد توزيع المهام بروح الفريق لا بمنطق الألقاب. فوجود مثل هذا القائد ليس عبئًا على الهياكل؛ بل استثمار يصنع الفارق، ويحيل التناغم من مجرد نظرية جميلة إلى ممارسة يومية ملموسة.
في النهاية.. يظل التناغم المؤسسي هو الفارق بين مؤسسة تتحرك بخطى متقطعة وأخرى تسير بثبات نحو أهدافها؛ فالموارد وحدها لا تصنع الإنجاز ما لم تُدار بروح الفريق، والقرارات تبقى حبرًا على ورق إن لم تجد طريقها عبر قنوات منسجمة. إنها ثقافة "نحن" التي تجعل من كل إدارة حلقة في سلسلة متينة؛ وحين تتحول هذه الثقافة إلى ممارسة يومية، تصبح المؤسسات قوة جماعية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل بثقة وإتقان.