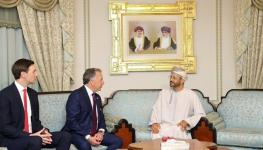بدر بن خميس الظفري
@waladjameel
نالت اللحية اهتماما واسعا ودارت حولها نقاشات عديدة تتعلق برمزيتها الدينية وحكمها الشرعي ودلالاتها الاجتماعية بل وحتى بارتباطها بمفهوم الرجولة والذكورة.
وبعيدا عن الجدل الدائر بين علماء الإسلام حول حكم حلق اللحية وإعفائها وتهذيبها وتقصيرها وصبغها وتزيينها، نستعرض في هذا المقال آراء الفلاسفة حول اللحية، ووجهات نظر الديانات السماوية والوضعية الأخرى فيها، والدلالات العقائدية والرمزية التي أسبغت عليها.
لقد اعْتنى الفلاسفة والحكماء منذ القدم بمظهر اللحية، وعدّوها دلالةً على النضج العقلي والاتزان السلوكي. ففي الفلسفة اليونانية، ظلّ الفلاسفة يحتفظون بلحاهم طوال حياتهم، ويرون في حلقها نوعًا من التهاون بالطبيعة التي جبل عليها الإنسان. يذكر الفيلسوف الرواقي إبكتيتوس، وهو أحد أشهر فلاسفة الأخلاق في القرن الأول الميلادي، في كتابه (المحادثات) أنه رفض طلب أحد الحكّام بحلق لحيته، واعتبر الأمر إهانة لفلسفته، فقال: "أنا لا أحلق لحيتي لأني فيلسوف". وقد هُدد بالقتل إن لم يفعل، فردّ بعبارة تفيد استعداده لتحمّل التبعات: "افعل ما ترى". هذه العبارة تُظهر تمسّكه بالمبدأ، لا بالشكل، فقد رأى في لحيته رمزًا لعقيدته الأخلاقية.
وقد تميّزت المدارس الفلسفية في أثينا وروما بأنماط مختلفة في هيئة اللحية: فمذهب الكلبيين، وهم أتباع الفيلسوف ديوجين، تركوا لحاهم دون تهذيب تعبيرًا عن احتقارهم للمظاهر. أما الرواقيون فكانوا يفضلون لحى طويلة مهذبة، تتناسب مع رؤيتهم للفضيلة والاعتدال. وفي المقابل، اكتفى أتباع أرسطو بلحية متوسطة الطول، تميل إلى التوازن بين المظهر والنظافة. وقد أشار موقع "سوشيال ثيولوجي" الإلكتروني إلى أن الناس في تلك العصور كانوا يميّزون الفيلسوف من لحيته، لا من لباسه أو مظهره العام.
وفي الديانة اليهودية، ورد في سفر اللاويين، أحد أسفار التوراة، تحذيرٌ لبني إسرائيل من حلق جوانب الرأس واللحية، في قوله: "لا تُقصّروا رؤوسكم مستديرًا، ولا تُفسدوا عارضيكم". وقد فُسرت هذه العبارة، وفق ما ذكره الحاخام شلومو غانزفريد في كتابه (مختصر المائدة المُعدّة) بأنها تحرِّم إزالة اللحية باستخدام الموس، أي الشفرة الحادة، لكونها تفسد ما جعله الله زينة للرجل. وبناءً على هذا التفسير، أجاز بعض الحاخامات استخدام المقص أو الآلات الكهربائية إذا لم تلامس الجلد مباشرة، لأنها لا تُعد حلقًا تامًا. كما أضاف كتاب (الإشراق)، وهو من أهم كتب التصوف اليهودي، بُعدًا روحانيًا للّحية، حيث ورد فيه أن شعر اللحية يحمل طاقة نورانية تتدفّق إلى النفس، ويرمز إلى البركة الإلهية، ولذلك يمتنع المتصوفة اليهود عن قصّ لحاهم نهائيًا.
وترتبط اللحية أيضًا بطقوس الحداد في الشريعة اليهودية؛ إذ يمتنع الرجل اليهودي عن الحلاقة لمدة ثلاثين يومًا بعد وفاة قريب، وهي فترة تُعرف باسم "شلوشيم". وقد ذكر المؤرخون أن الملك داود في العهد القديم أمر بعض جنوده بالبقاء في مدينة أريحا وعدم العودة إلى القدس إلا بعد أن تنبت لحاهم، وذلك بعدما تعرّضوا للإهانة من خصومه الذين حلقوا نصف لحاهم كنوع من الإذلال، كما ورد في سفر صموئيل الثاني.
أما في المسيحية، فلم يرد في العهد الجديد نصٌّ ملزم بخصوص اللحية. إلا أن آباء الكنيسة الأوائل قدّموا تأويلات تعبّر عن مكانتها الرمزية. في كتابه (مدينة الله)، أشار القديس أغسطينوس إلى أن اللحية تُميّز الرجل الجادّ والشجاع، وترمز إلى نضجه ومسؤوليته. وكتب كليمنضُس الإسكندري، أحد مفكري المسيحية في القرن الثاني الميلادي، في كتابه (المربي)، أن الله خلق الرجل بوجه ذي لحية، كما خلق الأسد بلبدته، ومن ثَم فإن حلقها يُعد مساسًا بالخلق الإلهي. هذه النظرة جعلت اللحية دليلًا على الرجولة الفطرية، وليست مجرد سمة خارجية.
وقد حافظ رجال الدين في الكنائس الشرقية الأرثوذكسية على لحاهم بوصفها جزءًا من هيبتهم الدينية، بينما اتجه الكهنة في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا إلى الحلاقة منذ أواخر القرون الوسطى. وخلال عصر الإصلاح الديني، اتخذ بعض القادة البروتستانت، مثل مارتن لوثر إطلاق اللحية شعارًا للانفصال عن الممارسات الكاثوليكية، كما أشار إلى ذلك جون بينغهام في كتابه (تاريخ موجز للكنيسة في إنجلترا). أما ترتليان، أحد مفكري المسيحية في شمال إفريقيا، فقد عبّر عن موقفه بوضوح حين قال: "نعمة الله لا تتعلق بشعر الذقن، بل بنقاء القلب"، مبينًا أن المظهر ليس هو موضع التفاضل عند الله، بل العمل الصالح.
وفي البوذية، يُطلب من الرهبان عند انضمامهم إلى الحياة الدينية حلق شعر الرأس والوجه، كعلامة على التخلي عن الدنيا والرغبات المادية. وقد ورد في كتاب (سلة الانضباط)، الذي يحوي قوانين الرهبنة البوذية، أن هذا الطقس يُعد شرطًا أساسيًا للزهد. وقد التزم الرهبان في دول مثل تايلاند وبورما والصين بهذه الشعيرة، ويرون في الرأس الحليق علامة على النقاء والتواضع. أما في اليابان الحديثة، فقد سمحت بعض التقاليد البوذية للرهبان بإبقاء لحاهم، وخاصة في المعابد التي تأثرت بالتيارات الاجتماعية الحديثة.
أما الهندوسية فتعدّ من أكثر الديانات تنوعًا، ولذلك تعددت رؤاها حول اللحية. بعض الطبقات كالبراهمة، وهم طبقة الكهنة، ربطوا الطهارة بحلق الشعر واللحية، بينما تمسك النُّساك واليوغيون بإطالة اللحى وشعر الرأس، بوصفها رموزًا للزهد والانفصال عن الدنيا. وقد أشار كتاب (شريعة السلوك)، وهو من كتب التشريع الهندوسي، إلى طقس "كيسانتا"، وهو أول حلق للّحية يجريه الشاب عند بلوغه، إعلانًا عن تحوّله من الطفولة إلى الرجولة. في المقابل، تُصوّرُ المنحوتات الهندوسية القديمة بعض الحكماء بلحى كثيفة وشعر منسدل، كإشارة إلى الحكمة والانسحاب من زينة الحياة.
أما السيخية، فقد أدرجت اللحية ضمن شعائرها الدينية منذ تأسيس طائفة الخالصة عام 1699 على يد الغورو جوبيند سينغ. وقد ورد في وصاياه، المعروفة باسم (الأوامر الـ 52)، أن الحفاظ على شعر الوجه والرأس من أوامر الله، ويدل على قبول الإنسان لهيئة خلقه. ولذلك يُربّي السيخي لحيته منذ بلوغها، ويعتني بها يوميًا بمشط خاص، ويلفها تحت عمامته باحترام شديد.
الزرادشتية، وهي ديانة فارسية قديمة، لم تفرض حكمًا مباشرًا بشأن اللحية، لكنها أوصت بعدم إهمال النظافة، خاصة عند قص الشعر. في كتاب (قانون الطهارة)، أحد نصوصها الطقسية، ورد أن الشعر المقصوص يجب أن يُدفن أو يُحرق بعيدًا عن مصادر الماء والنار، حفاظًا على الطهارة. وقد ظهر رجال الدين الزرادشتيون في النقوش القديمة بلحى طويلة، دلالة على الهيبة والوقار، إلا أن بعضهم في العصر الحديث فضّل الحلاقة، خاصة في البيئات الحضرية. وقد ذكرت الباحثة ماري بُويس في كتابها (الزرادشتيون)، أن هذه الممارسات تدل على التقدير الطقسي للنظافة، لا على فرض شكل معين.
حين نتأمل ما قيل عن اللحية في هذه الديانات والفلسفات، لا نجد في نظرة الإسلام إليها خروجًا عن هذا السياق، بل نكاد نلمح انسجامًا دقيقًا في الرؤية والمكانة والدلالة، هذا التماثل المثير رغم اختلاف البيئات والثقافات يفتح بابًا لتساؤل عميق: هل اللحية هي ميزة للمسلم المتدين وحده أم حكم وتقليد يخص البشر جميعا؟