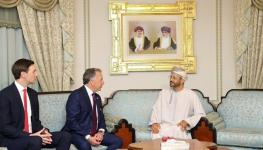حاتم الطائي
◄ التعليم القضية المُجتمعية الأولى والركيزة الأساسية لتحقيق "عُمان 2040"
◄ تمكين المُعلّم ضرورة حتميّة لتحفيزه على أداء "المهمة الرساليّة"
◄ أهمية بلورة فلسفة جديدة للتعليم تقوم على اكتساب المهارات وحُب المعرفة
بدأ العدُّ التنازلي الأخير لانطلاق العام الدراسي الجديد في مدارسنا، وقد شمّرت وزارة التربية والتعليم عن ساعديها، ببدء دوام الهيئة التدريسية صباح الأحد، استعدادًا لاستقبال الطلبة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وتوازى مع هذه الاستعدادات، إعلان حالة طوارئ في مُختلف البيوت العُمانية؛ إذ يتأهب أولياء الأمور لسنة جديدة في مسيرة تعليم أبنائهم، فيُسارعون الخطى لشراء مُستلزمات الدراسة، وإعادة ضبط الساعة البيولوجية للطلبة، بعدما اختلت عقاربها خلال الإجازة الصيفية، فضلًا عن التهيئة النفسية والإدراكية لهم، لبث الروح الإيجابية، وغرس حُب العلم في نفوسهم.. وفي خضم كل ذلك يطرح الجميع تساؤلات عدة حول مُستقبل التعليم في بلادنا، وماذا نُريد من 12 سنة دراسية قد يلتحق بعدها الطالب بالمسار الجامعي أو ربما يكتفي؟!
وعلى مدى سنوات نهوضنا الوطني، ظلّ التعليم أحد الأولويات الرئيسية التي استحوذت على جهود مُختلف فئات المجتمع، من حكومة، ومُواطنين، ومؤسسات بحثية وفكرية، وقطاع خاص، ومستثمرين، وغيرهم، وذلك من منطلق أنَّ التعليم هو الركيزة الأساسية لتطور المجتمع، والقوة الدافعة من أجل اللحاق بركب التقدم الحضاري، وألا نهضة حقيقية دون منظومة تعليمية تُعلي من شأن العلم والمعرفة وتسمو بالطالب إلى آفاق لا حدود لها من اكتساب المهارات الحياتية والخبرات العملية، وبما يؤهله إلى وضع بصمة جليّة في مسيرة النمو والازدهار الوطني.
ونظرًا لأنَّ التعليم يُمثل القضية المُجتمعية الأولى، ومحور اهتمام الجميع، فإنَّ الإسهامات الفكرية والمعرفية الرامية إلى الارتقاء بالتعليم وتنميته وتعزيز فوائده، ليس على الطالب وحسب؛ بل على كل أفراد ومؤسسات المجتمع، تتزايد وتيرتها مع بداية كل عامٍ دراسي. لكنّنا في هذا المقال لن نتطرق إلى الانتقادات واللّوم والتوبيخ الذي ينساق إليه البعض، دون طرح حلولٍ عمليّة قابلة للتنفيذ، وفي المُقابل، سنعمل على تشريح الواقع وتحليله، والمساهمة في بلورة رؤية تطويرية شاملة ومتكاملة، تكون المُرتكز لإحراز نقلة نوعية في قطاع التعليم، مع التأكيد على أنَّ كل جهد يصب في صالح التطوير، يجب أن يكون محل تقدير وقبول لدى الفاعلين في هذا القطاع الحيوي والبالغ الأهمية.
لم يعد التعليم مجرد جهود حكومية لبناء المدارس وتوفير المُعلمين ووضع المناهج وحسب؛ بل إنه صار قضية أمن قومي، دون مبالغة؛ فالتعليم النافع والمُتقدِّم والمُتطوِّر يُخرِّج أجيالًا من المُتعلمين القادرين على تولي زمام القيادة في مُختلف قطاعات العمل، ويُساعد أفراد المجتمع على بناء مسارات تنموية لم تكن قائمة من قبل، فما كان عليه مجتمعنا- مثلًا- قبل 50 عامًا، مُغايرٌ تمامًا لما وصلنا إليه الآن. وبالمثل؛ ينبغي أن نكون بعد 10 سنوات من الآن في مكانة مختلفة بالكلية عمّا نحن عليه حاليًا، فبقاء الحال من المُحال، لكن أيُ حالٍ نُريدها في المستقبل؟ وأيُ تعليمٍ نرجوه في خضم الثورات المعرفية التي تتسارع وتيرتها، ساعة تلو الأخرى، ولن أقول عامًا وراء عام! وعلينا أن نضع في عين الاعتبار مُستهدفات الرؤية المُستقبلية "عُمان 2040"، ومتطلبات إطلاق ثورة تعليمية حقيقية، لا محاولات تجريبية قد تنجح وقد لا تنجح.
تتبارى الدول في الوقت الراهن في مسارات التعليم، وآليات تطوير هذا القطاع المؤثر في مستقبل الأمم والشعوب، ولم يعد التنافس قائمًا على جودة المناهج؛ بل على طبيعة المهارات التي يكتسبها الطالب عند تخرُّجه. وأصبحت التنمية المعرفية لا تعتمد بالدرجة الأولى على ما يتلقاه الطالب داخل القاعة الدراسية، ولا في إطار المؤسسة التربوية، ولكن اشتملت هذه التنمية المعرفية حُزمة من المعارف والمهارات والمعلومات والإمكانيات التي تتطوَّر بفضل المسؤولية التشاركية بين مكوّنات المجتمع؛ من مدرسة، وأسرة، ومكتبات، وأندية ثقافية، وجمعيات النفع العام، ووسائل إعلام، ونُخبة فكرية، وبرلمان، ومؤسسات بحثية، وشركات القطاع الخاص. تتكاتف أدوار كل هذه المؤسسات والكيانات من أجل أن يصل الطالب في سن التخرّج إلى مرحلة من الوعي العميق والفهم الواسع والدراية الكاملة بمُتطلبات الحياة، ودوره المؤثر في مجتمعه، كعنصر فاعل يُضيف إلى الواقع، لا ينتقص منه.
ومن أجل ذلك، نرى 3 ركائز رئيسية إذا ما بُنيت عليها النهضة التعليمية المنشودة، فإنَّ الازدهار حليفنا، والتنمية مسارنا، والتميُّز نهجنا. الركيزة الأولى والمحورية في منظومة التطوير التعليمي، تتمثل في المُعلّم، الذي امتدحه أمير الشعراء بالبيت الذي يحفظه الجميع عن ظهر قلب، وجاء في صيغة فعل الأمر "قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا // كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولًا"، ما يعني أننا مطالبون بتنفيذ الأمر، وتبجيل المُعلّم، أيُّما تبجيل، من خلال تمكينه وتدريبه وتأهيله على النحو الذي يضمن أن يكون هذا المُعلّم بالفعل "رسولًا". ولم لا، فهو بالفعل رسول العلم، ورسول المعرفة، ورسول الفضائل التي يجب أن يتعلمها الطالب، ويكون فيها قدوة حسنة لجموع الطلبة، ورسول الكفاءة.
وتمكين المُعلّم في عصرنا الحالي، يستند على ضروريات لا غنى عنها، في المُقدمة منها: مهارات القرن الحادي والعشرين؛ إذ كيف نُطالب بها الطلبة، بينما هناك مُعلّمون ليسوا على علمٍ بها؟! ومثل هذه المهارات ما إذا اكتسبها المُعلّم ومارسها، تحققت المهمة الرساليّة له، فهو رسولٌ في محراب العلم، يؤُم الطلابَ في الحرم المدرسي، ويضيء لهم مشاعل المعرفة، وينمي لديهم حُب الاطلاع واكتساب المهارات. ولا شك أن تمكين المعلمين يرفع من كفاءتهم، ويطوِّر من مهاراتهم، وهنا أُشير إلى الدور الرائد والمحوري الذي يُؤديه المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، والذي نعوّل عليه الكثير في توفير التدريب النوعي وتنظيم دورات قصيرة مُتخصصة في مهارات القرن الحادي والعشرين، والأهم من ذلك أن تتسع أدوار هذا المعهد، لتشمل برامجه التدريبية فئات أخرى غير المعلمين الجدد، كأن تشمل المعلمين الأوائل، والذين يتقلدون الوظائف القيادية والإشرافية. وبالتوازي مع هذا التمكين، ضرورة اتباع أساليب تحفيزية للمُعلّم، ومنها أن يكون يوم المُعلّم العُماني إجازة رسمية، يشعر من خلالها المُعلّم بالتقدير الواجب والمُستحق من الدولة والمجتمع، على أن يكون يومًا احتفاليًا لتكريم المُعلّمين المُجيدين وأصحاب الإنجازات؛ ما يخلق تنافسًا شريفًا بين جميع المُعلّمين.
الركيزة الثانية في منظومة تطوير التعليم، تتمثل في: تطوير المناهج الدراسية وبلورة فلسفة جديدة للتعليم، وأول خطوة يتعين تنفيذها في هذا السياق، النظر إلى طبيعة المنهج الدراسي من حيث الكيف لا الكم، فلا داعي لوضع منهج دراسي يشُق على الطالب استيعابه، بينما من باب أولى تهيئة منهج دراسي يمنح الطالب المعرفة والمهارات التي يحتاجها في كل مرحلة دراسية، مع التركيز على الأنشطة المُحفزة للإبداع والتفكير النقدي والتحليل، والبُعد عن أي طريقة تتسبب في تجذُّر أساليب الحفظ والتلقين لما لها من نتائج سلبية بالغة. والمنهج الدراسي يجب أن يقوم على ترسيخ المعارف دون حشو زائد بمعلومات لن تعود بالنفع، أو إلزامه بحفظ جمل وفقرات كاملة لا هدف منها سوى دفع الطالب لأن يكره التعليم، بدلًا من حبه. علينا أن نغرس الشغف في نفس الطلبة، وأن يُدركوا أنَّ المدرسة بيئة خصبة لإطلاق العنان لإبداعاتهم وتخيّلاتهم لعالم أفضل، وأن عملية التعلّم لا تتوقف مع انتهاء اليوم الدراسي، لأنها عملية تحصيلية تراكمية، وليست مهمة وظيفية يؤديها الطالب داخل القاعة الدراسية وحسب.
وهذا يقودنا إلى الركيزة الثالثة، وهي: تقديم تعليم نوعي للطالب، فالتعليم ليس فقط منهاجا دراسيا؛ بل منظومة متكاملة، تشمل المُختبرات، والملاعب، والفنون؛ إذ لن تنجح أي منظومة تعليمية لا تشتمل على هذه الجوانب، فتعلّم العلوم النظرية دون تجربتها في المختبرات، يقتل الخيال لدى الطالب، وربما يدفعه لعدم تصديق هذه العلوم. كما إن عدم اهتمام الطالب أو أسرته بالأنشطة الرياضية، بدعوى أنها "غير ضرورية"، أمر بالغ الخطورة، وذو نتائج سلبية شديدة، على صحة الطالب ونفسيته. ولذلك يجب أن تكون المشاركة في الأنشطة الرياضية ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب. والأمر ذاته مع الفنون، من رسمٍ وموسيقى ومسرح (التمثيل) وفنون شعبية؛ إذ يجب أن تكون مواد أساسية تمنح الطالب درجات إضافية، حال تحقيق إنجاز، وألّا يعتبر البعض ذلك أمرًا مُستهجنًا، لأن هذه الفنون هي التي ترتقي بذائقة الطالب وتُساعده على تنمية الإبداع. وهذا التعليم النوعي المنشود، قد تحقق جزء منه، باعتماد مسارات التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي، لكن الأهم من ذلك النتائج المرتقبة على المدى المتوسط.
ويبقى القول.. إنَّ تطوير التعليم ليس مُهمة موسمية، أو إجراء مؤقتًا؛ بل عملية متواصلة لا تتوقف، ومسؤولية تشاركية يتعين على الجميع من مؤسسات وأفراد، الإسهام فيها، دون تقاعس أو سلبية، وأن تكون رؤية "عُمان 2040" المُنطلق الذي نمضي من خلاله نحو الأهداف المرجوة؛ كي نرى أبناءنا مُتسلحين بالمهارات التي تؤهلهم لقيادة هذا الوطن في شتى قطاعاته.