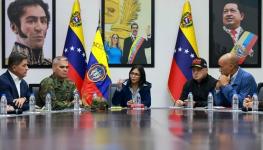د. عبدالله باحجاج
فكرة العقود المُؤقتة، وراؤها فكر ينسخ التجارب الخارجية ويوطّنها دون دراسة مدى مواءمتها لبيئتنا العُمانية، لا نتفق على أنَّ البعد الغائي من فكر العقود المؤقتة هو إيجاد حل لقضية الباحثين عن عمل، فهذا قد أصبح متجاوزًا، ودليلنا، القرار الوزاري رقم (97/ 2022) القاضي بشغل الوظائف الدائمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بعقود؛ إذ إنَّ فكر العقود المؤقتة ليس صناعة عمانية، وإنما أجنبية، وهو من الألغام التي أُريد زراعتها في الدول ذات الأبعاد الاجتماعية والأيديولوجية لتفكيك روابطها، وجعلها منشغلة بلقمتها اليومية، دون أن ترفع رأسها للقضايا الأخرى التي لا تمس حدود المعدة.
ونسخُ هذا الفكر في بلادنا ينبغي قراءته بعقلانية عالية الوطنية، وبتفكير سياسي عميقٍ، وفوق المبررات التي تستند إليها السياسات والقرارات الوزارية، كقرار تحديد الحد الأدنى للأجور عند 325 ريالًا؛ لأننا هنا في مرحلة تأسيس مرحلة متجددة لدولتنا المعاصرة، ولن يكون هذا التأسيس من العدم، وإنما على أسس ثابتة وأخرى متغيرة، فلا يمكن تطبيق أيّة أفكار وقرارات وسياسات إلّا بعد دراستها من كل النواحي، خاصة إذا ما كانت تمس المنطقة الاجتماعية.
وعند إمعان الفكر في التحوُّل نحو فكرة العقود المؤقتة القابلة للتجديد أو المحددة بأجل زمني نهائي، فإن من المُلاحَظ ظاهرة استفراد السلطات الحكومية والعمومية والخاصة بالقرار في كلتا الحالتين، وحتى دون حق المواطن في اللجوء الى القضاء، فهذه السلطات قد حصّنت قراراتها بقانون إنهاء العقود دون إبداء الأسباب. وهنا يكون لتلكم السلطات سلطة مُطلقة في بقاء أو إنهاء العقود؛ فلا ضمانات هنا للحقوق.. وهنا ينبغي استنطاق النتيجة المترتبة على ذلك، وهي:
العقود الدائمة أو المؤقتة تعدُ من أهم وأخطر الأدوات التي تعيد صناعة المجتمع عامة، فهي أداةٌ تصنع مجتمعًا جديدًا تهز روابطه التأسيسية السابقة، وتعومها في كل الاتجاهات بعد ما كانت رأسية حصرًا، وتبني جيلًا متوترًا ومنهزمًا وضعيفًا، دون ممكنات لمقاومة التحديات والاختراقات الداخلية والخارجية. وقد أصبحت هذه التحديات الآن معلومة، وسيصبح من يؤمِّن لهم الوظيفة الآمنة هو الذي ستجنح إليه الولاءات والانتماءات والروابط، وهذا يعني أننا نشهد تحولًا نوعيًا وكميًا في هذه المنطقة الحساسة جدًا، التي تختزن معظم مقومات الاستقرار.
فكيف إذا ما علمنا بالتحولات السياسية الإقليمية الجديدة، وتقاطعاتها الدولية داخل منطقة الخليج، وانكشاف أجندتها السياسية والأيديولوجية.. هنا تظل قضية الروابط والانتماء والولاء والقيم والمبادئ خطًا أحمرَ، فبقاؤها في أفقها الرأسي ينبغي أن يكون في سُلم أولويات كل جهة حكومية، وعلى رأسها السياسة المالية، وهذا لا يعني استبعاد التطوير داخل هذا المنطقة؛ بل العكس، لكنه ينبغي أن يكون تطورًا ذكيًا، يُحافظ على الثوابت في إطار تحديث المجتمع وعصرنته بما يتناغم مع مفهوم التجدد للدولة المعاصرة، وهناك مساحة كبيرة للتطوير وفق فلسفة البناء على الواقع، وليس هدمه، ومن ثم البناء عليه.
وهنا نقترحُ فتح هذا الملف من الزوايا الحادة الني نتناولها الآن، ومن قِبل مؤسسة متخصصة في تقييم السياسة المالية والقرارات الوزارية وآثارها السياسية والاجتماعية على مُستقبل أركان الدولة الأساسية، ومن منظور تحدياتها الداخلية والإقليمية والعالمية، فلا يُمكن ترك مثل هكذا تقييم عاجل، ونكتفي بتدخلات مقتضبة ومحدودة لأصحاب الدخل المحدود وفئات الضمان الاجتماعي، وذلك حتى لا نتفاجأ بأسوأ الاحتمالات- لا قدَّر الله- فكل شيء ينبغي منذ البداية أن يكون تحت السيطرة، وهذا لن يكون إلّا بمعرفة نتائج أو تداعيات السياسات والقرارات مسبقًا، والتأكُد منها بعد فترة زمنية، ومن ثم: هل ينبغي الاستمرار فيها أم تعديلها وتطويرها؟
والدافع وراء فتحنا لهذا الملف الآن يكمن في عدم وجود اهتمام به، من أي نوع من الاهتمامات، خاصة في المرحلة الراهنة التي يمكن توصيفها بعودة عصر النفط وتزامنه مع عصر الغاز الذهبي، وبالمستقبل الذهبي الواعد والآمن لتحولات الدولة التالية: الاقتصاد الهيدروجيني، والعصر الذهبي الجيوستراتيجي والجيوسياسية لبلادنا في العالم الجديد، والعصر الذهبي السياحية الذي يحتاج لفكر وجهد جديد ينقله لهذا العصر في ظل توفر كل مقوماته في بلادنا، وبعصور مماثلة واعدة لو عملنا عليها من الآن، مثل جعل بلادنا مركزًا إقليميًا عالميًا للغذاء، ومركزًا عالميًا لإعادة التصدير في العالم الجديد.. إلخ.
ولا يبدو أن الفكر الذي نسخ فكرة العقود المؤقتة، يُدرك أن البلاد قد انتقلت من مرحلة الأزمة النفطية ومخاطرها على مديونية بلادنا، إلى أبهى عصور مواردها المالية، ولا يدرك تلكم العصور الذهبية التي تفتح التفاؤل على مصاريعه، فلم يرفع رأسه لمشاهدتها، كما إنه لم يرفع رأسه لاستشراف منتجات فكره على المجتمع والجيل الجديد، ومن ثم على مستقبل الاستقرار الاجتماعي في حقبة الضرائب والرسوم وتقليص حجم الإنفاق الاجتماعي، فلن يعدل أو يغير من سياساته المالية القاسية، ولا من القرارات الوزارية التي تستمد جوهرها منها.
سيظل فكره كما لو أن بلادنا لا تزال في ذروة الأزمة النفطية، ومخاوف نزول الأسعار النفطية إلى 10 دولارات، رغم أن الظرفية المالية والآثار الاجتماعية لهذه العقود بدأت تظهر فوق السطح بصورة مقلقة، وعليه الانتقال سريعًا إلى فكر الدولة الذي صنعت منظومات الروابط والانتماءات بين سلطتها السياسية والمجتمع، والاعتماد على مسار العقود الدائمة والمؤقتة يسحب الدور التاريخي من الدولة، ويسلمه لشركات ربحية، ولشركات لها أجندات مبطنة، وسلطات غير واعية سياسيًا بتأثير قراراتها وسياساتها المالية على الدولة سياسيًا واجتماعيًا وأيديولوجيًا.
تشغلني كثيرًا في هذا الملف- وهو انشغال مرحلي- الآثار السيكولوجية الاجتماعية الناجمة عن العقود المؤقتة، وآثارها الآنية والمستقبلية؛ فالآنية فإنها قد أصبحت تشكل ورطة للباحثين عن عمل وأولياء أمورهم، وقد رصدتها في عدد من الصور، سأكتفي باثنتين منها. فقد التقى بي ولي أمر في حالة استياء وتذمر كبيرين من إنهاء عقد ابنه المؤقت بسنتين في إحدى شركات النفط، وبعد يوم، وجدت نفسي في إحدى الجلسات، وبجانبي ولي أمر يفتح معي إنهاء عقد ابنه المؤقت بشهرين في مؤسسة حكومية، ففي الحالة الأولى مثلًا، يجد الابن مع زوجته وولده عالة على راتب أبيه المتقاعد (1200 ريال)، ويجد الاب نفسه الآن في ورطة مماثلة في الإنفاق على أسرته وعلى أسرة ابنه بهذا الدخل. إنهما حالتان من الحالات التي تفرزها العقود المؤقتة، ويمكن القياس عليها.
فماذا نتوقع من احتمالات لمثل هذه الآثار السيكولوجية الفردية والاجتماعية في حالة تعميمها وترسيخها داخل المنطقة الاجتماعية الحساسة جدًا، فكيف إذا ما انضمت إليها الآثار السياسية في حقبة الضرائب وانفتاح البلاد؟ لذلك فلنسارع في مراجعة متكاملة وذكية لكل السياسات المالية والقرارات التي اتُخذت منذ يناير 2020 وحتى الآن؛ فالمرحلة الراهنة وكل آفاقها مطمئنة، ومواتية لهذه المراجعة.