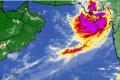علي بن سالم كفيتان
"الميطان" هي شجرة الزيتون البري التي تنمو طبيعيًا في سفوح ظفار وجبال الحجر، وتُسمى في الشمال بـ"العتم"، ويعد خشبها هو الأقوى؛ فصار مادة البناء الرئيسية لسقف المنازل والحظائر الحيوانية لحقب خلت، كما تُعد عصي الميطان أو العتم هي الأطول عُمرًا والأكثر صلابةً؛ لذلك استخدمها الريفيون لحماية أنفسهم من عوامل الطبيعة ومن شرور الأعداء، فقريتنا الحجرية القديمة لا يكاد يخلو بيت فيها من الميطان؛ حيث تتوسط بيت العائلة كوتدٍ يحمل جميع أطراف السقف المخروطي المنحدر إلى الجدار، بينما الحجر هو المادة الثانية المتوفرة بسهولة في كل الأنحاء، فشكّل الميطان والحجر ثنائيَ قريتنا المنغمسة في أكليل الريف الظفاري الحالم.
يصحو الجميع منذ الخيط الأول للنهار ليندفع إلى الخارج، وقبل أن تغسل وجهك سترى أعمدة الدخان تتصاعد من كل أطراف القرية؛ فهو طقس يومي لإبعاد الحشرات عن المواشي، وثغاء الأبقار المتحفزة لإرضاع أبنائها يتهادى من كل مكان، وشيئًا فشيئًا تسمع أصوات الناس الخارجة من البيوت تختلط بسيمفونية خض الحليب التي تعزفها النساء المتسمرات في الفناء، إنها المهمة الأولى لهن في هذا النهار الطويل. فقربة الحليب الرائب مُعلقة بحبلين على ثلاثة عصي مربوطة من الأعلى، وتجلس المرأة في الأسفل لتخضها بحركات متوازنة نحو الأمام والخلف، وتستمر العملية حسب كمية الحليب، بينما يتسابق الأطفال لجلب صفرية الروب ويكون محظوظًا من يظفر بلعق متبقيات السمن على الملعقة الخشبية، في حين يجمع الآخرون ما تناله أيديهم على أطراف الصفرية الضخمة من جزيئات منسية، وفي بعض الأحيان تتكرم عليهم الأم وتطلب منهم إحضار ما يُعرف بلهجة أهل الريف "مُلحك"؛ وهو فرع صغير من أي شجرة حية، شكله كالسواك، ثم تُسخن لهم كمية من السمن وتضعه أمامهم في صحن ليلعقوه بهذه الأغصان الغضة. وما إن تفتح عين وتغمض أخرى حتى ترى الصحن نظيفًا خاليًا وكأنه لم يزره السمن يومًا.
الرجال يتجهزون لحلب الأبقار بلبس الثياب المُلقاة على طرف الزريبة، وغالبًا تكون وزارًا وقميصًا قد أكل عليهم الدهر وشرب ولفحتهم الشمس وأشبعهم المطر، وسدت كل فراغاتها، فباتت متخشبة، وأمام هذا المشهد يقوم الرجل بفركهم ومن ثم نجفهم في الهواء ليستطيع لبسهم قبل بدء أي عملية جديدة، ثم يتجوّل في المكان ويدس النار بالمزيد من السماد لتتصاعد الأدخنة البيضاء حتى تغطي الأنحاء وتنعدم الرؤية، فتغادر الحشرات مرغمة، بينما تتمتع الأبقار بالاقتراب من الموقد لتطرد ما تبقى من الذباب المشاكس. تنطلق النساء الريفيات وعلى رؤسهن صفاري الحليب الفارغة الضخمة، بينما الأطفال يأخذون صحلة الحليب بعد أن تم غسلها في المنزل ووضعها على النار، حتى تكون نظيفة؛ فالبعض يعتقد أنه في حال الحلب بصحلة باردة أو متسخة فإن المواشي تمرض وتعطب ضروعها.
في ذلك اليوم الذي كنتُ فيه مريضًا ولم أشارك معهم، جلستُ على عتبة البيت مُراقبًا قريتي؛ فالأولاد مهمتهم إطلاق العجول بشكل مُنتظم لترضعهم أمهاتهم، ومن ثم إجبارهم على العودة قبل أن تنال حظها من الحليب، وهنا يكون الصراع بين الصبي والعجول الجائعة، وعندما يفقد العجل الأمل برشفة حليب أخرى يلقمه الصبي كرة من العلف والطحين؛ كتعويض عن الخسارة، ولا تخلو العملية من جروح فغالبًا تجد أظافر الأولاد تم اقتلاعها أو أصابتهم كدمات من إطلاق العجول وجرها يوميًا، بينما يحلب الرجل بانتظام وتقوم المرأة بتفويج الأبقار للحلبة أو طرف السور، وضمان عدم تدفق أكثر من واحدة على العلف. أثناء العملية يكون حليب البقرة الأخيرة من نصيب الصبي وما تركه يرتشفه الرجل الذي يتجرد سريعًا من لبس الحلب ويُعيد هندامه الأنيق مجددًا. وهنا يعود الجميع إلى المنزل، فتكون البنات قد أعددن الشاي ونظفن البيت والفناء وغسلن المواعين، وما أن تظهر الشمس حتى يكون الجميع في القرية قد أنهوا أعمالهم الصباحية.
شيبان القرية يتربعون على العتبات يحملقون في الأبقار التي يتم اقتيادها للمرعى، فيقول أحدهم هذه مريضة، وهذه ستلد قريبًا، وهذه يجب تنظيفها من الحشرات العالقة، يجتمع حولهم الناس قبل فرز من يرعى الأبقار ويقوم على سقايتها من العين، وهنا تنطلق الضحكات والنكت على مائدة الفطور المكون في الغالب من الشاي والحليب الساخن، وبعدها يتفرق الجمع كل في مهمته..
اليوم لا تكاد ترى في القرية سوى بقايا جدران الحجر التي غزاها الطابوق وبعض أغصان الميطان الجاثمة على الحظائر القديمة... فقد غادر الجميع وهجروا قريتهم إلى غير رجعةٍ.