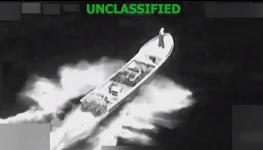د. سيف بن ناصر المعمري
لا تزال السفينة عالقة منذ زمن طويل برهائنها في وسط البحر؛ يواجهون خطر الأنواء وأيضًا خطر خاطفيهم الذين يبحثون عن من يكترث لهم لكي يتفاوضوا معه لإنقاذ حياتهم، بدلاً من قتلهم واحدا تلو الآخر، يحاولون مع حكومتهم علها تهرع بكل مؤسساتها وقواها وعلاقاتها الدولية لتنقذهم لكنها تفاجأهم بلا مبالاتها، ويتساءلون أيعقل هذا مواطنون مخطفون وحكومتهم لا تأبه بهم؟
في ظل ذلك الصمت يظهر التربوي نمر فريحة محاولاً إنقاذ السفينة بمفرده، أتراه كان لا يُدرك أن المهمة كما يصفها فرويد "مستحيلة"، أم تراه كان حالماً بأن موقفه سوف يؤثر في حكومته ورجالاتها ويحرك فيهم غيرة إن لم تكن من أجل رهائن السفينة فلأجل مجدهم الذي لا شيء يحركهم غيره في كل ما يقومون به، أما تراه كان يعول على التأثير في قلوب الخاطفين إن فشل في التأثير في قلوب الحاكمين، لا أعرف ماذا كان يدور في رأس الدكتور نمر فريحة حين خرج من ضيعته البسيطة لتحرير السفينة، كان أعزلاً من كل شيء إلا من الكتاب الذي عده السلاح الأفضل من كل سلاح، فهو لا يحدث كل الدمار الذي تحدثه الأسلحة الأخرى التي تشترى بملايين الدولارات والتي رأى مفعولها في طريقه حيث الحرب الأهلية تدمر كل شيء.
وتساءل لماذا يتحاربون مع بعضهم البعض وينسون رهائن السفينة؟ كان سؤالا مؤلماً له عرف إجابته في مرحلة متأخرة جدا من عمره ..إنهم يتحاربون من أجل اقتسام الوطن لا من أجل بنائه، ولو كان الوطن يعنيهم في شيء لما تجاهلوا المختطفين في السفينة التي ظل الدكتور نمر يناضل طوال عمره من أجل استنهاض وعي الناس من خلال التربية الوسيلة التي آمن بها كوسيلة تغيير سلمية للحفاظ على إنسانية الإنسان من القهر والاختظاف، ما قيمة الإنسان المختطف داخل وطنه؟ ما قيمة الإنسان المهدور في وطنه؟ ما قيمة الإنسان المهزوم داخل وطنه؟ كيف يمكن لجيش من المهزومين أن يحافظوا على وطن من أن يختطف من قبل جماعة صغيرة؟ أنها الأسئلة العميقة التي واجهها نمر فريحة في طريقه التربوي طوال خمسة عقود واصل فيها الليل بالنهار يكتب ويبحث ويجدد النظريات والمنهاج، ويقارع الأفكار بالأفكار، لم ييأس ولم يستسلم أمام كل الضغوطات التي واجهها ليتخلى عن السفينة ورهائنها ونسيانهم، هل قرر أن يوقف هذا النضال التربوي أخيرًا؟
لقد آلمني ما جاء في مقدمة الكتاب الأخير للدكتور نمر فريحة والذي أهداني أياه الأسبوع الماضي وعنوانه "المواطنة العالمية والمواطنة الرقمية وما بينهما"؛ حيث أكد أنه الكتاب الأخير له في مجال تربية المواطنة، وقبل الأخير في مجال التربية بشكل عام، وأعرف ما يعنيه ذلك الكلام حيث كنا أنا وهو نحمل ذلك الأمل ببناء مواطنين لا يمكن أن يخطفوا بسهولة. التقينا منذ سبعة عشر عاما في شهر سبتمبر في البحرين مع آخرين في مؤتمر لتعزيز المواطنة، لكن ما حصل أننا اكتشفنا أن الأمور بدلا من أن تمضي إلى الأفضل، مضت إلى الأسوء في الوطن العربي، وأن المواطنة المنشودة صارت بعيدة المنال، والطريق إليها طويلاً وشائكاً، وأن المؤسسة التربوية التي كان نمر فريحة يضع ثقته فيها لتخليص رهائن السفينة، أصبحت هي نفسها مؤسسة رهينة وأتوقع أنه في طريقه ليعلن خلاصة ربما تكون مخيبة لآمال كثير من التربويين في كتابه الأخير، وكأنه يقول فيه ما قاله الشاعر ريتسوس "على ما صنعت وما لم تصنع الحسرة هي نفسها أيها الضوء السري المتكاثر في المرايا المهشمة"، ما أصعب أن تتساوى الأمور، وتتساوى النتائج، وما أصعب أن تظل المرايا مهشمة، والصورة مهزومة، والأشياء في غير أماكنها، ويتحول المواطنون إلى رهائن مستسلمين لأقدارهم التي حاول نمر فريحة أن يغيرها بالتربية، لكن هذه التربية ليست حرة كما تصورها وبالتالي كيف لتربية غير حرة أن تنتج مواطنين أحرارا قادرين على مقاومة خاطفيهم.. وقيادة سفينتهم إلى الشاطئ الآمن.
إنه الطريق الصعب والمحبط في كثير من الأحيان الذي مضى فيه الدكتور نمر فريحة وآمن به، وأعرف أن القرار الذي يتخذه اليوم بالتوقف عن تحرير السفينة صعبًا، ربما لأنه يرى أن هناك طريقًا آخر يمكن من خلاله أن ننقذ السفينة حين فشلنا من خلال التربية، إنه الأدب الذي ربما يقود إلى إيقاظ الناس من سباتهم لكي يصنعوا عالما تكون القيمة فيه للمعرفة والأدب والقراءة كوسائل للخلاص والتحرر، لا أعرف ما الذي يدور في ذهن الصديق الدكتور نمر ولكن على يقين أنه لم يقل كل ما يود قوله.. وإنها ربما مرحلة التأمل في ما مضى من حياته الحافلة بالبحث والتنقيب والمقاومة خاصة حين وجد نفسه في صدام مباشر مع أولئك الذين كانوا يعنيهم أن تغرق السفينة بكل رهائنها في البحر، واجههم وهو أعزل من كل شيء إلا من الكتابة، ووضع لهم كتابًا يوثق فيه استهانتهم بالوطن ومن فيه، وقال لمن حوله: سيذهبون وسيبقى الكتاب للأجيال القادمة ليعرفوا أن السفينة ما كانت لتواجه كل هذا التأزم لولا هؤلاء، ولذا سوف يظل السؤال يطارده أينما ذهب: لمن سوف تترك سفينة الرهائن يا دكتور نمر؟
ربما نحصل على إجابة على مثل هذا السؤال منه، وهو القريب هنا في مسقط التي وهبها عشر سنوات من حياته الحافلة، ووهبته السكينة التي قادت إلى ولادة كثير من كتبه التربوية والأدبية، وإن ترك السفينة لن يترك مسقط، ولن تتركه مسقط، فهناك جسر روحي لا يُمكن أن ينفصل، ستعبر من خلاله ذكريات كثيرة ربما لا تتسع دفتي كتابه لتدوينها، كما لا تتسع تلك الدفتين لأدون فيها ما جرى بيننا من نقاشات تربوية وأدبية هنا وفي بيروت طوال تلك السنين.