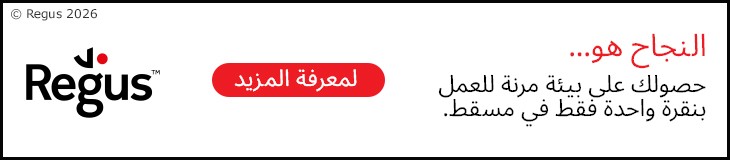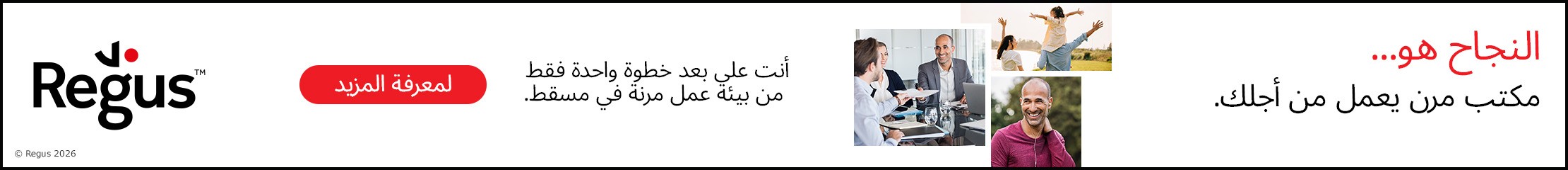خالد بن حمد الرواحي
في كل صباحٍ نبدأ اليوم بالخطوات ذاتها؛ نغادر منازلنا إلى المدارس أو المكاتب، نشتكي من ازدحام الطرق وبطء الإجراءات، ثم نعود آخر النهار متذمّرين من النتائج نفسها. كأن الزمن يدور في دائرةٍ مغلقة لا تنكسر. وكما قال أينشتاين: «من الجنون أن نكرّر الأفعال ذاتها ونتوقع نتائج مختلفة». ومع ذلك، ما زلنا في مجتمعاتنا نعيد الأنماط نفسها جيلًا بعد جيل؛ نُربّي أبناءنا بالطريقة ذاتها، ونُدير مؤسساتنا بالعقلية نفسها، ونتعامل مع تحديات التعليم والعمل بأدواتٍ لم تعد تصلح لعصرٍ تغيّر فيه كل شيء… إلا نحن.
نعيش اليوم مفارقةً لافتة؛ فكل جهة تُحمّل الأخرى مسؤولية الواقع، بينما الجميع يسير في الدائرة ذاتها. الأسرة تُطالب الحكومة بتوفير الوظائف، والحكومة تُنادي بتطوير التعليم، والمؤسسات تشتكي من ضعف الكفاءات، والطلاب ينتظرون فرصةً تطرق أبوابهم. ومع ذلك، لم نسأل أنفسنا بصدق: هل غيّرنا نحن شيئًا في طريقة تفكيرنا أو تربيتنا أو إدارتنا؟ ما زلنا نُدرّس أبناءنا ليحصلوا على «وظيفةٍ آمنة»، لا ليصنعوا فرصهم بأنفسهم، ونُقيم البرامج ذات الشعارات المكرّرة، ثم نستغرب أن النتائج لا تختلف عمّا كانت عليه قبل أعوام.
ترسّخت في وعينا الجمعي فكرةُ أن الأمان لا يتحقق إلا بوظيفةٍ حكومية، وأن النجاح يُقاس بعدد سنوات الخدمة لا بما نُنجزه خلالها. هذه الثقافة نشأت حين كانت الدولة المحرّك الرئيس للاقتصاد ومصدر الفرص. غير أن الزمن تغيّر، وتغيّر معه شكل العمل، بينما بقيت عقولنا أسيرةَ المفهوم القديم. ما زال الشاب يدرس لسنوات لينتهي إلى مقعدٍ خلف مكتبٍ حتى لو كان بلا جدوى، وما زالت الأسرة تزرع في أبنائها الخوف من التجربة، فتغدو الوظيفة غايةً بحدّ ذاتها لا وسيلةً للعطاء والإنتاج.
المدارس والجامعات ليست بعيدة عن هذه المعادلة؛ فما زالت مناهجنا تُخرِّج طلبةً يجيدون الإجابة في الامتحان أكثر مما يجيدون حلّ المشكلات. يغيب عنهم التدريب العملي وروح المبادرة، فينشأ جيلٌ ينتظر من يوجّهه بدل أن يبتكر طريقه. وكم من شابٍ يملك مهارةً في التصميم أو البرمجة أو الحِرَف التقنية الحديثة، لكنه يختار الانتظار بدل أن يبدأ مشروعه الصغير؛ فيخسر الزمن وتخسر الدولة طاقاته.
لقد أثبتت التجارب العالمية أن التحول الاقتصادي يبدأ بثقافة العمل قبل السياسات؛ فاليابان لم تنهض بالقوانين وحدها؛ بل غيّرت مفهوم العمل والانضباط في وجدان مواطنيها. وسنغافورة لم تبنِ اقتصادها بالموارد الطبيعية؛ بل بثقافة الإتقان والمسؤولية الفردية. وكذلك نحن، لن نصل إلى التغيير الحقيقي إلّا إذا بدأنا بتغيير العقلية التي تُدير علاقتنا بالعمل والفرص.
وفي السنوات الأخيرة، اتخذت الدولة خطواتٍ مهمة لتعزيز ثقافة العمل الحُر عبر برامج التمويل والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات التدريب وريادة الأعمال. غير أن هذه الجهود لن تؤتي ثمارها ما لم تتغيّر النظرة الاجتماعية إلى المهن الحرة، وما لم يدرك الشباب أن قيمة العمل لا تُقاس بنوع المهنة؛ بل بعائدها وأثرها. فحين نحترم الحرفي كما نحترم الموظف، ونُقدّر رائد العمل كما نُقدّر صاحب المنصب، نكون قد وضعنا حجر الأساس لتحوّلٍ ثقافيٍّ واقتصاديٍّ حقيقي.
إنَّ التغيير الحقيقي يبدأ من تعديل طريقة التفكير داخل البيت والمدرسة والمؤسسة. حين نغرس في الطفل قيمة الاعتماد على النفس، ونفتح أمام الشاب أبواب التجربة دون خوفٍ من الفشل، يصبح العمل الحر خيارًا طبيعيًا لا مغامرة. وعلى المؤسسات أن تتبنّى ثقافةً تُكافئ المبادرة لا الالتزام الأعمى بالتعليمات، بينما تقع على الحكومة مسؤولية تهيئة البيئة التشريعية والتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات، وتقديم التسهيلات والإعفاءات من الرسوم والضرائب خلال السنوات الأولى من تأسيس المشروع، وربط التعليم بسوق العمل. هذا التحوّل يتسق مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» في التنويع الاقتصادي ورفع الإنتاجية وتمكين الشباب.
المستقبل لا يُمنح لمن ينتظر؛ بل يُصنع على أيدي من يملكون شجاعةَ كسر الدائرة والبدء من جديد. وحين نغيّر الأفعال، سنكتشف أن «المعجزة» لم تكن بعيدة؛ بل كانت فينا منذ البداية.