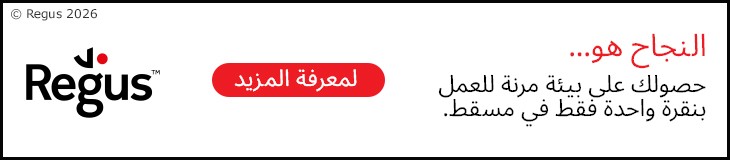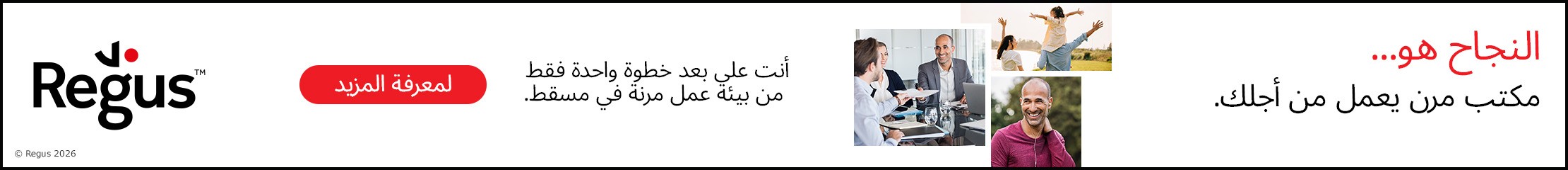عارف بن خميس الفزاري **
على مدى عقود، شكّلت المعالجات التقليدية حجر الزاوية في تطور الحواسيب الحديثة. فقد ارتبط اسم شركة إنتل بمسيرة متواصلة من الابتكار منذ إطلاق الجيل الأول من معالجاتIntel Core عام 2008، مرورًا بتطورات لاحقة وصلت إلى معالجات Core i9 التي مثّلت معيار الأداء الفائق في الحواسيب المكتبية والمحمولة. ومع ذلك، بدأت الشركة في السنوات الأخيرة بتغيير نهجها، إذ تخلّت عن حرف (i) في أسماء معالجاتها، لتصبح الفئات الجديدة ببساطة Core 3 وCore 5 وCore 7، إلى جانب فئة أعلى أداءً تحمل اسمCore Ultra والتي تضم معالجات Ultra 5 وUltra 7 وUltra 9 ويعكس هذا التغيير تحوّلًا استراتيجيًا من جانب إنتل بعد أن بلغت حدود التطوير الممكن ضمن مسار المعالجات الكلاسيكية.
وبحسب والدرُوب (2016) فقد أوضح أن قانون مور، الذي افترض أن عدد الترانزستورات على الشريحة يمكن أن يتضاعف كل عامين تقريبًا، لم يعد يسير بالزخم نفسه كما في العقود الماضية. فقد بيّن أن الصناعة باتت تواجه حدودًا فيزيائية وحرارية عند محاولة تصغير أحجام الترانزستورات، مما جعل تحقيق القفزات المُتسارعة في الأداء أكثر صعوبة وكلفة. وأكد أنّ هذه التحديات التقنية تفرض إعادة التفكير في جدوى الاعتماد على نهج التقليص المستمر وحده لمواصلة تحسين الحواسيب.
وفي هذا السياق أوضح الباحثان نيلسن وتشوانغ (2010) أن الحوسبة الكَمِّيّة تمثل نقلة نوعية مقارنة بالحوسبة التقليدية. ففي حين تعتمد الحواسيب المعتادة على وحدات معلومات محدودة لا تستطيع إلا أن تعبر عن حالتين بسيطتين، فإنَّ الحواسيب الكَمِّية تمتلك وحدات أكثر مرونة تتيح التعامل مع إمكانات متعددة في اللحظة نفسها. هذا الفارق الجوهري يجعل الحوسبة الكَمِّيّة قادرة على معالجة مسائل أعقد بكثير، وبسرعة تتجاوز قدرات الحواسيب التقليدية بمراحل.
ووفقًا لتقارير المفوضية الأوروبية (2021)، فإنَّ الحوسبة الكَمِّيّة، وبرغم أنها ما تزال في بداياتها، تتطور بوتيرة متسارعة في ثلاث ركائز رئيسة: الحوسبة والاتصالات والاستشعار الكمي، مع توقعات بأن تدخل مرحلة الاستخدام التجاري الواسع خلال العقد القادم. وفي السياق نفسه، أثبتت دراسة آريوت وزملاؤه (2019) في شركة Google ما يُعرف بـالتفوق الكمي، حين تمكن معالج مكوّن من 53 كيوبت من إنجاز عملية محددة بسرعة تفوق قدرات أقوى الحواسيب التقليدية بمليارات المرات، وهو ما يُعد دليلًا عمليًا على الإمكانات الكبيرة لهذه التقنية.
وعلى المستوى الدولي، تستثمر شركات عملاقة مثل Google وIBM وMicrosoft مليارات الدولارات لتحقيق ما يُعرف بـالتفوق الكمي. ووفقًا للمفوضية الأوروبية (2021)، فقد خصصت الحكومات ميزانيات ضخمة لتطوير بيئات بحثية متكاملة، حيث رصد الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج Quantum Technologies Flagship ميزانية مقدارها نحو 1.05 مليار دولار أمريكي لدعم الأبحاث والتطبيقات الكَمِّيّة على مدى عشر سنوات. كما أشار المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي (2023) إلى أنّ البيانات التحليلية الحديثة تُظهر أن حجم الاستثمارات الحكومية المعلنة في تقنيات الحوسبة الكَمِّيّة على مستوى العالم قد تجاوز40 مليار دولار أمريكي حتى عام 2023، شملت أكثر من ثلاثين دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد بدأت دول الخليج العربي في رسم ملامح حضورها في هذا الميدان الواعد. ففي الإمارات العربية المتحدة، أسس معهد الابتكار التكنولوجي (2023) في أبوظبي مركزًا متخصصًا لأبحاث الحوسبة الكَمِّيّة، يُعرف بـ Quantum Research Center، يركّز على تطوير أنظمة التشفير الكمي والاتصالات الكَمِّيّة وتطبيقاتها. أما في قطر، فقد دشّنت جامعة حمد بن خليفة (2023) مركز قطر للحوسبة الكَمِّيّة (QC2)، وأطلقت مختبرًا وطنيًا للحوسبة الكَمِّيّة بتمويل قدره 10 ملايين دولار أمريكي، يهدف إلى دعم التطبيقات العلمية والتقنية في مجالات استراتيجية مثل الكيمياء الكَمِّيّة والأمن السيبراني.
وبالنسبة لسلطنة عُمان، فإنّ أهمية هذه الثورة التقنية تتضح عند ربطها بأهداف رؤية عُمان 2040، التي تؤكد على بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، مع استيعاب الثورات الصناعية الحديثة وتحقيق الاستدامة المالية. وفي هذا الإطار، يمكن للحوسبة الكَمِّيّة أن تفتح 3 مسارات حيوية: توطين الصناعات التقنية عبر تطوير البرمجيات الكَمِّيّة وإنشاء مختبرات متقدمة لتصميم مواد جديدة للطاقة المتجددة. وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال تسريع عمليات التعلم الآلي والتحليل الكمي للبيانات الضخمة. بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني الوطني عبر الانتقال إلى خوارزميات ما بعد الكم، التي تضمن حماية البنى التحتية الرقمية والبيانات الحساسة لعقود طويلة (Mosca, 2018).
إنّ تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية عُمان 2040 يتطلب تعزيز الاستثمارات في الابتكار والتقنيات المتقدمة. وبالتالي، فإن دخول سلطنة عُمان المبكر إلى فضاء الحوسبة الكَمِّيّة سيُسهم في خلق ميزة تنافسية إقليمية، وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مُضافة، خاصة إذا تم ربطها بقطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة الخدمات اللوجستية والقطاع الصحي.
لقد بلغت المعالجات التقليدية حدودها الطبيعية ضمن مسارها الكلاسيكي، وأصبح من الواضح أن المستقبل ينتمي إلى الحوسبة الكَمِّيّة التي لا تمثل مجرد تحديث تقني، بل ثورة معرفية قادرة على إعادة صياغة الاقتصاد والصناعة والأمن التقني. وبينما تستثمر الدول الكبرى بقوة في هذا المجال، فإن الفرصة سانحة أمام سلطنة عُمان لتبني مسار استراتيجي يستند إلى رؤية عُمان 2040، ويؤسس لبنية أساسية معرفية تواكب تحولات الاقتصاد العالمي. إن الاستثمار في الحوسبة الكَمِّيّة ليس ترفًا، بل خيارًا استراتيجيًا سيحدد موقع الدول في خريطة المستقبل.
** باحث في المعرفة