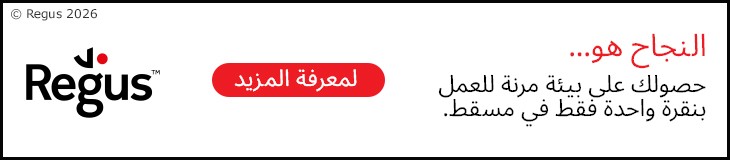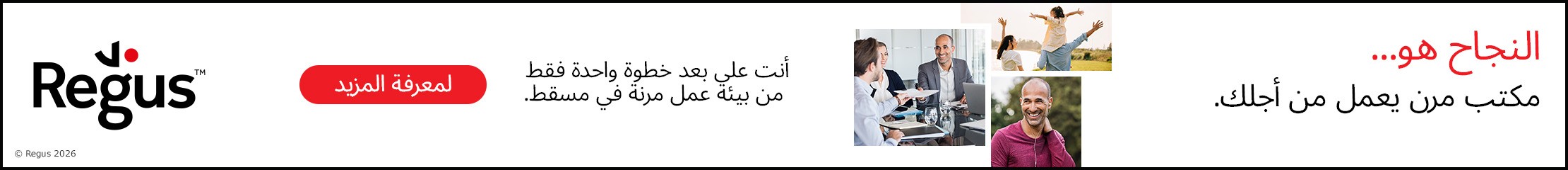أ. د. حيدر أحمد اللواتي **
تحدثنا في مقالنا السابق عن واحدة من أشهر دراسات جامعة هارفارد حول دورة الحياة، التي بدأت عام 1938، والمعروفة أيضًا بـ"دراسة هارفارد الطويلة الأمد عن النمو البشري"، وأهمية هذا النوع من الدراسات، وفي هذه المقالة سنعرض بعض الإحصائيات المهمة، ولكن يجب التأكيد بأن هذه السلسلة من المقالات لا تهدف إلى تغطية جميع جوانب الدراسة، وإنما تشير إلى بعضها.
فقد توصَّل الباحثون في هذه الدراسة إلى عدد من الملاحظات القائمة على ضوابط واضحة قابلة للقياس، وسأذكر بعضًا ممَّا ذُكِر في كتبهم المختلفة؛ إذ أشاروا إلى أنه لا علاقة بين مستوى دخل الفرد وبين مستوى الذكاء الذي يتم تحديده باستخدام "IQ Test"؛ حيث إن مستوى ذكاء الأفراد الذين يتراوح بين 110 إلى 115 ومستوى ذكاء الأفراد الذين يفوق 150 لا يختلف ولا يُعد عاملًا مُهمًا في التنبؤ بمستوى دخل الفرد، بينما لوحظ أن الأفراد الذين لديهم علاقة أخوية قوية في صغرهم كان دخلهم السنوي يزيد بأكثر من 51000 دولار (كمعدل، عام 2009)، مقارنة بالإخوة الذين لا يملكون هذه العلاقة الأخوية القوية، أو من لم يكن لديهم إخوة.
كما إن الرجال الذين ينشأون في أسر مُتماسِكة ومُحِبة فإن دخلهم يزيد بالمعدل بـ66000 دولار سنويًا، مقارنة بالرجال الذين نشأوا في أُسر مُفكَّكة ولا تربطهم علاقات أسرية قوية. ومن الملاحظات الفارقة واللافتة للنظر، أن بعض الرجال الخاضعين للدراسة استطاعوا بعد الحرب العالمية الثانية أن يرتقوا إلى رتب عسكرية عُليا؛ فحصلوا على رتبة (رائد)، بينما آخرون ظلوا جنودًا. فما الذي أحدث هذا الفارق؟
تبيَّن أن الرتبة العسكرية التي حصل عليها هؤلاء لم تكن نتيجة لبنيتهم العضلية، أو الطبقة الاجتماعية، أو ذكائهم أو قدرتهم على التحمل، إنما العامل الحاسم كان الأُسر المتماسكة والعلاقات الاجتماعية الدافئة التي تربوا ونشأوا فيها، فمن هؤلاء حصل 24 (من أصل 27) على رتبة ملازم أول على أقل تقدير، وأربعة حصلوا على رتبة رائد، بالمقابل من ثلاثين رجلًا تربوا في أسر افتقدت إلى دفء العواطف وعاشوا طفولة سيئة، لم يصل أحد منهم إلى رتبة رائد، ولم يصل ثلاثة عشر منهم إلى رتبة ملازم أول.
ومن الدراسات المهمة التي أشارت إليها الدراسة أثر الأبوة والأمومة على الفرد؛ إذ لاحظت الدراسة -مثلًا- أن القدرة على الاستمتاع بالإجازات والقدرة على اللعب، ترتبط بالعلاقة الجيدة مع الأب، كما إن علاقة الابن بأبيه لها أثر أكبر ومهم في علاقته الزوجية، وأن الرجال الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع آبائهم يكونون أقل قلقًا في مراحل الدراسات الجامعية، ويتعرضون لضغوط نفسية أقل وبشكل ملحوظ. بينما لوحظ أن الرجال الذين كانت علاقاتهم سيئة بآبائهم كانوا أكثر ميلًا لوصف أنفسهم بأنهم متشائمون، ويجدون صعوبة في التقارب مع الآخرين، كما إن الرجال الذين لديهم علاقة جيدة مع آبائهم كانوا يشعرون برضا ذاتي ملحوظ بعد سن الخامسة والسبعين.
إنَّ هذه الإحصائيات تُشير إلى أمور مهمة، ربما علينا إعادة النظر في أولوياتنا، فذلك الأب الذي يقضي ليله ونهاره سعيًا وراء توفير حياة مادية مُرفَّهة لأولاده أو لتوفير أرقى المدارس التعليمية، وبالمقابل يغيب عن المنزل لفترات طويلة، ولا يوطِّد علاقته مع أبنائه، ظنًّا منه بأنه يبذل جهده في توفير تعليم راقٍ لأبنائه أو توفير حياة مرفهة لهم، فهو مُخطئ تمامًا في حساباته، فيكفي أن يوفر تعليمًا مناسبًا لهم، ويكفي أن يوفر حياة كريمة لهم ويقضي وقته في التفاعل واللعب معهم؛ فذلك أهم بكثير وأجدى في تنشئتهم وتربيتهم.
أمَّا الأُم فكان أثرها بالغًا، وبصورة واضحة كما تشير الدراسة إلى ذلك؛ فلقد لاحظت الدراسة أن القدرة على العمل والإنجاز مع تقدم العمر مرتبطة وبصورة واضحة بعلاقة الرجل بأمه، فكلما كانت علاقته مع أمه جيدة زادت قدرته على العمل والإنجاز. بل والغريب في الأمر أن ارتفاع دخل الرجل كان مرتبطًا وبشكل وثيق بالعلاقة الجيدة مع أمه؛ فالأم الحنون التي تُغدق حنانها على أطفالها تُؤثِّر وبصورة واضحة على دخل الرجال، إذ لوحظ أن تلك الفئة من الرجال يزيد دخلها بمعدل 87,000 دولار سنويًا، مقارنة مع الرجال الذين كانت أمهاتهم تهملهم ولا تُظهر اهتمامها بهم!
ومن الملاحظات المدهشة والتي لم يستطع الباحثون تفسيرها، أن الخرف أو التدهور العقلي في سن الثمانين وما بعده ارتبط ارتباطًا وثيقًا بعلاقة الرجل بأُمه في صغره؛ إذ لوحظ أن 33% ممن لم يحظوا بأُمهات تهتم بهم وتُغدق عليهم حنانها، أُصيبوا بالخرف في سن التسعين، بينما لم تتجاوز نسبة الإصابة بالخرف 5% لدى الرجال الذين حظوا بأُم مهتمة وتُغدق عليهم حنانها. فيما لم يعثر الباحثون على أن العلاقة مع الأب لها أثر مُشابه.
هذه الإحصائيات تؤكد أن وجود الأم الحنون في حياة الطفل له أثر بالغ في ثقته بنفسه وبمجتمعه، ولذا فإن الأُم العاملة عليها أن تُدرك أن وظيفتها الأولى هي تربية أبنائها، وإذا ما أدَّت هذا الدور على أكمل وجه، يُمكنها القيام بأعمالها الأخرى، أمَّا إذا لاحظت أن عملها يؤثر وبصورة ولو بسيطة نسبيًا على اهتمامها بأطفالها، فلا بُد من تقديم الأولويات؛ فالملاحَظ أن الدراسة لم تُشِر إلى إمكانية تعويض دور الأم بالأب مثلًا، بينما أشارت بصورة خاصة إلى أهمية حنان الأم، ولربما يُشير ذلك إلى حكمة المُشرِّع الإسلامي عندما قام بتوزيع أدوار المسؤوليات الأسرية، التي خصَّت الأب بالجانب الاقتصادي وركَّزت على الجانب التربوي للأم؛ فهذا التقسيم الذي طالما اتُّهم به الإسلام بأنه يقف في وجه طموح المرأة، باتت تُرجِّحه اليوم بعض الدراسات الأكاديمية.
من المهم التأكيد على أن الدراسة ركَّزت كثيرًا على أن علاقة الرجل بأسرته وبأبيه وأُمه، لا تتأثر بموقف أو موقفين، أو بظروف طارئة؛ بل بمجمل العلاقة الأُسرية والجو العام الذي يسود الأُسرة، ولهذا فلا يَظُن الأب أو الأُم أن الإجازة الصيفية أو التنزُّه على شاطئ البحر في فترات مُتباعدة سيُعوِّض الأبناء أو يُنسيهم إهمال الأبوين لهما.
ومن الأمور اللافتة التي لاحظتها الدراسة وأشار إليها الباحثون، أن الطفولة التعيسة التي قد يتعرَّض لها البعض، يُمكن في بعض الأحيان التخفيف من أثرها بشكل ملحوظ، إذا استطاع الرجل أن يُكوِّن علاقات صداقة حقيقية، أو علاقات زواج ناجحة.
وللحديث بقية...
** كلية العلوم، جامعة السلطان قابوس