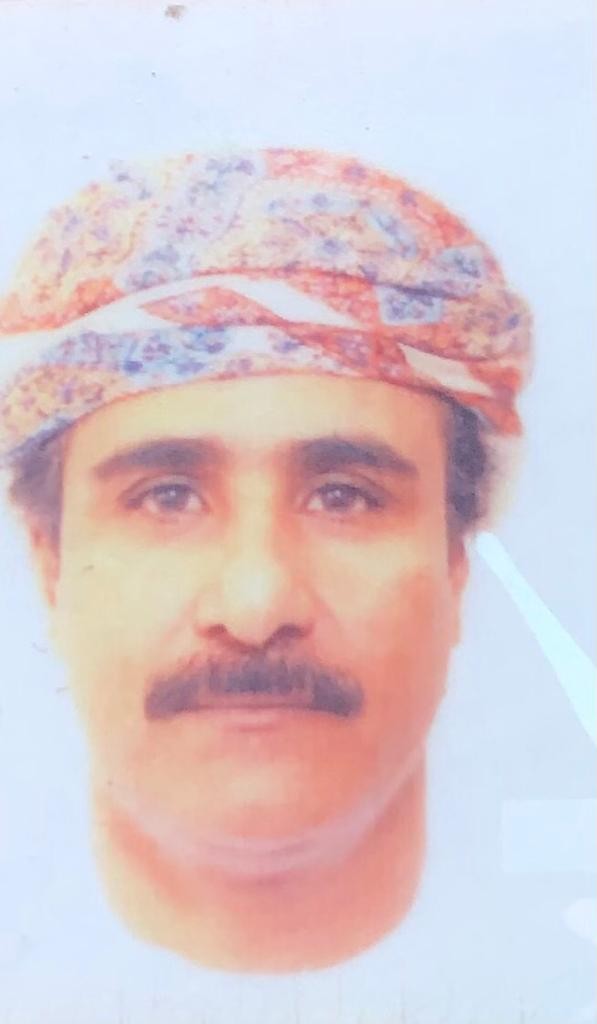مسعود أحمد بيت سعيد
السودان حكاية عجيبة وفريدة ومتنوعة وأحيانا مُعقدة. تتمظهر أزمته بمظاهر مُتعددة قد لا تبدو مفهومة أو مُبررة، وهو بالطبع ككل البلدان العربية التي يعتبر التأثير الخارجي على بساطته أكثر فعل وحضور من التأثير الداخلي، وتنازعه تعدد الهويات التي لم تمكنه بعد من حسم انتمائه وشكل نظامه السياسي، رغم تجذرها في الواقع لم تتمكن من اشتقاق صيغ التعايش الاجتماعي التي تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية دولة القانون والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات كنواظم عامة.
والبحث عن خيارات من خارج تربة الواقع الاجتماعي والتسليم بأبدية صراع الهويات كانت نتائجه كارثية. لقد لفحه مؤخرًا نسمات الربيع العربي الساخن فأضاف وهجًا على حرارة الصحراء. قدَّم حراكا نموذجيا حضاريا راقيا ومتقدماً وخرج بأقل الأضرار قياساً بالآخرين، وإن كان لم يحصد إلى الآن، سوى التطبيع القسري مع الكيان الصهيوني. لقد اتسم حراكه الشعبي بنضج معقول ساهمت فيه قطاعات واسعة من كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وكان للمرأة السودانية البطلة دوراً رياديًا وطليعياً مميزاً. وفي فجر 11 أبريل أعلن المجلس العسكري عزل البشير واعتقاله. وفي أغسطس وُقعت الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"؛ حيث تقاسما السلطة لفترة انتقالية لمدة 51 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات في مطلع 2024.
نتائج الانتفاضة الشعبية أنعشت الرغبات الدفينة لمُعظم المكونات الاجتماعية والسياسية في تنشيط دورها وتحالفاتها الإقليمية والدولية بعيداً عن منطلقات انتفاضته الشعبية وتطلعاته نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. امتنع الحزب الشيوعي عن المُشاركة في الحكومة الانتقالية وهو المعروف بعُمق تحليله السياسي وقراءته الدقيقة للواقع واستشفاف آفاقه وأبعاده التاريخية. اتهمهما بالانصياع لمؤسسات التمويل الدولي ووأد الثورة الشعبية، وقد طور لاحقاً مواقفه بشكل جذري للعمل على إسقاط حكومة الفترة الانتقالية رافضًا لعب دور الوزير الأحمر في حكومة رجعية مهمتها إجهاض مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، وقد تأكدت صحة تقديراته وصوابيه تحليله؛ ففي 25 أكتوبر الماضي انقلب المجلس العسكري على شركائه وحلَّ الحكومة وأعلن حالة الطوارئ. وبتاريخ 21 نوفمبر 2021، وُقعت اتفاقية بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان والدكتور عبدالله آدم حمدوك رئيس الوزراء، تضمنت بنودًا عدة؛ منها عودة الأخير لمُمارسة مهامه، لكن هذه المرة دون غطاء شعبي وطني ومن خلف الشريك الأساسي "قوى الحرية والتغيير"، الأمر الذي يُبقي الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات.
واليوم يلوح في الأفق إمكانية للقوى التقدمية السودانية للعب دور كبير ومؤثر في مجريات الأحداث بشكل حقيقي، مع التأكيد على أنَّ الاستقرار في إقليم لم تحسم خياراته السياسية والاستراتيجية أمر محفوف بالمخاطر. لقد أسقط الحراك الشعبي سلطة الفرد دون أن يسقط سلطة الطبقة ككل الذي جرى في الأقطار العربية الأخرى. لم تكن الانتفاضات الشعبية العربية من صنع القوى والأحزاب ذات البرنامج السياسي والاجتماعي البديل. وكانت القوى الطبقية المُسيطرة ذكية رغم نعتها خمسين عاماً بالغباء، تتقن التمثيل على مسرح الجماهير بمهارة فائقة. وسيبقى الفرد مهما ضُخِّم دوره مُجرد تجسيد لسلطة الطبقة أو الطبقات وممثلها الرسمي والمُعبر الشعبي عن سيطرتها الطبقية في أفضل الأحوال، وليس أدل على ذلك من غياب الأفراد وبقاء السياسات والنهج الاقتصادي والاجتماعي.
أعتقد أن الأمور واضحة ولا حاجة للبرهان. إنَّ الهوية العربية هي بلاشك بيضة القبان، ويرجع سبب معظم الاختلالات في الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى غياب دور المكون القومي التقدمي الذي يحفظ التوازن الاجتماعي والنفسي في بلد متعدد الأعراق والأجناس والذي دونه لا يعرف السودان أو غيره من البلدان العربية الاستقلال والاستقرار والازدهار.
وليس بخاف على أحد أنَّ الممارسات الخاطئة أوحت للبعض بعدم الحاجة للهوية العربية التي يمكن استبدالها بأية مرجعية أخرى. هل ذلك ممكن؟ أظن أنَّ مثل هذه الاستنتاجات المتسرعة لا تقود سواء للانتحار والموت البطيء.
إنَّ العودة للمرتكزات والثوابت تبقى أسلم ألف مرة من التيه في عوالم الفضاءات رغم سعتها ومغرياتها. فلا بأس من إطالة النظر.. والأجمل أن تقف على الأرض الأصلب.. بعيدًا عن حواف الجبال الشاهقة رغم متعة الوهلة الأولى.