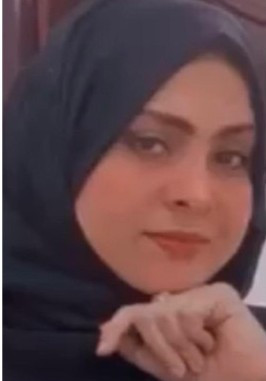سعيدة البرعمية
صديقتي..
يا لها من مسالك!
الطرق على اختلاف مساراتها ومُفترقات غاياتها، بعثرت الأرواح بين التقاطع والتباين؛ فأوصلتها للشيخوخة، شاخت الأرواح حقاً ومزَّقها المشيخ إرباً؛ أضناها البحث عن المجهول والمفقود معًا، فوهنت وتكاتل الإعياء عليها، كمن يلهث في الصحراء خلف السراب أو كحبوب القمح تسحقها الرحى بلا هوادة.
رأيت أمي وأنا صغيرة تفتح خزانتها وتأخذ شريط الكاسيت وتضعه في المُسجل الصوتي وتستمع إليه، الغريب أنّ الأصوات التي تصدر منه ليست أصواتا موسيقية ولا صوت الراحل محاد الفهد- رحمه الله- الذي اعتادت الاستماع إليه. أنصتُّ لتلك الأصوات؛ فإذا بها أصوات رجال ونساء، يلقون التحية ويخبرون عن أحوالهم، ويُطالبون من سيستمع إليهم أن يُبادلهم تسجيلا آخر بنفس الطريقة، يخبر فيه عن حاله وحال الأهل والوطن، وكيف هي الحبيبة ظفار؟
كانت الدموع تنزل من عينيها، أخبرتني دموعها عن شيخوخة روحها، وكيف أنّ روحها أصبحت رثَّة، ما زلت أتذكر لون الكاسيت الذي دلنّي على أنَّ الأرواح تشيخ، فتذوي وتنكسف وتقتحمها التجاعيد بتعرجات مخيفة ومقلقة. لما كبرت تذكرتُ تلك الكلمات التي استعمرت أذني الصغيرة، أدركت أن أهلي كانوا في اليمن بعيدين عن أهلهم هُنا وتلك وسيلة التواصل قديماً بين من هم في ظفار وخارجها، يُسجّل الشريط ويُرسل مع أحد المسافرين ويصل بعد مدة، حسب رحلة السفر تلك.
أذكرُ أنني منذ سنتين أو أكثر، سألت أمّي عن ذلك الكاسيت، فانكمشت تجاعيد وجهها واصطدمت بتجاعيد روحها، قالت: كسرته، ثم صمتت. شعرتُ أنها تسترجع بصمتها كلماته، كلمة كلمة، فيبدو أنني بثرثرتي قد نكأتُ جراحها.
إنِّها رسائل الأحزان، تنقل وتجلب الحزن، شرايين متصلبة تعيق تدفق الحياة، فتشيخ بسببها الأرواح.
أمّا عن سؤالك، إذا كنت غريبة الأطوار أم لا؟ فأنا أعتقد أنك لست غريبة الأطوار، إنما أنت تجيدين اللّعب مع ما يدعى "حياة".
هناك أرواح حقًا، قد سلب توهج القناديل أرواحها، وبقدر ما أسعدها سرعة اشتعالها، صدمها سرعة انطفائها؛ بل وآلمها، وبقيت تجاعيدها تتسطر وتتتعرج وتلتهم ما بقي من رميم أرواحها، فهي قد سلكت أقصر الطرق لإشعال القناديل، فاستمرار اشتعالها أو اختفائها هو حسب المسلك الذي اختير لإشعالها.
كنتُ طفلة يعتبرني أهلي، لا أجيدُ سوى اللّعب والعبث والثرثرة؛ لأنَّ كلّ إخوتي يجتهدون في الأعمال التي توكل إليهم ويتفانون في اتقانها، وأنا لا أبالِ، وإن عملتُ عملًا بعد الكثير من الكلام، فإنني لا أجيده، وأسمع الجميع يتذمر من حولي، كان أبي - رحمه الله – يوجه لي سؤالا باستمرار: "تَعْمَرْ حَتْخِرِجْ بَعَشْ الْنِفْعَشْ نَفَعْ؟!" أيّ بمعنى، هل يا ترى ستموتين دون أن تنجزي شيئًا في حياتك؟
لم أعط السؤال مساحة من التفكير، ولم يؤثر فيني؛ بل كنت أعود للّعب الذي أغلبه خيال وثرثرة، كبرتُ وما زلت لا أختلف كثيرا عمّا كنت عليه في صغري، فما زلت لا أحظى برضا بعض من حولي، ولا رضا ما يدعى "حياة "، لكني لم أسمح لها أن تعبث بروحي، فأنا مازلت أُقدّس الخيال والحلم معا والثرثرة، وظلّ هناك من يوجه لي الأسئلة بدل السؤال، وفق تطورات الحياة والمراحل العمرية.
سألت ما السرّ في تعظيم روحي لـ"مرباط"؟
فعندما أجلس على شاطئ مرباط، أشعر كأن البحر يمتد بموجه إلىّ، مستبشرا بقدومي، فأدنو منه؛ فتتجرد روحي من جسدي وتقفز على موجه، فينأى بها إلى أعماقه، يهمس لها: "لا بأس امسحيها في هيبتي"، تشكو إليه فيمسح عليها، ويعيد ترميمها.
يُخيلُ لي وأنا واقفة بثبات على الشاطئ، منتظرة عودة روحي من رحلتها مع الأمواج، أنّ سمحان الشامخ خلفي يقترب مني؛ فأتكئ عليه؛ فهناك يتسع أفقي وينشط الخيال عندي، لاسيما عندما يكون الشهر في انتصافه، يغشاني الكمال بالرغم من حجم النقصان الذي يعتريني.
صديقتي..
لقد حلم أفلاطون بمدينته الفاضلة، وفق معايير الكمال، وعجز أن يُحقق وجودها على الواقع، وعجز من آمن بلفسفته أن يضع حجر الأساس لمعالم المدينة الأفلاطونية، لكنّي عندما أقف على شاطئ مرباط أستشعر الكمال الأفلاطوني يغمر روحي، فزاوية الجمال هناك منفرجة شفافة تتسرب إليَّ وأذوب فيها، مهما بلغ قبحي وسوء خصالي، فإِنْ تعذّر وجود المدينة الفاضلة على أرض الواقع، فلم يتعذّر وجود مرسى لروحي في مرباط.