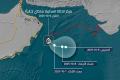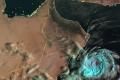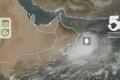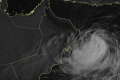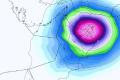جمال القيسي
نعترف أننا تحسَّرنا، ذات مرحلة قريبة، مع المتحسرين على غياب التواصل الحقيقي بين الأصدقاء وأبناء الأسرة الواحدة، على زعم من القول، إن ذلك نتج بسبب انشغال الجميع بالهواتف الذكية، ومواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، وما يتعلق بها عمومًا، وكنّا متناسين، أنّ من أهم ما في هذه المواقع وما يوازيها من برامج، يوفر تواصلا، يكاد يكون متكاملا، وذلك عبر النص والصورة والفيديو. والحقيقة أنّ الزعم بغياب التواصل، يرافقه زعم آخر، إذ، في ما أرى، أنّه ليس هناك غياب أو انقطاع، وليس دقيقا كيل التهم للوسائل والمخترعات بفائض قول من التشبث برتيب الأيام وغائبها، وروتينها الذي فرض إيقاعه على أجيال الكهول.
وهذا، أو ذاك "التحسر"، على غياب التواصل، لو دققنا في دوافعه، وما وراء أكمته، لوجدنا أنّه ليس سوى حالة "تحسر رومانسية" لا أكثر، وأن التواصل الذي نندبه، لم يمت، ولا يحتضر، وما به من علة أو سوء، ولا حتى هناك أعراض هزال تظهر عليه، بل إنه التواصل نفسه، ولكنه تحول إلى شكل آخر، بحكم ما يفرضه العصر، (بل ما يمنحه) العصر وتطوراته الجامحة، نحو مزيد من السهولة في إيصال كل شيء، بما في ذلك "إيصال التواصل"!.
ولعلنا نكتشف، أكثر، حين نراجع أنفسنا، أن هذا الندب على فقدان الحميمية بين المقربين، ليس سوى عدم اعتراف بالواقع الذي يقول إنّ التواصل قائم وحقيقي، وأنه ربما أشد من "التواصل التقليدي". وحين نُراجع ما يجري معنا يوميًا، نتأكد أننا على تواصل أكثر حميمية أدفأ مع من نحب، حيث صار يتم هذا عبر طرق عديدة متعددة، من الأدوات السريعة الخاطفة المُعبرة وبطريقة أسهل وفي وقت غير مرتبط بأية عوامل أو مساعدة خارجية، مادية؛ مثل ساعي البريد أو الهاتف الأسود...إلخ.
التواصل حقيقي، بل إنّ تحية الصباح والمساء، صارت تصلك مع وردة أو ابتسامة أو أغنية، و"لمزيد من التواصل" لا ينقطع خيط التواصل! أنك حتى في أكثر ساعات العمل ازدحامًا، قد تصلك الطرائف، والمقاطع المضحكة، فتسليك خلال وقت قصير قد لا يتجاوز الثواني. ولم يكن هذا يقع قبل هذه المرحلة بغير اتصالات، أو مواعيد مرتبة بعناية للقاءات وسهر وسمر وهرج ومرج، وممارسة خفة ظل نتوخاها من بعض الندماء، وربما تكون خفة ظل وهمية لكننا ابتدعناها بسبب شح الإبداع! هذا الإبداع الذي صار متوافرا عبر التواصل الحديث، لأسباب عديدة، أقلها كثرة المجربين، والحشاشين والمدلين بدلائهم في آبار النكتة والمفارقات و. .و. .إلخ.
وحين كنّا نلطم مع "اللطلامات"، على غياب الأيام الحلوة و"الزمن الجميل" الذي كان يجمع الأسرة على مسلسل السهرة، وزيارات الأقارب؛ فإننا كنّا نلجأ إلى ذلك فقط بحكم فقدان العمر وتفلته من أصابعنا تفلت الماء. كل ذلك اللطم إنما هو حنيننا إلى أنفسنا، ليس أكثر، وهو كثير بالطبع. (واستهلكتْ كثيرًا عبارة الزمن الجميل. أليس كذلك؟!!)
وبعبارة أبسط، فقد تحسر آباؤنا، وأقاموا الأحزان، وزفروا قائلين: "اييييه يا زمن.. والله آخر زمن"! ولعنوا وسائل الثورة التكنولوجية التي أتاحت التلفزيون للجميع، فأبعد أهل البيت عن بعضهم، وقضى على أحاديث ليالي الشتاء، وقصص الغولة والضبع والسبع والأشطر بين الفتية حسن!، ولكن هناك لدى "المعتدلين" من الآباء، قد تجد الحسرة تتوقف عند زمن معتدل، وبدوام استذكار واسترجاع زمن تجمع الجيران لمشاهدة التلفزيون في فناء بيت أبو بشير، مثلاً.
مضحك هذا الحنين، سيكون مضحكًا أكثر، حين نتخيل أبناءنا وهم يتحسرون على زمن كان النّاس فيه على تواصل دائم، فلا يمر عيد ميلاد دون رسائل تهنئة على الواتس أب وانبوكس الفيسبوك، وتليغرام وانستغرام وكيلوغرام، وما أجملهم وهم يلوون شفاههم ندمًا على طي الزمان لأيام مجموعات الواتس التي كانت أسرة حقيقية، ينبعث الدفء من حروفها وصورها وفيديوهاتها. ما أخف دمهم وهم يفتقدون زمن البساطة. "الزمن الجميل"!