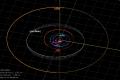د. ذياب بن سالم العبري
هناك أشياء لا تُقاس بالمال، لكنها تُرمّم الأرواح كما يرمّم المطر وجه الأرض. من بينها: السلام حين يُقال بصدق، والابتسامة حين تُمنح بلا تكلّف. وحين نلتقي بمن يمرّ أمامنا فلا يسلّم، أو يشيح بوجهه كأنَّ بينه وبين الناس جدارٌ غير مرئي؛ يخرج من الذاكرة العُمانية ذلك العتب الشعبي الرقيق: «لاقاني ولا تغدّاني».
عبارة قصيرة، لكنها تحمل فلسفة مجتمعٍ بأكمله: لا أريد منك شيئًا… فقط قابلني بوجهٍ إنساني.
هذه المقولة ليست دعوة للمُداهنة، ولا مطالبة بعلاقات مصلحية، بل هي تذكيرٌ بأنَّ حُسن اللقاء قيمةٌ مستقلة بذاتها. العُماني، بطبعه الاجتماعي، يعتقد أن التَّحية ليست "إجراءً شكليًا"، وإنما عهدٌ صغير يوقّعه الناس كل يوم: نحن بخير… ونحن معًا.
ولأن الحياة تتسارع، قد تتراجع هذه العادة الجميلة أمام زحمة الانشغال، فتضعف البشاشة ويقلّ السلام، ويصبح الصمت هو اللغة الافتراضية. هنا تبدأ الخسارة الحقيقية: لا نخسر كلمةً فقط، بل نخسر دفءَ العلاقة، ونفتح بابًا للجفاء وسوء الظن، وربما "القطيعة الباردة" التي لا تُعلن نفسها لكنها تزداد يومًا بعد يوم.
لقد جاء الدين ليُثبّت هذا المعنى في الوجدان؛ فالكلمة الطيبة صدقة، والوجه الطلق معروف. وفي الحديث الشريف: «لا تحقرنّ من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق». فالبشاشة ليست أمرًا ثانويًا، بل سلوكٌ يرفع صاحبه ويُسعد من حوله. وعلى الطرف الآخر، يذكّرنا القرآن بأن التكبر لا يصنع مقامًا: «ولا تمشِ في الأرض مرحًا…»؛ لأنَّ من يبتعد عن الناس بوجهٍ متعالٍ لا يعلو في الحقيقة، بل ينعزل.
واللافت أن ما استقرّ في ثقافتنا وديننا تؤكده اليوم لغة العلوم الإنسانية: الابتسامة تُخفّف التوتر، وتزيد القبول المتبادل، وتفتح باب التعاون. هي "إشارة أمان" صغيرة، لكنها تسبق كل حوار ناجح. حتى في بيئات العمل، حيث تُقاس النتائج بالأرقام، يظل المناخ النفسي هو الحاضنة الأولى للإنتاج؛ ومناخُه يبدأ غالبًا بتفصيلٍ بسيط: تحية محترمة، وابتسامة صادقة.
ولذلك لا نتحدث هنا عن مثالية، بل عن مهارة اجتماعية وطنية تحفظ تماسك المجتمع. نحن بحاجة إلى أن نُعيد الاعتبار لقاعدة سهلة وعميقة في آنٍ واحد:
أن نُلقي التحية على من نعرف ومن لا نعرف، وأن نُبادر بالسلام لا انتظارًا لردّ، بل احترامًا لفكرة الإنسان في داخل الإنسان.
وتبدأ القصة من البيت. الطفل لا يتعلم البشاشة من النصائح، بل من المشهد اليومي:
أبٌ يسلّم وهو يدخل، وأمٌ تبادر بالتحية وتُحسن استقبال الجيران والضيوف، وكبارٌ يجعلون السلام عادةً لا تتبدّل بتبدّل المزاج. وحين يرى النشء الكبار يمرّون على الناس بوجهٍ طلق، يتعلمون دون شرحٍ طويل أن الكرامة لا تتعارض مع اللطف، وأن الوقار لا يُبنى بالعبوس.
ثم تمتد هذه التربية لتصنع الفرق في الشارع، وفي العمل، وفي المجمعات التجارية، وأينما وجدنا:
سلامٌ يسبق السؤال، وابتسامةٌ تكسر حدة اليوم، ووجهٌ بشوش يفتح أبواب الحديث بدل أن يغلقها. هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع “مجتمعًا مترابطًا” لا يعيش على المجاملات، بل على الاحترام المتبادل.
إن عبارة «لاقاني ولا تغدّاني» تذكّرنا بأن الناس لا تبحث دائمًا عن المنفعة، بل عن الاعتراف: أن تُرى، أن تُحترم، أن تُقابل بوجهٍ إنساني. وهي رسالة هادئة تقول: دعنا نعيد للقاء قيمته، وللسلام مكانته، وللبشاشة جمالها؛ فبها تُصلح ذات البين، وتخفّ المشاحنات، ويهدأ الصخب الداخلي الذي لا نراه في العيون إلا حين تبتسم.
في زمنٍ يعلو فيه الضجيج وتكثر فيه أسباب الانشغال، قد تكون أعظم "مبادرة مجتمعية" نبدأ بها من أنفسنا هي: أن نُحسن اللقاء.
فهل نُعيد هذه السنة الجميلة إلى حياتنا اليومية… ونترك للنشء درسًا حيًّا يرونه بأعينهم قبل أن يسمعوه بآذانهم؟