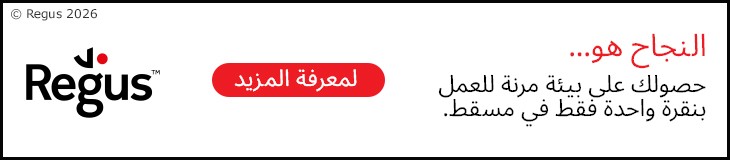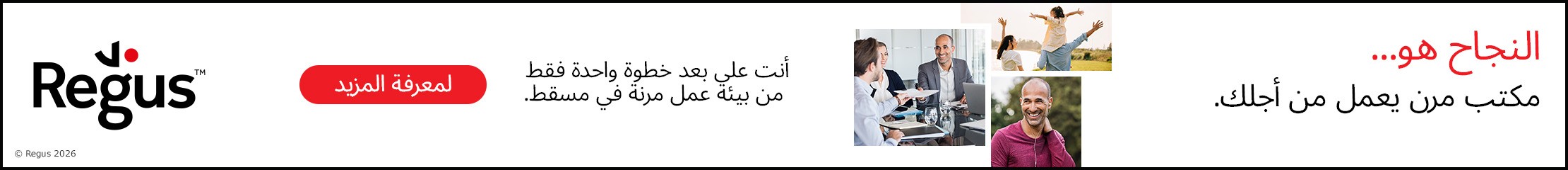جان يعقوب جبور
هذا المقال يتطرق إلى ترابط وتكامل الدستور اللبناني مع المقاومة الوطنية لأي اعتداء أو احتلال للبنان ومن أي عدو كان. ومبدأ المقاومة بالدستور اللبناني لا يشمل "المقاومة" التي مارستها بعض الميليشيات أبان الحرب الأهلية في لبنان.
أولًا: الإطار الدستوري العام
ينصّ الدستور اللبناني في مقدمته (الفقرة ب) على أن "لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان." كما تنصّ الفقرة (ج) على أن "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد." أما الفقرة (هـ) فتؤكد أن "الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن." من هذه الفقرة الأخيرة تحديدًا، استمدّت فكرة المقاومة جزءًا من شرعيتها الدستورية، إذ اعتُبر الدفاع عن الأرض اللبنانية ضد الاحتلال واجبًا وطنيًا، لا يتعارض مع الدستور، بل ينسجم مع مبدأ السيادة الوطنية ورفض الاحتلال الأجنبي.
ثانيًا: المقاومة كحالة وطنية قبل أن تكون تنظيمية
بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، ظهرت المقاومة اللبنانية كحركة وطنية جامعة تضمّ أطيافًا متعددة، ثمّ تطوّرت لتأخذ شكلًا منظّمًا بقيادة حزب الله. وفي هذا الإطار، لم يكن الدستور قد نصّ صراحةً على وجود “مقاومة مسلّحة” موازية للجيش، لكنّ الشرعية الوطنية والشعبية التي اكتسبتها من خلال تحرير الجنوب عام 2000، جعلتها جزءًا من الوجدان الوطني والسياسي، وليس مجرد تنظيم عسكري.
ثالثًا: وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) والموقف من المقاومة
اتفاق الطائف (1989)، الذي أُدرج في الدستور، نصّ في أحد بنوده على “حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية”، لكنه استثنى عمليًا القوى التي كانت تقاوم الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي. وقد فُسِّر هذا الاستثناء على أنه اعتراف ضمني بشرعية المقاومة طالما أن الاحتلال مستمر. وهكذا، أصبحت المقاومة شرعية استثنائية مؤقتة نابعة من استمرار العدوان، إلى أن يتولّى الجيش اللبناني وحده مسؤولية الدفاع.
رابعًا: الشرعية المزدوجة (الدستورية والميثاقية)
من منظور دستوري صارم، احتكار الدولة للسلاح هو قاعدة أساسية في أي نظام سيادي. لكن في لبنان، تتداخل الشرعية الدستورية مع الشرعية الميثاقية والسياسية التي أفرزها التوافق الوطني بعد الحرب. فالمقاومة، في نظر مؤيديها، تُكمل دور الدولة في الدفاع عن السيادة، بينما في نظر معارضيها تُشكّل تجاوزًا لاحتكار الدولة للقوة المسلحة. هذا التناقض لا يُحسم قانونيًا إلا عبر حوار وطني جامع يوازن بين مقتضيات الدفاع والسيادة ومبدأ وحدة الدولة.
خامسًا: البُعد الدولي والدستوري
التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 1701 (الصادر عام 2006)، يجعل العلاقة بين المقاومة والدولة خاضعة أيضًا للشرعية الدولية. فالدستور اللبناني، في مقدمته (الفقرة ب)، يربط لبنان بمواثيق الأمم المتحدة، ما يعني أن الدولة مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن كل ما يمسّ السلم والأمن. ومع ذلك، لا ينصّ الدستور على تجريم المقاومة، ما دام عملها في إطار الدفاع الوطني وليس الاعتداء الخارجي.
لذلك، يمكن القول إنّ علاقة المقاومة اللبنانية بالدستور اللبناني هي علاقة مرنة ومتعددة الأبعاد. فهي تستند من جهة إلى الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور التي تعتبر الدفاع عن الوطن واجبًا مقدسًا، ومن جهة أخرى تواجه تحدّي الانسجام مع مبدأ احتكار الدولة للسلاح والشرعية الدستورية. وبين هذين الحدّين، تبقى المقاومة حالة وطنية مشروطة بظروف الاحتلال والتهديد، على أن تتحوّل مستقبلًا إلى جزء من المنظومة الدفاعية الرسمية حين تكتمل سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وفي الختام، فإن الانقسام العامودي في لبنان ما زال مستمرًا مما يجعل من الدستور اللبناني والمقاومة في أضعف حالتهما حيث يُفسر الدستور من خلال أعراف مضمونها طوائف وأحزاب بأغلبيتها مرتبطة بمحاور خارجية وبتحليلات ميثاقية لا تحاكي الواقع الوطني. ففي الوقت الحالي يجلس أحزاب السلطة على طاولة واحدة من دون قرار حيث تجرهم العاطفة الجياشة الشعبوية بعيدة عن منطق العقل في الدفاع عن وطنهم وذلك لأغراض يعرفها كل لبناني شريف، وفيّ ووطني ألا وهي الاستسلام للخارج، ضرب الدستور وعلاقته بالمقاومة لأي احتلال لأرضه وموارده. إن الحرب الإقليمية الأخيرة قد كشفت أوراق ونيات الجميع محليًا وإقليميًا ودوليًا من خلال التواطؤ والخنوع والاستسلام للإبادة والتهجير والتطرف والتفتيت والتصفيق لسلام هزيل لا يخدم إلا مصلحة الأعداء.
فعليكم في لبنان التصرف حسب ما يقتضيه الحس الوطني والمواطنة ليكون الهدف جامعًا لكل مكونات الشعب اللبناني الحبيب بوجه أي اعتداء.