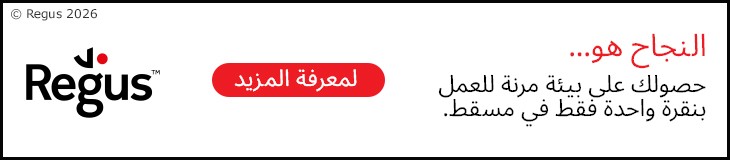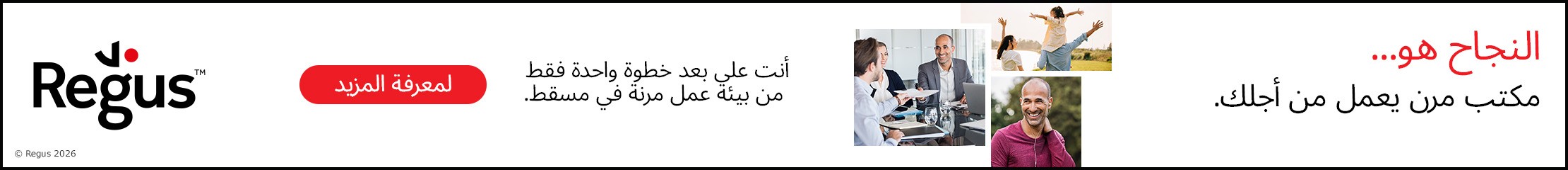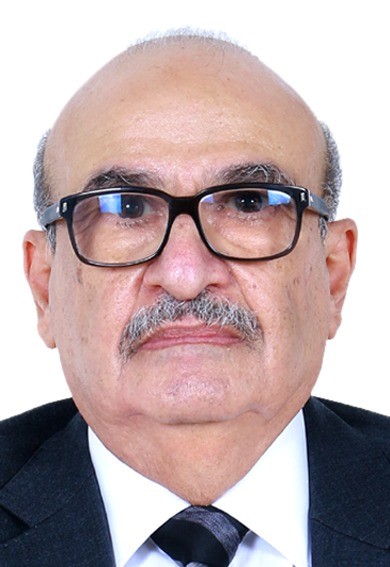عبيدلي العبيدلي **
مقدمة
لطالما اعتبر قطاع غزة واحدة من أصعب المناطق وأكثرها اضطرابا في العالم، حيث يتقاطع الصراع والسياسة والمعاناة الإنسانية مع المشروعات السياسية والمخططات. تبلغ مساحة قطاع غزة حوالي 365 كيلومترًا مربعًا فقط، وهي منطقة صغيرة، ولكنها ذات أهمية جيو- سياسية، واقتصادية عميقة.
عاش عدد سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة لسنوات تحت الحصار والحرب الدورية والشلل السياسي. وقد تدهورت الحالة الاقتصادية بشكل مطرد، مما أدى إلى أعلى معدلات البطالة والفقر في العالم. وفي ظل هذه الخلفية، فإن الجهود المبذولة لتحقيق السلام ليست مجرد مسائل تفاوض سياسي - بل هي أيضا مسائل تتعلق بالبقاء الاقتصادي والتنمية.
في الربع الرابع من العام 2025، تم لفت الاهتمام متجددا إلى غزة من خلال ما يسمى بــ "مشروع ترامب- نتنياهو للسلام"، الذي تم تقديمه كخطة من عشرين نقطة، تدعي أنها تحمل مشروعًا تدريجيًا لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، وانسحاب القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء غزة، ونزع سلاح حركة "حماس"، وإنشاء إدارة دولية انتقالية. لا تكمن خطورة هذا المشروع في إسكات البنادق فحسب، بل في إعادة تشكيل المسار السياسي والاقتصادي لحرب غزة. وخلافا للاتفاقات السابقة التي كانت غامضة في كثير من الأحيان بشأن القضايا الاقتصادية، تؤكد هذه الخطة صراحة على إعادة الإعمار، وإعادة فتح طرق التجارة، واستخدام موارد الغاز الطبيعي في غزة كركيزة أساسية للسلام. لكنها بالقدر ذاته، تتجاوز الحقوق الطبيعية المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أقترها له المنظمات الدولية والإقليمية.
تساؤلات كثيرة ومعقدة تثيرها خطة ترامب – نتنياهو، لكن السؤال الطبيعي، الذي هو، لماذا تتجاوز الوثيقة كل عناصر الحرب التي تشنها القوات المسلحة الإسرائيلية على شعب غزة، وتحاول ادعاء أنها تركز على الاقتصاد؟
هذا يؤكد أن فهم مشروع ترامب – نتنياهو، يبقى ناقصًا في غياب فهم البعد الاقتصادي الذي يقف وراء تلك الوثيقة. فاقتصاد غزة، أثناء الحرب وأكثر منه وبعدها مترابط بطبيعته مع الاقتصادات الإقليمية المجاورة. وهي بدورها تترابط مع الاقتصادات الإقليمية والدولية.
لقد فشلت الاتفاقات السياسية التي لا أساس لها اقتصادي مرارًا وتكرارًا في الشرق الأوسط. على الرغم من أن اتفاقيات أوسلو في التسعينيات كانت رائدة في اعترافها بالحكم الذاتي الفلسطيني، إلا أنها لم تخلق أبدا هذا النوع من التحول الاقتصادي الذي يمكن أن يرسخ السلام. وفي غزة، ظلت البطالة مرتفعة بعناد، وتدهورت البنية التحتية، وتصاعد الإحباط. عندما اندلع العنف مرة أخرى في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يكن هناك سوى القليل من الفوائد المادية التي يمكن أن تخسرها العودة إلى الصراع. وهذا يؤكد حقيقة مركزية: فبدون أمل اقتصادي، لا يمكن الحفاظ على السلام السياسي.
وتتجلى إحصاءات غزة في إلحاح البعد الاقتصادي. بحلول العام 2024، كانت البطالة الإجمالية أعلى من 45%. وتجاوزت بطالة الشباب 60%. واعتمدت أكثر من 80 في المائة من الأسر على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. كانت الكهرباء متاحة لبضع ساعات فقط في اليوم، وكانت المياه النظيفة نادرة، وتعمل المستشفيات تحت ضغط مستمر. وقدر البنك الدولي أن إعادة بناء البنية التحتية التي دمرت في حرب 2023-2024 ستتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وما لا يقل عن عقد من الجهود المستمرة. هذه الأرقام ليست مجردة فقط. وهي تعكس النضالات اليومية لسكان غزة العاديين، والتحدي الهائل المتمثل في بناء السلام على هذه القاعدة الاقتصادية الهشة.
ومع ذلك، فإن مصير غزة ليس معزولا. فهو يؤثر ويتأثر بمستوى الهدوء والاستقرار اللذين ستنعم بهما غزة أولًا. وسيتعكس ذلك بشكل مباشر على جيرانها وحتى الاقتصادات العربي البعيدة عنها. بالنسبة لإسرائيل، كانت الحرب تعني تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وانخفاض السياحة، وزيادة العجز المالي. بالنسبة لمصر، كان للصراع في غزة آثار غير مباشرة في شبه جزيرة سيناء ومن خلال تعطيل إيرادات قناة السويس حيث تم استهداف طرق الشحن في البحر الأحمر. وبالنسبة للبلدان الخليجية المصدرة للنفط، فإن كل تصعيد في غزة يزيد من التقلبات في أسواق النفط، مما يعقد التخطيط المالي. بالنسبة للولايات المتحدة، يترجم الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتعطل الشحن، والضغوط التضخمية التي تمتد إلى السياسة الداخلية. هذا الترابط يجعل من سلام غزة ليس ضرورة محلية فحسب، بل يجعل أيضا شاغلا اقتصاديا إقليميا وعالميا.
إذن، يجب تحليل خطة ترامب - نتنياهو ليس فقط من حيث أحكامها السياسية، ولكن أيضا من حيث تداعياتها الاقتصادية. ماذا سيحدث إذا نجحت الخطة، واستقر السلام - مهما كان هشا؟ ما هي الآثار الاقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل وغزة والضفة الغربية ومصر والاقتصادات العربية المصدرة للنفط؟ ما هي القطاعات التي ستستفيد، وما هي المخاطر التي قد تقوض المكاسب، وما هي المؤشرات التي ينبغي لصناع السياسات مراقبتها للحكم على التقدم المحرز؟ هذه هي الأسئلة المركزية التي تسعى هذه الورقة إلى استكشافها.
تنظر هذه المقالة في نظرية مكاسب السلام، التي تفترض أن الموارد المفرج عنها من الصراع يمكن إعادة توجيهها نحو التنمية، ولكنها تؤكد أيضا على الظروف التي تفشل في ظلها تحقيق المكاسب - مثل ضعف الحوكمة، أو إرهاق المانحين، أو تجدد العنف. تسلط الدروس المقارنة المستفادة من البوسنة ولبنان والعراق وأيرلندا الشمالية الضوء على الفرص والمزالق. يستمر التحليل بشكل فاعل تلو الآخر، ويحدد القنوات النشطة، والمخاطر والمؤشرات القابلة للقياس.
باختصار.. هذه ليست مقالة تعالج ما إذا كانت خطة ترامب ونتنياهو للسلام ستنجح سياسيًا، هذا السؤال يعتمد على القيادة والتفاوض والأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها. ومن هنا فهي مقالة لما قد يعنيه النجاح اقتصاديًا. والمخاطر كبيرة: فإذا تم تنفيذ السلام في غزة بشكل فعال، فيمكن أن يحول ليس فقط جيبا مدمرًا، بل يمكن أن يعيد أيضا تشكيل الديناميكيات الاقتصادية من واشنطن إلى القاهرة والرياض وتل أبيب. وإذا فشلت، فسوف تتحمل التكاليف على نطاق واسع، مما يعزز عودة دورة الصراع التي يولدها اليأس.
** خبير إعلامي