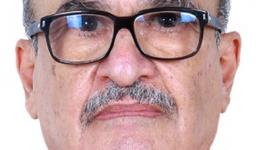سلطان اليحيائي
لا أحد يُنكر جهود الحكومة وما قدّمته من توجيهات ومبادرات في تنظيم السوق وتحسين بيئة العمل، وذلك جهدٌ مقدَّر ومُثمَّن. لكن يبقى من الواجب التأكيد أن الدور المحوري في توليد الفرص الوظيفية لا يقع على "وزارة العمل" التي يقتصر دورها على التنظيم والمتابعة؛ بل على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ فهي القلب النابض للاقتصاد وصاحبة اليد الطولى في فتح أبواب التشغيل عبر تنمية المشاريع والاستثمارات.
ومن هنا فإن التوازن بين "المُولِّد" و"المنظّم" هو ما سيحدّد نجاح أي خطة عمل قادمة.
بلغ إجمالي القوى العاملة في السلطنة أكثر من 2.2 مليون عامل، بينهم 1.44 مليون وافد مقابل أقل من 800 ألف عُماني؛ أي أن الوافدين يشكّلون 64% من السوق، والعُمانيون لا يتجاوزون 36%. أما في القطاع الحكومي؛ فالأرقام مطمئنة (90% عُمانيون)، لكن القطاع الخاص هو الفجوة الكبرى: أكثر من 1.4 مليون وافد مقابل 411 ألف عُماني فقط.
الأرقام التي بين أيدينا لا تحتمل العودة إلى الوراء. ما حدث لا نريده أن يتكرّر. الأخطاء وقعت، والنتائج واضحة: سوق عمل يفيض بالوافدين، بينما المواطن يبحث عن رزقه في أرضه فلا يجده.
لكن بدل أن نظل أسرى للتشخيص واللوم؛ فلنحوّل الأزمة إلى بداية جديدة، بخطة واقعية تعيد للعُماني مكانته، وتحفظ للوطن سيادته الاقتصادية.
المشكلة ليست في المواطن الذي يُتّهم بالتقصير، ولا في الوافد الذي يُنظر إليه كعدو؛ بل في منظومة التشغيل ذاتها التي سمحت باختلال التوازن. من استثماراتٍ بلا التزام حقيقي بتوظيف العُمانيين، إلى اعتمادٍ مفرط على اليد العاملة الرخيصة بدل بناء كفاءات وطنية، وصولًا إلى غياب التنسيق الفعلي بين وزارة العمل بوصفها المنظّم، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باعتبارها المحرّك الرئيس للاقتصاد.
ولمن يتساءل: "ومن أنت لتقترح خطة لوزارة؟"
أقول: "من يسعَ للمعرفة يجدها" وهذه المقترحات ليست إلّا قراءة واقعية للأرقام، وتحليل شامل لسوق العمل، استنادًا إلى إحصاءات رسمية ودراسات اقتصادية، وهي موجّهة لأي جهة معنية ترغب في وضع رؤية واضحة لإنقاذ سوق العمل.
1- قصيرة المدى (عام واحد)
أ. توطين بعض المهن الحرجة فورًا (البيع بالتجزئة، الخدمات الإدارية، الوظائف المساندة).
ب. تحديد حد أقصى لنسبة القوى العاملة الوافدة في كل منشأة لضمان توظيف العُمانيين بشكل متوازن قبل زيادة عدد الوافدين.
ج. فتح منصة وطنية شفافة وإن -وُجدَت- تخضع (للرقابة) تعرض الوظائف الشاغرة بشكل فوري للعُمانيين.
2- قصيرة - متوسطة (1–3 أعوام)
أ. ربط منح التسهيلات والاستثمارات الأجنبية بجدول زمني لتوظيف العُمانيين.
ب. استبدال سياسة الغرامات على عدم التعمين بحوافز ضريبية وتمويلية للشركات الملتزمة.
ج. إطلاق برنامج "مهن المستقبل" لتدريب العُمانيين على القطاعات التقنية والصناعية التي سيحتاجها الاقتصاد.
3- متوسطة المدى (3–5 أعوام)
أ. إعادة هيكلة برامج التدريب المهني لتكون مرتبطة بعقود عمل مضمونة.
ب. إنشاء وحدات توظيف داخل المناطق الاقتصادية والصناعية تتولى ربط المستثمر مباشرة بالكادر العُماني.
ج. توسيع فرص ريادة الأعمال للمسرّحين عبر مشاريع صغيرة مدعومة بالتمويل والتسويق.
4- طويلة المدى (5–10 أعوام)
أ. تقليل الاعتماد على القوى العاملة منخفضة الأجر، وتحويل الاقتصاد نحو القيمة المضافة العالية.
ب. بناء شراكات تعليمية مع الجامعات العالمية لإعداد جيل يتقن الصناعات الدقيقة والتكنولوجيا المتقدمة.
ج. إدخال برامج "العُماني أوّلًا" في قطاعات الطاقة المتجددة والتقنية والذكاء الاصطناعي.
5- مرحلة التحصين (10 أعوام فأكثر)
أ. جعل تشغيل المواطن ركيزة من ركائز "الأمن القومي".
ب. سنّ تشريعات لا تسمح باختلال نسبة القوى العاملة الوطنية مجددًا.
ج. تحويل سوق العمل العُماني من مستهلك للوظائف إلى مُصدّر للخبرات.
ومؤخرًا زاد الحديث حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية العُمانية الهندية، ونرى أن هذه الاتفاقية ليست شرًّا مطلقًا، لكنها تتحوّل إلى تهديد إن لم تُدار بحكمة. والحل أن تُربط أي استثمارات هندية ببرامج تشغيل وتدريب للعُمانيين داخل السلطنة، لا باستقدام المزيد من القوى العاملة.
وأخيرًا.. سوق العمل بحاجة إلى خطة متكاملة، لا قرارات جزئية، والمطلوب اليوم أن نحوِّل الأرقام من أزمة إلى فرصة، ونعيد للعُماني مكانته الحقيقية في سوق العمل. إذا تمسكنا بالخطوات الصحيحة، وعملنا بتخطيط واقعي وصارم، فسيزدهر الوطن، وعلى أمل ألا يظل العُماني يومًا غريبًا في وطنه.