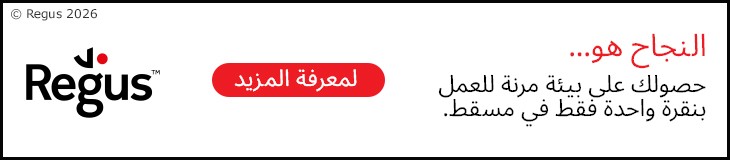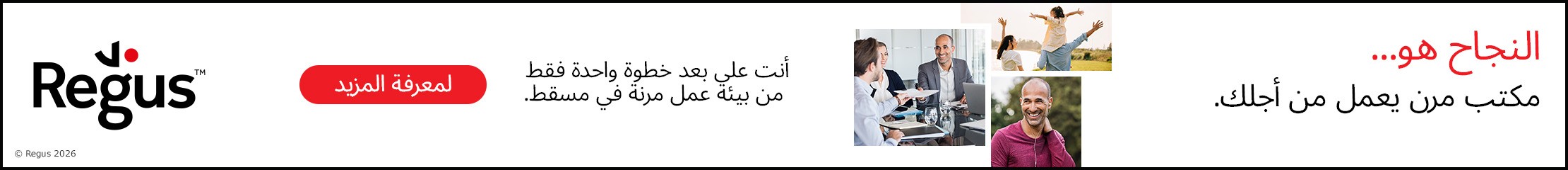عبدالنبي الشعلة **
خلال العشرين عامًا الماضية، تكرَّرت زياراتي لإسبانيا، وفي كل مرة، لا يسعني إلّا أن أُخصِّص وقتًا لزيارة مدينة قرطبة أو مدينة غرناطة، وهما من أبرز مراكز الإشعاع الحضاري العربي الإسلامي في الأندلس. وعند زيارتي لقرطبة، أحرص على الوقوف أمام تمثال الفيلسوف والمفكر الأندلسي الكبير ابن رشد، في ساحة تحمل اسمه بحيّ اليهود في قلب المدينة القديمة، وعلى مقربة من الجامع الكبير.
ومثل كثيرين من أبناء العرب والمسلمين، تنتابني هناك مشاعر مختلطة: شعور بالفخر والاعتزاز بإرث هذا المفكر العظيم، وشعور آخر بالحسرة والحيرة، لأن من ينصب له التماثيل ويحتفي به ليس العرب ولا المسلمين؛ بل أوروبا، التي أعادت الاعتبار له بعد قرون من التجاهل والنسيان في موطنه الحضاري الأصلي.
هذا التمثال ليس الوحيد في أوروبا؛ فهناك تمثال آخر له في جامعة السوربون بفرنسا، وآخر في جامعة ليدن بهولندا، إلى جانب عشرات الدراسات والأبحاث والمناهج التي تناولت إرثه الفلسفي والعلمي. ولكن تمثال قرطبة هو الأكثر رمزية: ابن رشد يعود إلى المدينة التي شهدت ولادته وتألقه، ثم شهدت نفيه وإقصاءه، لكنه يعود إليها اليوم في هيئة مكرَّم، محاط بالتقدير.
إنها مفارقة مؤلمة: كيف للمدينة التي طردته وهو في كنف دولة إسلامية آنذاك، أن تستعيده بعد قرون لتحتفي به في كنف دولة أوروبية مسيحية، فيما عواصم العرب والمسلمين تواصل تجاهله؟
أكان ابن رشد بحاجة إلى أوروبا لكي يُقدَّر؟ أم أننا نحن -في هذا العصر- من نحتاج إلى ابن رشد لنتصالح مع عقلنا وهويتنا، ونصوصنا التي ظلت رهينة الجمود وسوء التأويل؟
وُلد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد عام 1126م في قرطبة، في زمن بلغت فيه الحضارة الأندلسية أوجها. ولم يكن فقيهًا أو قاضيًا فحسب، بل كان طبيبًا وفلكيًا وفيلسوفًا موسوعيًا بامتياز. وهو ممن سعوا بجرأة ومسؤولية إلى التوفيق بين النقل والعقل، وبين الشريعة والحكمة، ورأى أن الدين الحق لا يناقض الفلسفة الصادقة.
في كتابه الشهير "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" وضع الأساس لما يمكن تسميته اليوم بالتفكير النقدي الإسلامي، مؤكدًا أن تأويل النصوص يجب أن يُبنى على منهج عقلي رصين، وأنه لا تعارض بين العقل والنقل إذا أُحسن الفهم وصدق المقصد.
ورغم أن ابن رشد ظل طوال حياته مؤمنًا ملتزمًا، وكان قاضيًا مالكيًا رسميًا لدى بلاط الموحدين في الأندلس، فإن التيارات المتشددة آنذاك لم ترَ فيه إلا زنديقًا منحرفًا عن العقيدة. فكان نصيبه النفي، والحصار الفكري، وإحراق كتبه، في مشهد يكاد يتكرر -بمختلف الأشكال- مع كل مفكر حرّ عبر العصور.
وفي الوقت الذي أُقصي فيه ابن رشد من عالمه الإسلامي، حملت أوروبا كتبه المترجمة إلى اللاتينية والعبرية، وجعلتها جزءًا من مناهجها في جامعات باريس وبولونيا وأوكسفورد، حيث لقّبته بـ"الشارح الأكبر لأرسطو"، واعتبرته حلقة الوصل التي نقلت الفلسفة اليونانية إلى عصر النهضة الأوروبية. ووجد فيه فلاسفة أوروبا -المسيحيون واليهود على السواء- نموذجًا للتنوير والجرأة العقلية في مواجهة استبداد الكنيسة.
المفارقة أن اسمه ظل يتردد هناك بإجلال، بينما أُدرج في بعض كتب التراث عندنا بجانب "الزنادقة"، فلا جامعة عربية تُكرِّس له فصلًا دراسيًا، ولا عاصمة عربية تحتفي به في مناهجها، ولا تمثال واحد في مدينة إسلامية يشهد على عظمة إرثه.
ليست المشكلة غياب تمثال، بل غياب ثقافة كاملة. فيما يسود العالم الإسلامي ثقافة تهاب السؤال، وتخشى الاختلاف، وتفضّل النقل الأعمى على البحث والتأمل. ثقافة ما زالت تحاصر الفلسفة وتربطها بالإلحاد، وتربط الرموز التذكارية -حتى لو كانت علمية وفكرية- بالوثنية.
إنَّ التمثال ليس مجرد مجسّم من حجر أو نحاس؛ بل هو تعبير عن الاعتراف، وتقدير للدور، ونداء إلى الذاكرة الجماعية للأمم. وعندما تنصب مدينة ما تمثالًا لابن رشد، فإنها تقول لأبنائها: "هذا منكم، وهذا نموذج يُحتذى به في استخدام العقل، وفي محبة العلم، وفي التوفيق بين الإيمان والتفكير الحر".
لكن الاحتفاء الحقيقي لا يكون بالنُصب وحدها؛ بل بإعادة إحياء أفكاره في التعليم والبحث والجدل العام، بالانفتاح على مقولاته الجريئة، ومناقشة رؤاه النقدية للنص الديني، وفهمه المتوازن للشريعة والحكمة.
نحن اليوم أحوج ما نكون إلى ابن رشد: لا بوصفه مفكرًا من الماضي، بل كمنهج عقلاني حيّ، يرشدنا إلى أن الدين والعقل ليسا خصمين، وأن الفلسفة لا تهدم الإيمان، بل تعمّقه، وأن استخدام العقل هو عبادة، وليس خيانة.
إن إعادة الاعتبار لابن رشد لا تعني تمجيد فرد بعينه؛ بل تعني استعادة ذلك الجانب العقلاني التنويري من تراثنا، الذي أهملناه طويلًا. تعني أن نُعيد بناء الجسور بين الإيمان والعقل، بين النص والاجتهاد، بين الموروث والتجديد.
لقد آن الأوان لأن نكفّ عن جلد ذواتنا بتقاليد الانغلاق، وأن نستدعي إرث ابن رشد من رفوف النسيان، لا لنُؤبّنه؛ بل لنحييه.. فنهضة الأمم لا تُبنى على الإنكار، بل على الاعتراف، ولا على القطيعة، بل على استئناف مسيرة العقل والتنوير.
** كاتب بحريني