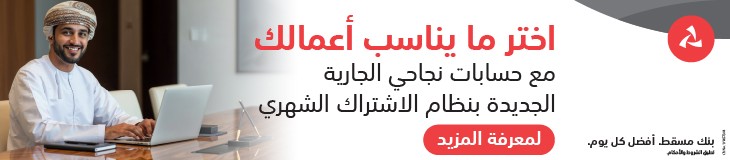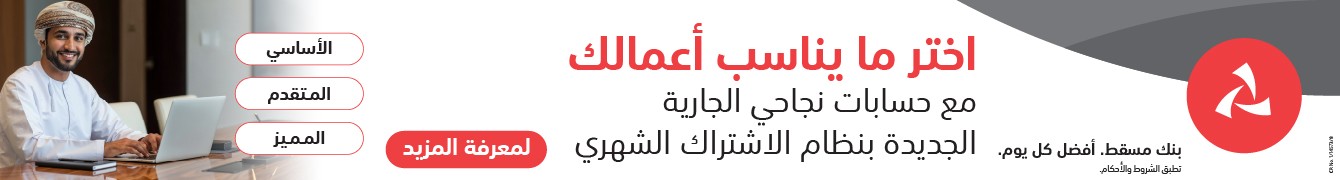أحمد الفقيه العجيلي
في عصر يُقاس فيه التأثير بعدد المشاهدات لا جودة الفكرة، تتصدر التفاهة المشهد، ويُهمّش العقلاء، ويتراجع التعليم، وتنهار المعايير، لم تعد مؤشرات التأثير في عصرنا تُقاس بالعلم، ولا مكانة الأشخاص تُبنى على الحكمة أو عمق الفكرة. بل بات المعيار هو من يُثير الضجيج، ويجيد صناعة "الترند"، ويُتقن فن الحضور الخفيف، حتى لو كان بلا مضمون.
إذن نحن أمام تحول جذري، لا في أدوات التواصل فقط، بل في البنية القيمية التي تحكم مجتمعاتنا. فمنذ سنوات قليلة، كان المثقف هو من يُستشار، والعالم هو من يُقدَّم، وصاحب الخلق هو من يُصغى إليه، أما اليوم، فقد اختلطت الأصوات، وغاب الرشد، وتقدّم من لا دراية له، وتوارى أصحاب الفضل في الزوايا.
وكما يقول آلان دونو في كتاب نظام التفاهة: "لقد تبوأ التافهون المناصب، أما أصحاب الكفاءة فقد انزَوَوا جانبًا."
وحينما أصحبت التفاهة نظاماً لا استثناء أصبح العالم يعيش لحظة فارقة، تتحكم فيها أدوات تكنولوجية فائقة التأثير، تتصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُعيد تشكيل الذائقة العامة والمعايير الثقافية وأصبحت الخوارزميات هي التي تُقرر من يظهر، ومن يُنسى. ومن ثم، لا يُطلب من المحتوى أن يكون نافعًا أو رصينًا، بل أن يكون لافتًا، سريعًا، قابلاً للمشاركة... ولو كان أجوف.
وتُشير الإحصائيات إلى أن 63٪ من الشباب اليوم يستقون أخبارهم من هذه المنصات، مما يجعل عقولهم مُعرضة للتوجيه الممنهج، لا من أصحاب الاختصاص، بل ممن يملكون أدوات التأثير الرقمي.
وكأننا نعيش زمن الرويبضة الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أصبح الرجل التافه - الذي لا يفقه شيئًا - هو من يُستشار في قضايا العامة عبر مقاطع مصوّرة قصيرة، وسلاسل ترندات "ساخرة" تُغيّب الوعي، وتختزل القضايا، وتُقصي العقلاء، يُهمَّش العلماء، ويُسخر من المفكرين، وتُطفأ منابر الحكمة لحساب شهرة آنية لا تدوم. وهذا تمامًا ما وصفه آلان دونو بقوله: "التافه هو الذي يتقن لعبة الصعود في النظام، ويخضع لقواعده، ويترقّى لا لأنه الأفضل، بل لأنه لا يُهدد أحدًا."
وهنا نتساءل: من الذي سمح بصعود التافهين؟
التفاهة لا تصعد وحدها، بل تُهيأ لها الأرض، وتُفرش لها المنابر، ويُمنح أصحابها التصفيق والترويج. ومن أبرز العوامل التي مهّدت لها:
صمت العقلاء وانسحاب أصحاب الرأي فحين آثر أهل الحكمة السلامة، وترددوا في الدخول إلى فضاءات التأثير الحديثة، فُتح المجال لغيرهم.
فكثير من المثقفين والمختصين نأوا بأنفسهم عن منصات التواصل، معتبرين أنها "سوق ضجيج"، فخلا الميدان، واحتله من لا خُلق ولا علم له. وقديما قيل: "إذا غاب العاقل، تكلم الأحمق." والصمت الطويل للعقلاء ليس حكمة دائمًا، بل قد يكون تفريطًا في وقت الحاجة.
فالمتلقي نفسه - في كثير من الأحيان - أصبح شريكًا في صعود التفاهة، حين صار يبحث عما يُسليه لا ما يُنميه. فصاحب المحتوى السطحي يحصد الإعجابات، والمفكر يُعد "ثقيلًا" أو "مُعقدًا". وهذا الانحراف في الذائقة شجع صناع المحتوى على إنتاج المزيد من "السهل الممتنع"… الذي لا يمتنع.
كما أن تساهل المؤسسات الإعلامية والثقافية في المعايير قد فتح المجال لهؤلاء، فحين تتراجع معايير الجدارة والكفاءة، ويُستضاف "المثير" لا "المؤثر"، وتُمنح الجوائز والمناصب وفق الشعبية لا المعرفة، تصبح التفاهة مُؤسّسة، لا مجرد ظاهرة عابرة، وتتحول البرامج إلى ترفيه صرف، والحوارات إلى جدل بلا مضمون، وتغيب البرامج العميقة لصالح ما "يصنع مشاهدات". وقد عبّر الإمام علي بن أبي طالب عن هذه الظاهرة حين قال: "إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت سلبته محاسن نفسه." حين تصعد التفاهة وتتراجع الكفاءة، فإن أول القطاعات التي تدفع الثمن هو التعليم، الذي يُفترض أن يُخرّج العقول لا يُخرّج المتابعين.
ومع تعاظم رموز السطحية، يصبح القدوة عند الطالب ليس المعلم أو الباحث، بل صاحب المقاطع الطريفة والعبارات المثيرة. وهذا ينعكس على القطاع العام، إذ تضعف الكفاءة ويُستبدل الأداء بالواجهة، وتُدار المؤسسات بعقلية العلاقات لا بالخطط، فينهار الأداء وتتدنى الإنتاجية.
وفي لحظات التحول الحضاري، لا تسقط الأمم فجأة، بل تتآكل من الداخل بصمت؛ حين تتقدّم الواجهة على الجوهر، وتُستبدل الكفاءة بالاستعراض، ويُرفع الجهل على أنه وعي، وتُقدَّم التفاهة في هيئة حكمة. ولعلّ سقوط بغداد عام 656هـ مثال حي على هذا المسار، حين أُهملت الكفاءات، وسُرّحت العقول، وأُغدقت الأموال على الجهلة والمنافقين. لم تعد الدولة تُدار بالعقل والحنكة، بل تحولت إلى قصر من ترف واستعراض، فكانت النتيجة انهيارًا مروعًا على يد هولاكو، وسقوط مدينة كانت رمزًا لحضارة كاملة.
هذا المشهد لا يخصّ الماضي وحده، بل هو واقع يتكرر بصيغ جديدة. نحن نعيش اليوم حالة صعود غير مسبوق لما أسماه المفكر الكندي آلان دونو "نظام التفاهة"، وهو نظام لا يفسد الأفراد فقط، بل يُنتج بيئة كاملة تُكافئ الامتثال وتُعاقب التميز، وتستبدل العمق بالسطحية، والمعنى بالضجيج، والكفاءة بالشهرة.
عندما يتصدر المشهد من لا علم له ولا تجربة، تتحول الساحة العامة إلى صدى للانفعالات، لا ميدانًا للفكر. تغيب القضايا الجوهرية، وتتوارى الموضوعات الكبرى، لتُستبدل بنقاشات هامشية تصنع الإثارة لا الفهم، ويضيع الرأي العام وسط طوفان من التوجّه لا التعبير، والتلقين لا التفكير.
وتتشوّه المعايير حين يرى الجيل الناشئ أن النجاح لا يرتبط بالاجتهاد أو الخلق أو العلم، بل يرتبط بالقدرة على لفت الانتباه ولو بالسخرية أو الجدل الفارغ. تُستبدل القدوة بالواجهة، والمربّي بالمؤثر، والمحتوى بالصوت العالي، فتنشأ أجيال تعيش في فقاعة شهرة زائفة، بعيدة عن واقع البناء الحقيقي.
ولا يسلم التعليم من هذا التيار الجارف، إذ يُستهزأ بالمعلم، ويُستبدل احترام المعرفة بالبحث عن الملخصات السريعة، وتُهمل مهارات التفكير والتمييز. فتتراجع الكفاءة، وتضعف الإنتاجية، ويختل الأداء في مؤسسات الدولة والمجتمع، نتيجة لتراكم مخرجات تعليمية تفتقر إلى العمق والمنهج.
أما التفاهة حين تسيطر على المنصات العامة، فإنها لا تجمع، بل تفرّق. لا تبني، بل تهدم. لأن غايتها ليست الفكرة ولا المصلحة العامة، بل البروز والإثارة. تُزرع ثقافة الاستهزاء، ويغيب أدب الاختلاف، وتتفكك القيم المشتركة التي تُمسك نسيج المجتمعات، فنجد أنفسنا أمام حالة من التشظي والانقسام.
وحين يُقدَّم غير المؤهلين إلى المواقع الحساسة، فإن الخطر لا يكون إداريًا أو معرفيًا فقط، بل وجوديًا. وقد نبه النبي ﷺ إلى هذا المعنى العميق حين قال: "إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة" (رواه البخاري). الحديث لا يخص المناصب العليا فحسب، بل يشمل كل موقع يُدار بغير أهله: في التعليم، في الإعلام، في القضاء، في الرأي العام، وفي كل ساحة يؤثر فيها القرار أو الكلمة.
وإذا كنّا نُدرك حجم الانحراف في المعايير، فلا بد أن نعي أن الصمت لم يعد خيارًا، ولا الترفع عن الدخول في "سوق الكلام" مبررًا للغياب. يجب أن يعود أهل الرأي والخبرة إلى المشهد العام، لا لمجاراة التافهين، بل لحضور رصين وهادئ وثابت، يزرع الثقة والفهم في ساحة اختلط فيها كل شيء. فمن يغيب عن الميدان، لا يلوم من يحتله.
ولا بد من إعادة تشكيل الذائقة الجمعية، عبر التربية والتعليم والإعلام، لتستعيد الكلمة قيمتها، وتُفهم الشهرة في سياقها الحقيقي، ويُفرّق بين من يفكر ومن يثير، بين من ينفع ومن يُشغل الفراغ. فليس كل من كثر متابعوه يستحق أن يُسمع، ولا كل من تصدّر يستحق أن يُقتدى به.
علينا أيضًا أن نعيد إحياء السنة النبوية في اختيار القادة والمستشارين، فالنبي ﷺ كان لا يُسند أمرًا إلا لمن يجمع بين الكفاءة والأمانة، لا لمن يطلبه، ولا لمن يثير الإعجاب السطحي. هذه القاعدة يجب أن تحكم اختيار المسؤول، والمربي، والموجّه، وكل من له أثر في التشكيل العام للعقول والقرارات.
ولا يمكن إنقاذ الذوق العام ما لم تراجع المؤسسات الإعلامية خطها التحريري، وتتوقف عن صناعة التافهين لمجرد أنهم "يربحون المشاهدات". كما أن المؤسسات التعليمية مطالبة بإعادة بناء القيم والمناهج، بحيث تُنتج جيلًا قادرًا على التمييز، لا فقط على الحفظ، وعلى المشاركة، لا فقط على التلقي.
غير أن كل هذا لن يُثمر ما لم يبدأ الفرد بمراجعة ذاته. قبل أن نطالب بتغيير المجتمع أو إصلاح الإعلام، علينا أن نتساءل: هل نُسهم، دون أن نشعر، في ترسيخ التفاهة؟ هل نتابعها؟ نُعيد نشرها؟ نُقلد رموزها؟ إن أولى خطوات الإصلاح تبدأ من هذا الوعي الفردي، من إدراك أثر المتابعة، واختيار من نصغي له، ومن نرفع صوته.
نحن لا نخوض معركة محتوى فحسب، بل معركة وعي. لسنا ضد الترفيه، بل ضد تسويقه كمعيار للجدارة. ولسنا ضد الشهرة، بل ضد أن تتحول إلى بطاقة عبور لكل منصة وموقع تأثير. فبقاء التفاهة في الصدارة ليس قدرًا، بل نتيجة غياب من يُنهض بالفكرة، ويُعيد ترتيب الذوق العام.
الحكمة لا تموت، لكنها تحتاج منبرًا يصونها، وعقلًا يصغي لها بإرادة حرة ونضج صادق. والتافه لا يعلو إلا حين يصمت العاقل. وإن كنا لا نملك السيطرة على الخوارزميات، فإننا نملك الاختيار: من نتابع، من نُشارك، من نُصغي له، ومن نصنع له جمهورًا.