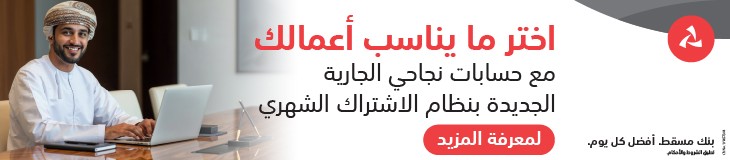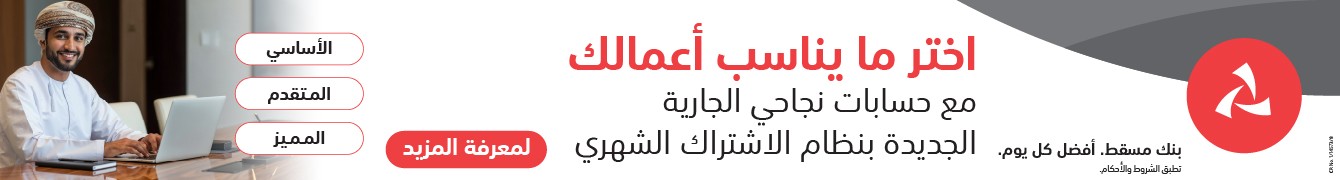تحقيق: ناصر أبوعون
يقول الشَّيخُ القاضِي الأجَلّ عِيَسى بِنْ صَالِحٍ بِنْ عَامِرٍ الطَّائِيُّ: [(ذِكْرُ الرِّبَاطِ). وَهِيَ (مَحِلَّةٌ) قَدِيْمَةٌ وَاقِعَةٌ جَنُوْبَ ظَفَارِ الْقَدِيْمَةِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا رُسُوْمٌ وَأَطْلَالٌ: [فَهَلْ تُجِيْبُ أَرْسُمٌ بَالِيَةٌ/ وَأَرْبعٌ خَالِيَةٌ مَنْ يَنْشُدُ]. وَلَمْ يَبْقَ قَائِمٌ بِهَا إِلَّا (مَسْجِدٌ جَامِعٌ) بِهِ عِدَّةُ أُسْطُوَانَاتٍ وَ(مِنْبَرٌ مِنْ خَشَبٍ). وَبِهَذَا الْمِنْبَرِ تَارِيْخُ صَنْعَتِهِ بِـ(النَّقْشِ)، وَحَولَ هَذَا الْمَسْجِدِ (مَقْبَرَةٌ عَظِيْمَةٌ) بِهَا عِدَّةُ قُبُوْرٍ عَلَيْهَا (أَلْوَاحٌ مِنَ الرُّخَامِ) نُقِشَ عَلَيْهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرَآنِ الْعَظِيْمِ وَاِسْمِ صَاحِبِ الْقَبْرِ وَنَسَبِهِ وَتَارِيْخِ وَفَاتِهِ. وَمِنْ بَيْنِ تِلْكَ الْقُبُوْرِ قَبْرُ (الْمَلِكِ إَبْرَاهِيْمَ بِنِ يُوْسُفَ)، وَقَبْرِ (أَبِيْهِ الْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ الْغَسَّانِيَ). وَقَبْرِ (الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلّيّ القلعي) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْأَفَاضِلِ أَهْلِ التَّقْوَى وَالصَّلَاحِ؛....)].
.....
كيف نشأ (الرباط) و(الزاوية) في ظَفار؟
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيسى بن صَالِحٍ الطَّائِيُّ: [(ذِكْرُ الرِّبَاطِ). وَهِيَ (مَحِلَّةٌ) قَدِيْمَةٌ وَاقِعَةٌ جَنُوْبَ ظَفَارِ الْقَدِيْمَةِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا رُسُوْمٌ وَأَطْلَالٌ: [فَهَلْ تُجِيْبُ أَرْسُمٌ بَالِيَةٌ/ وَأَرْبعٌ خَالِيَةٌ مَنْ يَنْشُدُ].
يتضمن قول الشيخ عيسى الطائيّ: [(ذِكْرُ الرِّبَاطِ)] مُصطلحين، هما: (الرباط) و(الزاوية)، وهما متساويان من حيث الوظيفة، إلا أنّ مصطلح (الرباط) استخدمه الخزرجيّ، ونشأ في الأصل كمبنى ذي وظيفة دِفاعيّة، ثمّ أصبح فيما بعد مبنى دينيًا للمُتعبّدين من الجُند البطّالين، الذين يقضون بقية حياتهم متفرغين للعبادة. أمّا (الزاوية) فمصطلح مغربيٌّ أطلقه من ابن بطوطة بدلالته التي تعني مبنى المتصوّفة العلماء وفقهاء الدين الدارسين لأصوله (01). ولكن كيف نشأ (الرباط) و(الزاوية) في ظَفار العُمانيّة؟ لقد كانت ظَفار محطَّ أنظار رجال التصوّف وأعلامه؛ ففي عهد الملك الواثق إبراهيم بن السلطان شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول (711هـ - 1311م)؛ ويُروى أنّ ولد أحمد الرفاعيّ وصل ظَفار يريد الحج، فتلقّاه السلطان بالإجلال والإكرام، وأقامه عنده ثلاثة أيام في الضيافات النَّفيسة، وكان يرسل له كل يوم ألف دينار، فلما وصل العلم بوفاته أمر السلطان بالقراءة عليه سبعة أيام، وحضر القراءة ملكُ بني رسول، وأعيان الدولة(02)، كما يذكر الخزرجي أن الفقيه الفاضل أبو عبدالله محمد بن علي بن عبد الله ولد صاحب المقداحة(03) كان قد خرج في حياة أبيه قاصدًا السياحة والتَّعبّد فبلغ مدينة ظَفار الحبوضيّ، وأقام هناك مُدَّةً، فلما توفي والده، وخلا الموضع من قائم يقوم فيه، أرسلوا له رسولا، وسألوه الوصول إليهم، فوصل، وابتنى رِبَاطًا على صِفَة رِباط ظَفار، وقام بالموضِعِ قِيامًا مُرْضِيًا إلى أن توفي في (سلخ جُمَادى الآخرة) من سنة (710هـ - 1310م)(04). وقِيل سُميت بـ(الرِّباط) نسبةً إلى (رُبُط العلم والدِّين والتَّعبّد)، التي تأسست في القرن السادس الهجريّ ومن أشهرها: (رِباط بامنصور)، و(رِباط الشيخ سعد الدين بن علي الظَفاريّ ت٦٠٧هـ) المشهور بـ(رِباط الشيخ محمد بن أبي بكر حفيد الشيخ سعد ت ٧١٤هـ).
موضِع مقبرة رِباط ظَفار
وذَكر الشيخ عيسى الطائي موضِعَ مقبرة الرباط الكبيرة قائلًا: [(مَحِلَّةٌ) قَدِيْمَةٌ وَاقِعَةٌ جَنُوْبَ ظَفَارِ الْقَدِيْمَةِ)]. وكلمة (مَحِلَّةٌ) مفردٌ، وجمعها (مَحَالّ) ومعناها: (مكان ينزلُ فيه القوم)، ودلّ عليها قول عبد مناف بن رِبْع الحَربيّ الهُذَليّ يصف غارته على أعدائه ليلا: [وَأَنَا الَّذِي بَيَّتَكُمْ فِي فِتْيَةٍ/ بِـ(مَحِلَّةِ) شَكْسٍ وَلَيْلٍ مُظْلِمِ](05). وقول الشيخ عيسى الطائيّ: [(وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا رُسُوْمٌ وَأَطْلَالٌ)]: (فَهَلْ تُجِيْبُ أَرْسُمٌ بَالِيَةٌ/ وَأَرْبعٌ خَالِيَةٌ مَنْ يَنْشُدُ)، وهذا البيت منسوب للشاعر يحيى بن سلامة بن الحسين بن محمد، أبو الفضل الحصكفي، المولود بـ(طنزة) بعد الستين وأربعمائة وهي بلدة من الجزيرة من ديار بكر ونشأ بحصن (كيفا) وانتقل إلى (ميافارقين=في شمال شرق دِيار بكر، بين دجلة والفرات)، وهو إمام فاضل في علوم شتى، وكان يفتي ويقول الشعر اللطيف والرسائل المعجبة المليحة الصناعة وكان ينسب إلى الغُلو في التشيع، وَرَدَ بغداد وقرأ شيئا من مقاماته وشعره على أبي زكريا التبريزي. فكتب التبريزي على كتابه: (قرأ عليَّ ما يَدْخُلُ الأُذُنَ بِلَا إِذْنٍ). والبيت فيه تصحيف وأصله: [وَهَلْ تُجِيْبُ أَعْظُمٌ بَالِيَةٌ/ وَأَرْسُمٌ خَالِيَة مَنْ يَنْشُدُ)(06)
هل ثمة فارق بين المسجد والجامع؟
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ: [(وَلَمْ يَبْقَ قَائِمٌ بِهَا إِلَّا (مَسْجِدٌ جَامِعٌ) بِهِ عِدَّةُ أُسْطُوَانَاتٍ وَ(مِنْبَرٌ مِنْ خَشَبٍ). وَبِهَذَا الْمِنْبَرِ تَارِيْخُ صَنْعَتِهِ بِـ(النَّقْشِ)، وَحَولَ هَذَا الْمَسْجِدِ (مَقْبَرَةٌ عَظِيْمَةٌ) بِهَا عِدَّةُ قُبُوْرٍ عَلَيْهَا (أَلْوَاحٌ مِنَ الرُّخَامِ) نُقِشَ عَلَيْهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرَآنِ الْعَظِيْمِ وَاِسْمِ صَاحِبِ الْقَبْرِ وَنَسَبِهِ وَتَارِيْخِ وَفَاتِهِ)].
يتضمن قول شيخنا عيسى الطائي: [(وَلَمْ يَبْقَ قَائِمٌ بِهَا إِلَّا (مَسْجِدٌ جَامِعٌ)] مَصطلحين: (مَسْجِدٌ) و(جَامِعٌ)؛ فأمّا (الجامع): فهو نَعْتٌ للمسجد، وسمّي بذلك؛ لأنه يجمع أهلَه؛ ولأنه علامةٌ للاجتماع، فيُقال: (المسجد الجامع)، ويجوز قولنا: (مسجد الجامع) بالإضافة؛ أي: إضافة الجامع للمسجد، بمعنى: مسجد اليوم الجامع(07)، ويُقال للمسجد الذي تُصلَّى فيه الجمعة (جامعًا)، وإن كان صغيرا؛ لأنه يجمع الناس في وقت معلوم(08).
العناصر المعماريّة بمسجد الرباط
يقول شيخنا عيسى الطائيّ: [(بِهِ عِدَّةُ أُسْطُوَانَاتٍ)]، أي أعمدة، و(الْأُسْطُوَانَة) اسم فارسيٌّ مُعَرَّب. ويُسمّى مسجد رباط ظَفار بـ(زاوية محمد بن أبي بكر المشيخي تاج العارفين)، ويشغلُ مساحة تبلغ 181.5 متر مربع، وينقسم التكوين المعماري الحالي للمسجد إلى ثلاثة أقسام؛ أمّا القسم الأول فهو الغربيّ وهو عبارة عن بيت للصلاة بمساحة تبلغ 69 مترًا مربعًا، ويتجزَّأُ من الدخل إلى (بلاطتين) بواسطة (بائكة) عبارة عن ثلاثة أعمدة و(كَتِفَين) مُدْمَجين بارزين من سِمْت كلٍّ من الجدارين الشمالي والجنوبيّ. وكانت هذه الأعمدة والكتفين تحمل فوقها أربعة (عُقُود) كانت تحمل السقفَ مع الجدران الخارجية الأربعة. وقد سقط السقف الأصليّ وأُعِيد بناؤُه في الخمسينيات من القرن العشرين(09) بمستوى أكثر انخفاضًا عن مستوى السقف المُجدَّدِ وكسوة الجزء الذي يعلو هذه المواضع من جدار القبلة بالملاط=المُوْنَة=خَلِيطٌ منَ الكِلْس والرَّمْل)، والتي تدل على أن السقف الأصليّ كان أعلى من مستوى السقف المجدَّد ويُتَوَصَّل إلى داخل المسجد من سُلّم يرتفع ثلاث درجات تنتهي بـ(بَسْطة= مساحة مسطَّحة منبسطة يدور عندها السُّلّمُ ويغيِّر اتِّجاهَه)، ومنها يُتَوَصَّل باب يقع في الطرف الغربيّ من الجدار الجنوبيّ ويبلغ اتساع فتحته مترا، وارتفاعه 2.20 متر، يعلوها (عتب حَجَريّ= الفسحة التي تلي الباب من الداخل، والمحجوزة عن أرض الغرفة بحاجز)، ويقع في مستواه من أعلى وفي الطرف الشرقيّ للجدار الجنوبيّ (نافذة= (الجمع: نافِذات ونوافِذ) هي فتحة في الجدار أو في الباب أو في السقف تسمح للهواء وللضوء بالعبور وتسمح أيضًا برؤية ما هو خارج البناء) يبلغ اتساعها مترا وارتفاعها عند قمة العقد 1.15 متر. وهذه النافذة معقودة بـ(عقد مُدبَّب= مستقيمين مائلين بزاوية حادة معينة يلتقيان في الأعلى لتَعْتِيب فتحات النوافذ والأبواب والأعمدة والأكتاف)، وهذا العقد يمكن أن يعتبر أنموذجا لاستكمال العقود التي أُنشئت في القرنين (7-8 هـ/13-14م) في العمائر الدينية والمدنيّة بظَفار والرِّباط. أمّا الجدار الشرقيّ لبيت الصلاة فيتوسطه فتحة باب يبلغ اتساعها مترًا تقريبًا، ويوجد بهذا الجدار دخلتان تكتنفان فتحة الباب المذكور، ويتقدم بيت الصلاة من جهة الشرق ساحة مكشوفة تبلغ سعتها حوالي 50 مترًا يحدُّها جدران أربعة ويوجد بالجدر الشرقي فتحة باب يبلغ اتساعها 1.20 متر، ويتوسط جدار القبلة المِحراب، ويبلغ اتساعه حوالي مترا، أمَّا عُمقُه فيبلغ 1.35 متر، وقد انعكس هذا العُمق على بروز بناء المحراب من الخارج عن سمت جدار القبلة. ويلاحظ أن ارتفاع (حِنْيَة المِحراب= تجويف داخل الحائط وأحد أساليب العِمارة الإسلامية تُستخدم للدلالة على اتجاه القبلة) يبلغ 1.80 متر فقط. وهكذا يبدو المحراب منخفضًا بالقياس إلى ارتفاع جدران المسجد التي ترتفع إلى مستوى 4.90 متر(10).
المِنْبَر في اللغة والاصطلاح
ويتضمن قول الشيخ عيسى الطائي: [(وَمِنْبَرٌ مِنْ خَشَبٍ وَبِهَذَا الْمِنْبَرِ تَارِيْخُ صَنْعته بِـ(النَّقْشِ)] إشارتين؛ الأولى: معنى (المِنْبَر) في اللغة والاصطلاح، فـ(المِنْبَر) لُغةً من مادة (نَبَرَ)، ومن معانيه (الرَّفْع)؛ فكلُّ مرتفع (مُنْتَبَر)، و(الْمِنْبَر) بتثليث حركة الميم (11) مَرْقاةُ الخَاطب، وسُمي بذلك لارتفاعه وعلوّه(12). و(الْمِنْبَر) اصطلاحًا: عنصر مِعماريٌ إنشائيّ عبارة عن منصة مرتفعة تتسع لقيام وجلوس الخطيب ويُستخدم في الجُمْعَات والأعياد والمناسبات، وهو أحد المعالجات الصوتية والبصرية؛ إذ كلما ارتفع المنبر سمع الحاضرون صوت الإمام واستقبلوه بوجوههم ليرمقهم، ويرمقوه(13) [(مِنْ خَشَبٍ)]، و(الخَشب) بفتح الخاء، وفي لغة أخرى (الخُشُب) بضم الخاء والشين: وهو ما غَلُظَ من العِيدان ونحوها. ويُجمع على ستة صِيَغٍ في العربية، هي:(خُشْب)، و(خِشاب)، و(خُشْبَان)، و(أخْشاب)، و(خُشُوب)، و(أخْشِبة). ودَلَّ على معناه قول مالك بن خالد الخُناعيّ الهُذَلي يصف قتال قومه لأعدائهم وانتصارهم عليهم: [فَمَا ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ حَتَّى كَأَنَّهُمْ/ بِذَاتِ اللَّظَى (خُشْبٌ) تُجَرُّ إِلَى خُشْبِ(14) وأول منبر خشبي في الإسلام كان منبر النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأقدم المنابر الخشبية في العالم العربي الباقية إلى يومنا هذا: منبر جامع القيروان، والذي يعود إلى عهد أحمد بن الأغلب (242-249هـ/857-864م)، وذكر الشيخ طه الولي أنّ الميل إلى صنع المنابر من الخشب هو بدافع الاقتداء بالنبي (صلى الله عليه وسلم)(15).
تأريخ إنشاء مسجد الرِّباط
وقول الشيخ عيسى الطائي عن منبر مسجد الرباط في ظفار [وَبِهَذَا الْمِنْبَرِ تَارِيْخُ صَنْعته بِـ(النَّقْشِ)]، والذي يكون غالبًا بـ(الحفر البارز أو الغائر)، وفي هذا القول إشارتان؛ أمّا الإشارة فتنبئ بأنّ الفراغ من بناء مسجد الرِّباط في ظَفَار، وصِنْعَة مِنْبَره؛ كان عام 580 هجرية الموافق 1159م، وأمّا الإشارة الثانية فكانت في قول الطائيّ بِـ(النَّقْشِ)، وهذه الكلمة تحتملُ وجهين؛ الوجه الأول: أنّ تأريخ بناء المسجد وصِنْعة (المنبر) مكتوب بالأرقام، والوجه الثاني أنّ تأريخ بناء المسجد وصِنْعة منبره مؤرّخٌ في (بيت شعريّ) كعادة أهل هذا الزمان وما قبله، حيث كانوا يعتمدون نظاما يُسمّى (حِسَاب الجُمّل)؛ وتقوم هذه الطريقة على تركيب جملة شعرية أو نثرية للتعبير عن الأعداد من (2000) حتى 1,000,00، وذلك عن طريق القاعدة المرتكزة على حرف (الغين) مع إعطاء كل حرف من (الأبجديّة) [أبجد، هوّز، حُطّي، كلمن، سعفص، قرشت، تخذ، ضظغ] قيمة عددية موجبة ثابتة لا تتغيّر؛ فمثلا إذا أردنا كتابة الرقم (1240هـ) نكتب (مرغ)؛ لأن الميم=40، والراء=200، والغين=1,000، وعند تركيب جملة شعرية تأريخية نراعي أن يكون الحرف المُعبِّر عن العدد الأكبر في المقدمة، ثم يليه الأصغر منه وهكذا دوليك. ومن أمثلة التأريخ بـ(حِسَاب الجُمّل) عندما توفي السلطان الظاهر برقوق في مصر كتب أحد الشعراء تاريخ الوفاة في عبارة: وفاة برقوق (في المشمش)؛ أي: 80+10+30+40+300+40+300= 810هـ(16).
مقابر ملوك وعلماء رباط ظفار
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ: [وَحَولَ هَذَا الْمَسْجِدِ (مَقْبَرَةٌ عَظِيْمَةٌ) بِهَا عِدَّةُ قُبُوْرٍ عَلَيْهَا (أَلْوَاحٌ مِنَ الرُّخَامِ) نُقِشَ عَلَيْهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرَآنِ الْعَظِيْمِ وَاِسْمِ صَاحِبِ الْقَبْرِ وَنَسَبِهِ وَتَارِيْخِ وَفَاتِهِ. وَمِنْ بَيْنِ تِلْكَ الْقُبُوْرِ قَبْرُ (الْمَلِكِ إَبْرَاهِيْمَ بِنِ يُوْسُفَ)، وَقَبْرِ (أَبِيْهِ الْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ الْغَسَّانِيَ)، وَقَبْرِ (الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِن عَلي القلعي) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْأَفَاضِلِ أَهْلِ التَّقْوَى وَالصَّلَاحِ].
تؤكد الدراسات المَسحيّة الآثارية، والمصادر التاريخية أن مَسْجِد الرباط حوله (مَقْبَرَةٌ عَظِيْمَةٌ) بِهَا عِدَّةُ قُبُوْرٍ من أهمها: قبر (الملك الواثق إبراهيم بن الملك المظفر يوسف بن رسول) المتوفى سنة 711ه، وقبر (الشيخ محمد بن أبي بكر بن الشيخ سعد تاج العارفين) المتوفى سنة 714ه، وقبر (الملك المغيث بن الملك الجواد بن الملك الواثق) الذي يعود تاريخه إلى سنة 746ه، وقبر (الملك الفائز بن الملك الجواد) ويحمل تاريخ وفاة سنة 765ه، وقبور أمراء الدولة الرَّسوليّة، وهي: قبر (الأمير سابق الدين يوسف بن تاج الدين إسماعيل) المتوفى سنة 776ه، وقبر (الأمير بدر الدين إيدغمش الواثقي) المتوفى سنة 718ه-، وقبر (الأمير شجاع الدين عمر بن طرنطاي) المتوفى سنة 766ه، وقبور بعض فقهاء ظَفَار، ومنها: قبر الفقيه (أحمد بن محمد بن عبد المولَى الأصبحيّ)، وقبر (الشيخ جمال الدين محمد بن عمر الأموي النَّحويّ)، وقبر قاضي ظفار ووزير المَلك الواثق المتوفى سنة 709ه، وقبر (الشيخ مدافع بن أحمد المعيني) المتوفى سنة 618ه، وقبر (السيد العلامة عقيل بن عمر عمران باعمر) المتوفى سنة 1062هـ، وقبور بعض النواخذة والقباطنة منها: قبر (محمود الهنوري) المتوفى سنة 761ه، وقبر(الخطيب إسماعيل النهروالي)(17)، وَمِنْ بَيْنِ تِلْكَ الْقُبُوْرِ [(قَبْرُ الْمَلِكِ إَبْرَاهِيْمَ بِنِ يُوْسُفَ)]، المشهور بالواثق الرسولي (711هـ - 1311م)، والملقّب بـ(السلطان الملك الواثق) بن يوسف المظفر بن عمر بن علي بن رسول، وكان حسن السيرة، عاقلا له مشاركة في فنون العلم. توفي في ظفار الحبوضيّ(18)،وشاهد قبر (الملك المغيث بن الملك الجواد بن الملك الواثق) المتوفى سنة 746ه، وشاهد قبر (الملك الفائز بن الملك الجواد) المتوفى سنة 765ه، وشواهد قبور أمراء الدولة الرسولية ووزرائها وأعيانها أهمها قبور:(الأمير سابق الدين يوسف بن تاج الدين إسماعيل) المتوفى سنة 776ه، وقبر (الأمير بدر الدين إيدغمش الواثقيّ) المتوفى سنة 718ه-، وقبر (الأمير شجاع الدين عمر بن طرنطاي) المتوفى سنة 766ه، وقد ذكره ابن بطوطة في رحلته باسم (سيف الدين عمر أمير جندر التركي الأصل).
تصميم شواهد قبور الرباط
يقول الشيخ القاضي عيسى الطائي: [قُبُوْرٍ عَلَيْهَا (أَلْوَاحٌ مِنَ الرُّخَامِ) نُقِشَ عَلَيْهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرَآنِ الْعَظِيْمِ وَاِسْمِ صَاحِبِ الْقَبْرِ وَنَسَبِهِ وَتَارِيْخِ وَفَاتِهِ)] وَمِنْ بَيْنِ تِلْكَ الْقُبُوْرِ قَبْرُ (الْمَلِكِ إَبْرَاهِيْمَ بِنِ يُوْسُفَ)، وَقَبْرِ (أَبِيْهِ الْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ الْغَسَّانِيَ). وَقَبْرُ (الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلّيّ القلعي) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْأَفَاضِلِ أَهْلِ التَّقْوَى وَالصَّلَاحِ].
يقول الشيخ عيسى الطائيّ: [قُبُوْرٍ عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِنْ رُخَامٍ صَغِيْرَةٍ] (قبور) جمعٌ ومن جموعها أيضًا (أقبُر) و(حِجَارَةٌ) جمعٌ أيضًا، ومن الجموع المشهورة عنها: (أحجار)، و(حِجَار)، و(أَحْجُر). ويقصد الشيخ عيسى الطائي بكلمة (حجارة) (شواهد القبور)، وغالبًا تأخذ الشكل المستطيل، وهي: (أَلْوَاحٌ مِنَ الرُّخَامِ). و(الرُّخام) اسم جنس، وهو حجر أملس مختلف الألوان، ويُستعمل في صناعة الأعمدة والتماثيل وغيرها. ودَلّ على معناه قول عمرو بن كلثوم التغلبيّ يشبه ساقَي صاحبته بأُسطوانتين من العاج أو الرخام: [وَسَارِيَتَي بَلَنْطٍ أَوْ (رُخَامٍ)/ يَرِنُّ خُشَاشُ حَلْيِهِمَا رَنِيْنَا(19)[نُقِشَ عَلَيْهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرَآنِ الْعَظِيْمِ وَاِسْمِ صَاحِبِ الْقَبْرِ وَنَسَبِهِ وَتَارِيْخِ وَفَاتِهِ]، و(النقش) يتمُّ بأكثر من طريقة لعمل النّقش الكتابيّ وهي: (أولا- طريقة (الأسلوب التَّنْقِيْطيّ)، وهو عبارة ورق شفاف أو مقوى أو صفائح من المعدن بها ثقوب مُفرَّغة تُوضَعُ على الشاهد في المساحة المتاحة، ثم يتمُّ وضع مسحوق الفحم في تلك المناطق لتعيين الخطوط الرئيسةِ للحروف والكلمات قبل الحفر. ثانيا: طريقة (صبّ الرصاص)؛ حيث يقوم الفنان أو الصانع بتفريغ النقوش الكتابية، والتي تُسمّى بـ(الحفر الغائر)، ثم يقوم بملء هذه النقوش الغائرة بمادة الرصاص، ويتركها حتى تثبت فتظهر بلون مغاير عن الرُّخام الأبيض(20). ومن أمثلة النقوش بـ(مقبرة الرِّباط) شاهدة قبر الملك الواثق ومحفور عليها بالخط الكوفيّ وداخل إطار مزخرف: (بسم الله الرحمن الرحيم - لا إله إلا الله محمد رسول الله- انتقل مولانا سلطان الإسلام الملك الواثق نور الدين إبراهيم بن الملك المظفر إلى رحمة الله -يوم الأربعاء لِعَشْرٍ من المُحرَّم سنة إحدى عَشَرَة وسبعمائة- وصلى الله على محمد وآله وصحبه). وفي خمسينيات القرن العشرين، انتقلت هذه الشاهدة مع مجموعة آثارية ثمينة إلى لندن، ثم استردَّتها حكومة سلطنة عُمان، وهي معروضة الآن بالمتحف الوطنيّ العمانيّ في مسقط.
ثلاثة قبور شهيرة في ظَفار
يقول الشيخ القاضي عيسى الطائي: [وَمِنْ بَيْنِ تِلْكَ الْقُبُوْرِ قَبْرُ (الْمَلِكِ إَبْرَاهِيْمَ بِنِ يُوْسُفَ)، وَقَبْرِ (أَبِيْهِ الْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ الْغَسَّانِيَ)، وَقَبْرِ (الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلّيّ القلعي)].
(قَبْرُ الْمَلِكِ إَبْرَاهِيْمَ بِنِ يُوْسُفَ)، هو إبراهيم بن السلطان المظفر شمس الدين يوسف بن عمر الرسوليّ، وقد أقطعه والده حُكم ظفار الحبوضيّ، سنة 692هـ ولقَّبه بـ(الملك الواثق بالله)، وتوفي سنة 711هـ، وَ(قَبْرِ أَبِيْهِ الْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ الْغَسَّانِيَ) وهو يوسف بن عمر بن علي بن يوسف الغسانى، (الملك المظفر) ثاني ملوك الدولة الرسولية. وُلِدَ بمكة سنة ٦١٩هـ، ووَلِيَ بعد مقتل أبيه سنة ٦٤٧ هـ، وأحسن صيانة الملك وسياسته، وقامت في أيامه فِتَنٌ وحروب، فخرج منها ظافرًا، وطالت مُدَّةُ حُكْمِه، وتُوفي سنة ٦٩٤هـ، وله كُتُبٌ منها: (اللمعة الكافية في الأدوية الشافية)، و(المعتمد في الأدوية المفردة)، وهو أول من كسا الكعبة من داخلها وخارجها سنة 659هـ بعد انقطاعِ وُرُوْدِهَا من بغداد سنة 655هـ، بسبب دخول المغول، ولا يزال على أحد الألواح الرُّخامية في داخل الكعبة إلى اليوم، النصُّ الآتي: (أمر بتجديد رخام هذا البيت المعظَّم، العبدُ الفقير إلى رحمة ربِّه وأَنْعُمه، يوسف بن عمر بن علي بن رسول. اللَّهمّ أيِّدْه بعزيز نصرك واغفر له ذنوبه برحمتك يا كريم يا غفار، بتاريخ سنة ثمانين وستمائة)، وكانت له عِنَاية بالاطلاع على كتب الطبِّ والفنون، ومعرفة بالحديث، فصنَّفَ (المخترع في فنون الصنع– خ) و(العقد النفيس في مفاكهة الجليس– خ) في خزانة مجلس الشورى الوطنيّ بطهران (كما في مجلة معهد المخطوطات 3: 31) و(البيان في كشف علم الطب للعيان- خ) مجلدان ضخمان، وجمع لنفسه (أربعين حديثاُ) كما يقول ابن كثير. وفي أنباء الزمن: قال الإمام المطهر ابن يحيى، حين بلغه خبر وفاته: (مات التّبَّع الأكبر، مات معاوية الزَّمان، مات من كانت أقلامه تَكْسِرُ رماحنا وسيوفِنا)(21) (وَقَبْرِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلّيّ القلعي) المتوفى سنة ثلاثين وستمائة للهجرة، وهو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن ابن علي بن أبي علي القَلعْي بفتح القاف وسكون اللام نِسْبةً إلى قلعة حلب بالشام وقيل نسبةً إلى قلعة بلدة بالمغرب هذا قول الجندي. وقال الأسنوي في طبقاته أنه منسوب إلى قلعة بينها وبين (زبيد) نحو يوم ولم يذكر الأسنوي اسم هذه القلعة التي نَسَبَه إليها ولا في أي ناحية هي من زبيد وهذا غلط من الأسنوي. والله اعلم. وكان القلعي المذكور فقهيًا عالمًا كبيرًا عاملاً له مُصنَّفات كثيرة مشهورة، انتفع الناس بها. منها: (قواعد المهذب) و(إيضاح الغوامض في علم الفرائض) مجلدان جيدان جمع فيه بين مذهب الشافعيّ وغيره وأورد فيه طرفًا من الجبر والمقابلة والوصايا، و(احتراز المهذب)، و(لطائف الأنوار في فضل الصحابة الأبرار). و(كنز الحفاظ في غرائب الألفاظ) و(تهذيب الرياسة في ترتيب السياسة)، و(أحكام القضاة)، وله غير ذلك. وأكثر ما توجد مصنفاته في (ظَفار)، و(حضرموت)، ونواحيها، وعنه انتشر (الفقه) في تلك الناحية، ولم ينتشر العلم عن أحد في تلك الناحية كما انتشر عنه. وأعيان فقهائها أصحابه وأصحاب أصحابه، وحجَّ من (مرباط) فَأَخَذَ عنه بـ(مكة) و(زبيد) وغيرهما من البلاد التي مَرَّ بها خَلْقٌ كثيرٌ، وكانت وفاته بـ(مرباط) وقبره هناك. والله أعلم(22).
*************
المصادر والمراجع:
([01]) مدينة ظَفار بسلطنة عمان، دراسة تاريخية أثرية معمارية، د. محمد عبد الستار عثمان، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1999م، 140-141
([02]) العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، علي بن الحسن الخزرجي (ت ٨١٢هـ)، تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي، ط1، ج1، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، دار الآداب، بيروت – لبنان، ١٩٨٣م، ص: 64
([03]) المرجع نفسه، ص: 65
([04]) نفسه، ص: 66
([05]) شرح أشعار الهُذَليين، صَنعة أبي سعيد السُّكّري (ت، 275هـ) رواية: أبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوِيّ بن أبي بكر أحمد بن محمد الحُلوانيّ عن السكّري، تحقيق: عبد الستار أحمد فرّج، راجعه: محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، مطبعة المدنيّ، القاهرة، 1965م، 2/687
([06]) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزي، دار الكتب العلمية، 1992م، ج18، ص: 129
([07]) انظر: لسان العرب، لابن منظور، فصل الجيم، باب العين،٨/ ٥٥.
([08]) المساجد - مفهوم، وفضائل، وأحكام، وحقوق، وآداب في ضوء الكتاب والسنة، د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مطبعة سفير، الرياض، د. ت، ص: 7
([09]) رواية شفوية عن الأستاذ عوض عيسى أحمد المدير السابق للآثار بمنطقة ظفار.
([10]) مدينة ظَفار بسلطنة عمان، مرجع سابق/ ص: 130، 131، 132
([11]) فقه عمارة المساجد، خالد عزب، مجلة العربي، العدد 656، يوليو 2014م، ص: 44- 45
([12]) لسان العرب لابن منظور، مج، ج 43، تحقيق:عبد الله الكبير وآخرون، مصر، القاهرة، دار المعارف، د. ط، د. ت، ص: 44-45
([13]) المرجع نفسه، 45
([14]) ديوان الهُذَليين، تحقيق: أحمد الزين وآخرون، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1995م، 3/16
([15]) انظر: نجوى عثمان، مساجد القيروان، دار عكرمة، ط1، دمشق، سوريا، 2000م، ص: 77/المنابر في العمارة المساجدية، النشأة ومراحل التطور، عثمان فؤاد، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية، العدد4، ج2، ديسمبر 2017م
([16]) التأريخ الشعري بحساب الجُمّل، سماح محمد صبري، مجلة تراث مصر، العدد1، نوفمبر 2022م
([17]) انظر: نقوش تاريخية من ظفار: شواهد القبور الإسلامية، أحمد بن محاد المعشني، 1998م-2008م - عمان تاريخ له جذور، ويندل فيليب، ط1، الدار العربية للموسوعات، 2012م
([18]) التيجان 300 والقاموس: مادة بره. وابن الأثير1: 156- الأعلام للزركليّ،ص: 82
([19]) ديوان عمرو بن كلثوم، تجميع وتحقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربيّ، بيروت، ط2، 1996م، ص: 69
([20]) خطوط شواهد القبور وأهمية دراستها، محمد الديب، بحث مُقدّم في الدورة الرابعة لملتقى القاهرة الدولى لفن الخط العربي، صندوق التنمية الثقافية
([21]) انظر: الأعلام للزركليّ: ٨/ ٢٢٤- معجم المؤلفين: ١٣/ ٣٢٠- الأرج المسكي في التاريخ المكي وتراجم الملوك والخلفاء - علي بن عبد القادر الطبري
([22]) العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية،علي بن الحسن الخزرجي(ت ٨١٢هـ)، تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي، ط1، ج1، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، دار الآداب، بيروت – لبنان، ١٩٨٣م، ص: 56 – 57