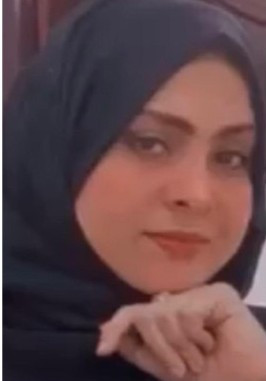سعيدة بنت أحمد البرعمية
يُقال إنَّ المجتمعات المُتقدمة تستحوذ على نسبة كبيرة من النساء المُدخنات، وهذا وفق بعض الإحصاءات والدراسات، كما يُعتقد أنَّ الظاهرة، إنما هي نتيجة لمواكبة التطورات والتحرر، ولم يقتصر تدخين النساء على المجتمعات المتقدمة فحسب؛ بل شهدت مجتمعاتنا العربية نسباً متفاوتة من النساء اللواتي أدمنّ التبغ بأنواعه، بالرغم من تصنيفنا ضمن عالم ثالث، ممّا يدل أنه لا علاقة للظاهرة بالتقدّم.
مجتمعنا الصغير المحافظ لم ينجُ؛ فالظاهرة موجودة فيه منذ زمن بعيد، ولكن بنسبة قليلة جداً، وانقرضت العادة برحيلهن، ولكن ما لبثت أن عادت باسم التطور والانفتاح وتدليل الذات؛ فهناك من هي جميلة وأنيقة تحبُّ نفسها وتهتم ببشرتها ورائحها، مثقفة وتقرأ؛ لكنها كغيرها لم تقرأ عبارة "التدخين سبب رئيسي للسرطان وأمراض القلب والشرايين"
قابلت صديقاتها بعد مدة من الانقطاع، أخرجت من حقيبتها سيجارة وأشعلتها وسط دهشتهن، جرّت نفسا عميقا ثم نفثت الدخان في وجوههن وقالت: هكذا هي الحياة، لا مكان لديَّ لهذه الدهشة التي أراها على وجوهكن، فلا شيء يبقى على حالة، نحن نتقدم، فبعد زواجي أقنعني زوجي أنَّ التدخين ليس حكرًا على الرجال، فالمرأة المتطورة الواثقة من نفسها وتحبّ زوجها، تشاركه شرابه وطقوسه وهواياته.
قالت لها إحداهن وكيف تشعرين؟ أجابت الشعور مختلف ومريح، يكفي أنني أدخن دون شعور بذنب، قاطعتها بقولها: أنا أمارس التدخين وحدي بالسر، زوجي وأهلي وصديقاتي لا يعلمون، راحتي ناقصة، أشعر وكأني أخفي جريمة، وأتعب كثيرًا بعد ذلك، كي أغيّر من رائحتي، وأعود إلى طبيعتي المألوفة، إنني أغبطك على ما أنت فيه، قالت الأولى الحياة تتغير وتتطور من حولنا، كيف لنا ألاّ نواكب المتغيرات ونرضى لأنفسنا أن نبقى ثوابت لا حياة ولا حركة!
سأخبركن شيئاً عندما ذهبت ذات يوم، برفقة بعض زميلاتي في العمل، دخلنا مقهى وجلسنا في الجانب المُخصص للعائلات، طلبنا السجائر والشيشة مع القهوة والشوكليت، وقضينا وقتاً ممتعاً، لكنها بالفعل كانت راحة ناقصة كون المكان مغلقاً؛ فالمجتمع يمقت هذه العادة وينظر للنساء المدخنات نظرة غير مُحترمة، الحقيقة أننا نتغير ولكن ضمن مجتمع ثابت لا يتغير!
وقفت الثالثة قائلة: لا مكان لي بين المدخنات المتغيرات؛ فأنا ما زلت متأخرة وثابتة ضمن مُجتمعي، فإنّي أم لأبناء كلّ همّي أن أكون قدوة لهم، ماذا لو رآني أحدهم أدخن أو حتى أجلس بينكن؟ وماذا عن تلك النصائح وعن درس المشكلات الصحية المتعلقة بالسلوك غير الصحي، الذي أخذوه في مادة المهارات الحياتية، في الصف السابع، الذي أخذ مني وقتا طويلا وشرحا عميقا مدعوما بالأمثلة، كي أرسخ فكرته في أذهانهم، إنني أفضّل الثبات والتأخر على تغيير من هذا النوع، فهو بنظري ليس تقدمًا.
التدخين، أهو عادة أم ثقافة أم تطوّر؟
يهتم كثيرا بمظهره وتجذبه أجمل العطور؛ يُحبّ ويتمنى أن يعيش طويلاً ليس من أجله؛ بل من أجل من يحبّ لكنّه يُدخن!
تجذبها روائح العطور وتنحني لقطف زهرة وتهتم بجمال ابتسامتها وشغوفة بألوان أحمر الشفاع، وتمسك بين أصبعيها اللطيفين حبّة سيجارة، وتنفث دخانها كما يفعل الرجال!
أما الأولاد في سن المُراهقة؛ فهم أكثر عرضة للتدخين، خاصة من كان والده مدخناً، إيمانًا منهم بأنهم كبروا؛ فيلجأون للتدخين كطريقة للفت النظر، للأسف ثقافة المجتمع لا تتعارض كثيرًا مع فكرة هذا المراهق، فوالده أخذ يدخن وهو في مثل عمره ولنفس الأسباب، وبطرق بدائية؛ لكن عصر ابنه يختلف عن عصره، فالابن المعاصر للتكنلوجيا بالإضافة إلى السيجارة التقليدية لجأ أيضا للسجائر الإلكترونية ( Vaping ) وأخذ يصطحبها معه للمدارس، فيكشفه المعلمون ويُعاقب، لكنه لا يتركها بل يتفنن في إيجاد الطرق التي تؤمن له سيجارته، ويعمل على التأثير بها على زملائه.
من أين لطالب مثله هذه السجائر وكيف اشتراها وكيف لا يعلم ولي الأمر ما بحوزة ابنه من النقود وماذا يشتري بها!
وماذا عن البنات المُراهقات، اللواتي يدخنَّ في دورات مياه المدارس، هل تعتقد البنت أيضًا أنها كبرت وتدخن لتثبت وجودها وتلفت النظر، أم أنها اكتسبت العادة من والدتها وصديقاتها، أم هناك من الأسباب ما لا نحيط به علما، كون هذا الجيل لديه أفكاره الخاصة وكأنهم من كوكب آخر، أم أن مجتمعنا الصغير المحافظ بات متغيرا ومواكبا للأفلام الأمريكية ومختلف الثقافات.
برأيي التدخين ليس إلاَّ، عادة سيئة لا تخدم إلا شركات التبغ، التي وضعت سمومها فيه وأخلت مسؤوليتها بوضع عبارة عليه، لايراها مدخنوها، وساهمت ثقافة المجتمعات في رواجها، ممّا جعلها تُقاس بتقدم وتطور المجتمعات.