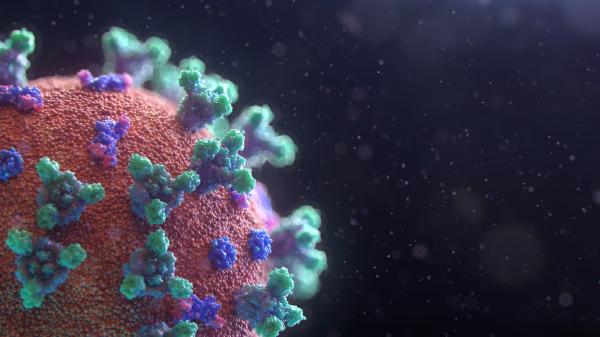ترجمة- رنا عبدالحكيم
عددت صحيفة ذا جارديان البريطانية 8 إجراءات يتعين على الحكومات حول العالم القيام بها من أجل وقف تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" والعمل على كبح جماح العدوى المجتمعية مع الحفاظ على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على أفضل نحو ممكن.
وفي مقال بقلم ديفي سريدهار رئيس الصحة العامة العالمية بجامعة إدنبره بإسكتلندا، قالت الصحيفة إن معرفة كيفية التحكم في انتشار الفيروس التاجي ليست مثل علم الصواريخ، لكن القيام بذلك في الواقع أثبت أنه بعيد المنال وصعب للعديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وأوضح الكاتب أنه عندما أخبرت الصين منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن فيروس تاجي جديد في 31 ديسمبر، بدأ العد التنازلي لاستعدادات البلدان. وتعرضت دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج، للإصابة بالفيروس لكنها لم تكن هائلة بفضل تجاربهم السابقة مع اثنين من الفيروسات التاجية القاتلة الأخرى: ميرس وسارس، ومن ثم كان رد فعل هذه الدول على التهديد سريعا. في حين أن دولا أخرى- مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة- خاضت في قضايا سياسية داخلية، فراقبوا وانتظروا، متوقعين أن يكون هذا الفيروس الجديد أشبه بسلالة إنفلونزا سيئة.
والآن وبعد أربعة أشهر تقريبًا من تفشي الوباء، ثمة دروس يمكن استخلاصها من دول شرق آسيا حول أفضل طريقة للسيطرة على هذا الفيروس التاجي والحفاظ على الحالات الجديدة اليومية عند أدنى مستوى ممكن.
وتبرِز 8 نقاط مدى وعي الحكومات عند اتخاذ الخيارات الصعبة القادمة، كما إنها توفر دليلاً لما ينبغي أن يتوقعه الأفراد حول العالم ويطالبون به حكوماتهم.
أولا: تحديد مكان الفيروس وكسر سلاسل انتقاله، وهذا يتطلب اتباع سياسة "اختبر.. تتبع.. اعزل"، وتتضمن اختبار المجتمع بشكل شامل، وتتبع المصابين ومن خالطهم، ووضع جميع هؤلاء الأفراد في الحجر الصحي الإلزامي. وسيتعين على الحكومات والبلديات المحلية تدريب كوادر مؤهلة للقيام بذلك. ورغم أن الاختبار في حد ذاته ليس حلاً، إلا أنه جزء حاسم من حزمة تدخلات الصحة العامة اللازمة لمواصلة تحديد حالات العدوى ووقف الانتشار. وإبقاء الحالات اليومية منخفضة من خلال هذا النهج يجنب المستشفيات أعباءً إضافية، ويسمح بنشاط اقتصادي واجتماعي.
ثانيا: حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية الذين هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، والذين يتعرضون لمخاطر كبرى أثناء أداء وظائفهم. ولا تتطلب هذه الحماية أولوية الوصول إلى الاختبار فحسب، بل تتطلب أيضًا معدات الوقاية الشخصية المناسبة المتاحة بسهولة.
ثالثا: الحفاظ على المراقبة المستمرة للفيروس باستخدام أنظمة التتبع للكشف عما إذا كانت أجزاء معينة من البلاد أصبحت بؤر تفشي، وما إذا كان المقيمين، مثل المهاجرين الذين يعيشون بالقرب من بعضهم البعض، أكثر عرضة للإصابة بالفيروس. ويمكن القيام بذلك من خلال البناء على شبكات الرصد.
رابعا: مراقبة الحدود للكشف عن الحالات الوافدة من الخارج. وحقق حظر السفر إلى دول معينة، فعالية محدودة، لكن الحجر الصحي الشامل لمدة 14 يومًا لأي وافدين دوليين يمكن أن يضمن اكتشاف الحالات الجديدة بسرعة بدلاً من التسبب في المزيد من الإصابات.
خامسا: التواصل الواضح والصريح مع الجمهور للحفاظ على الثقة والامتثال للتوجيهات العامة. ونظرا لأن الظروف الراهنة تمثل إزعاجا للجميع حيث يتم فرض قواعد ملزمة في السلوكيات اليومية، لذلك تعد الرسائل المتسقة والمباشرة حول آليات اتخاذ الحكومات لقراراتها، أمرًا ضروريًا لتأسيس منصة معلوماتية موثوقة في ظل تفشي عدم اليقين والشائعات.
سادسا: إدراك أن أي "استراتيجية خروج" ليست المفتاح السحري، وأن الحياة ستعود إلى أيام ما قبل العصر الذهبي. ولذا يجب تعديل "الوضع الطبيعي الجديد"، والذي من المحتمل أن يشمل التباعد الاجتماعي كلما أمكن ذلك، وإجراء اختبارات درجة الحرارة عند دخول المباني والمكاتب العامة، واستخدام الكمامات في الأماكن العامة. وكل ذلك من أجل تحقيق تفعيل بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الإجراءات التي تقلل من انتقال الفيروس.
سابعا: إذا تم تطبيق عمليات الإغلاق، في وقت مبكر وبسرعة، فيمكن أن يسهم ذلك إبطاء تفشي الفيروس، لكنها ليست حلاً في حد ذاتها، فهي سياسة مكلفة ويجب تطبيقها في أضيق الحدود قدر الإمكان. كما تسمح سياسة الإغلاقات للحكومات بتوفير الوقت واستخدامه في تعزيز البنى التحتية للقطاع الصحي بشكل كبير.
ثامنا وأخيرا: كل ما سبق عبارة عن استراتيجيات قصيرة المدى، بينما تنتظر البلدان نتائج علمية رئيسية لوضع قرارات سياسية مستنيرة والتوصل إلى "استراتيجية الخروج" النهائية.
ويبقى القول إن هناك فجوات كبرى حول ما هو متاح من معلومات عن هذا الفيروس، بما في ذلك أنظمة المناعة، وخطر إصابة الأفراد بأعراض حادة، والمدة المطلوبة لتطوير لقاح أو إنتاج علاج ناجع. لكن الخطوات المذكورة أعلاه يمكن أن تضمن للبلدان إبقاء معدل الإصابات بالفيروس منخفضا، مع تتجنب تكرار جائحة إنفلونزا عام 1918، والتي لم تسفر إلا عن سريان قاعدة "البقاء للأصلح".