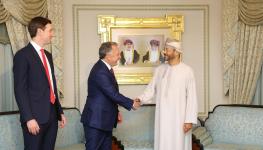د. صالح الفهدي
استمعت عرضاً إلى إجابة أحد المتخصصين -أو هكذا يُعرف- حينما سُئل في برنامج تليفزيوني عن الحكمة من وراء أضحية العيد، فذكر قصة الذبح المعروفة التي امتثل فيها سيدنا إبراهيم -عليه السلام- لأمر ربه في الرُّؤيا، وكاد أن يذبح ابنه إسماعيل، لولا أن فداه الله بذبح عظيم (يقال إنه كبش)، والمسلمون يقتدون بذلك الفعل فِداءً لسيدنا إسماعيل عليه السلام.
قلت لنفسي: إنَّ المتلقي المسلم يحتاج إلى المعاني العميقة من القصة؛ كي يُدرك الحكمة الإلهية منها، وما يحدث هو أنَّ الأغلب يرددون معاني مكرورة، لا تتوسل قراءات أعمق في المعاني الروحية، وقد كان ذلك سبباً رئيسيا في سطحية الفهم الديني للشعائر والعبادات.
بحثتُ في معانٍ أعمق عن هذه الشعيرة، ووجدت من يسأل مثلي عن دلالات الحكمة الإلهية من "الأمر بالذبح" وتكرار ظاهرية المعاني، في حين أنها تكتنف معاني روحيةً قابلةٌ للبحث، مطواعةٌ لإكسابها بعداً إيمانيًّا رمزيًّا، ووجدت أنها تحمل من المعاني ما رأيته جديراً بالتأمل أنَّ الأمر بذبح الابن ثم فداءه "يتعلق بالتحول العظيم الذي أحدثته الملة الإبراهيمية بتعويض القربان البشري بقربان حيواني، وفي ذلك إشارة جلية إلى تحرير الإنسان وتحريم إراقة دمه.. ولو لم يكن في عيد الأضحى من المعاني إلا هذا المعنى لكان فيه خير كثير" (رأي في معاني عيد الأضحى، مجلة المغرب الإلكترونية: http://ar.lemaghreb.tn).
إنَّ تفسيراً كهذا -على سبيل المثال- إنْ ترسَّخ في الإنسان منذ طفولته، غَرَس في نفسه قيمة الروح الإنسانية عند الله، وتحرير رقبة الإنسان وتحريم إراقة دمه، فينشأ مُدركاً لقيمة الإنسان عند الله، فلا يقدم على عمل مجرم إزاءه، ولا يتجرأ على إراقة دمه، لأنه يعلم أن الله قد حرره وفداه بذبح عظيم.
وعموماً، فقد وقعنا في الإشكاليات نفسها في كثير من أمور تعبداتنا، والسبب هو قصر الاجتهاد على ظاهر النص وعدم قراءته -تفسيرياً- بأبعاد ذات قيمة رمزية، ولنأخذ فريضة الصلاة التي عُلمنا إياها، فعلمناها أبناءنا على أن تاركها يستحق النار، وأن مُقيمها يستحق الجنة، وهذه تربيةٌ لا تتخللها المعاني الروحية السامية، كما أنها تقوم على أساس ناقص؛ فالصلاة لا يغني حسن إقامتها شيئاً عن المعاملة، وهذا ما يوضحه الحديث الشريف الذي رواه أحمد، والبيهقي في "شعب الإيمان" حين قيل للنبي -صلى الله عليه وسلم- يا رسول الله: إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار، قيل يا رسول الله: فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. والأثوار من الأقط دلالة مجردة على أن صدقتها لا تساوي شيئاً أمام صدقة المرأة الأولى.
إنَّ ربط إقامة الصلاة بالجنة أو النار في تربية الأبناء هو ربطٌ قاصرٌ، جعل كثيراً من المسلمين يصلون أروع صلاة، لكنهم أقبح الناس في تعاملاتهم مع الناس، وأشنعهم خلقاً، يغشون، ولا يوفون، ولا يلتزمون بأقوالهم، ولا يؤدون أماناتهم في أعمالهم، مفرطون في مسؤولياتهم، ألسنتهم حدادٌ على من خالفهم، كاذبون في أقوالهم، ومع ذلك لا يرون ذلك منقصةً في الإيمان، ماداموا يحسنون أداء صلاتهم، ويؤدون زكاتهم، ويصومون شهرهم بقيامه وتهجده، ويؤدون ويقيمون أركان الإسلام الخمسة قياماً يتباهون به!!!
والأمر نفسه في الحج؛ إذ أكاد أزعم أن أكثر الحجاج يجهلون المعاني الرمزية للحج، فلماذا يطوف الحجاج حول الكعبة سبعاً على عكس عقارب الساعة؟ وهو نفس دوران الأفلاك بل دوران الإلكترون حول النواة. هل الأمر خال من الحكمة، وما دلالة الرقم (سبعة)؟ وهل يقلد الحاج سعي السيدة هاجر زوجة نبينا إبراهيم -عليه السلام- بين الصفا والمروة لإرواء ابنها إسماعيل عليه السلام، أم لذلك بعدٌ إيماني أعمق؟ وما هي دلالة رمي الجمرات، هل تلك الأعمدة لها علاقة بإبليس؟ ما هي معاني الوقوف بعرفة؟ لماذا لبس ثوبين أبيضين غير مخيطين؟!
غياب توليد المعاني الروحية الرمزية من هذه الشعائر أدى لاجترارها، وكذا هو نصيب الحوادث التي نحتفي بها دون أن نتعمق أيضاً في دلالاتها كحادثة الإسراء والمعراج، والهجرة النبوية؛ فالحديث الشائع فيها هو اجترارٌ لا جديد فيه.
وكم لي أن أسعد حين أسمع البُعد الأعمق لمثل هذه الأحداث كمثل ما يقول مصطفى الشنار في "الهجرة النبوية ودولة الفكرة"، من أن "الهجرة تمثل انتصاراً حقيقياً للفكرة والمنهج والشورى والحوار، على الغطرسة والتسلط ومصادرة حرية الإنسان في الإختيار. وبالهجرة تحولت الدعوة لمرحلة المؤسسات ببناء المسجد والسوق، وتحرير مصادر المياه وبناء التحالفات، وبناء الصناعة العسكرية، واكتساب الفنون الحربية الجديدة كحفر الخندق، وتوظيف الجغرافيا، والحرب النفسية في القتال".
لهذا؛ أدرك لماذا لا يكاد المصلي في صلاة الجمعة يرفع رأسه مُتمعناً في خطبة الجمعة، أو غيرها من خطابات المناسبات؛ فالسبب يعود -من وجهة نظري- إلى غِياب رمزية الحادثة نفسها عن التعبير، إلى غياب القراءات المتعمقة التي تكسب الشعيرة، أو الحدث رمزية فهذه هي زبدة الإيمان التي تُحييه وتنير بصيرته، وتزيد من سعة وعيه.
ويتبيَّن لنا أن الإشكالية -كما يراها محمد عبدالفتاح السروري في "النص الديني في الإسلام من التفسير إلى التلقي"- تكمن في "أننا توقفنا عند كل ما قيل لزمن خاص، ولم نعمل على التعرف إلى ما يمكن أن يقال لزماننا. وهو تعرفٌ لا يكون بالتلقي السلبي لما يقوله النص أو الإنصات إلى مدلولاته. إذ إن متغيرات التلقي بين زمن الصدور الأول للنص والزمن الراهن تمنع النص من أن ينطق بذاته كما كان يحدث في زمن نزول الوحي؛ لأنه يحتاج إلى قراءة معاصرة تتحقق من خلال قارئ معاصر، لا تكتفي بالكشف عن معاني النص اللغوية، أو مقاصد الكلام بعد إضافة قرائن تاريخية لظروف إلقاء الكلام وتلقيه زمن الصدور الأول، بل تتقدم خطوة إلى الأمام للكشف عما نحن مخاطبون به وعما هو موجه إلينا".
وبإيجاز أقول: إنَّ على أهل الاختصاص أن يعوا جيداً ما هو حادثٌ في الواقع؛ فالمسألة لا تتعلق بكثرة المصلين في المساجد، إنما بأثر ذلك في واقعهم؛ فتحليل الواقع ينبئ باختلال في فهم الدين نفسه، والتعامل معه كمجرَّد شعائر: الإقدام عليها طريقٌ للجنة، والبُعد عنها طريقٌ لجهنم، دون أن يلقى بالاً للقيمة الروحية، والأبعاد الإيمانية الرمزية لهذه الشعائر والعبادات، لهذا فلا غرابة أن نجد هذا الانفصام الحاد بين العبادات والشعائر، وبين سلوكات الناس وأقوالهم والأفكار التي يحملونها.. فيا عُلماء الأمة عليكم بإدراك ذلك.. كفى تسطيحاً للدين، فما أنتج إلا خفاف العقول الذي حملوا الدين على أسنة الحراب، وعلى أحزمة النسف والتدمير. فوالله إنَّ الدين لأعمق وأسمى من فعل تعبُّدي لا حظَّ لصاحبه منه سوى حركات خالية من المعنى. الإيمان الحقيقي ما نرى أثره في الأرض، في واقع الناس، في قَسَمات الوجوه، في تعاملات الأسواق.. هذا هو الإيمان الأصدق من الازدحام على أبواب المساجد بخواء القلوب الخالية من معنى الإيمان.