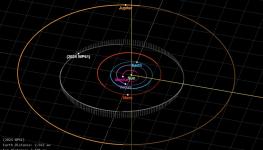د. عبدالله باحجاج
وصل بعضُ الباحثين عن عمل إلى حالتي اليأس والإحباط، هذه حقيقة نعلمها علم اليقين، ولدينا حالات مُؤكدة، لكن لا يُمكننا الجزم بالعدد، بمعنى هل هي ظاهرة أم لا؟ وهذه الحالات ناجمة عن وصولها إلى سن (40) وهي لا تزال في قائمة الباحثين، رغم أنه تتوافر لديها شهادة تقنية من معاهد فنية داخل البلاد، وحالات أخرى شابة، لم تتمكن بشهادة الدبلوم العام (الثانوية العامة) من الحصول على حقها في العمل.
فهل وصلت حالتا اليأس والإحباط إلى فئة الشباب الآخرين الباحثين عن عمل؟ وهل وصل الخوف كذلك إلى الطلبة الجامعيين؟ تساؤلان نطرحهما من منظور الافتراض الاستشرافي للزوم توسيع الآفاق لمسار قضية اليأس والإحباط، وشموليتها، وعوامل صناعتها، ومن يصل إلى هاتين الحالتين، كيف ستكون سيكولوجيته دون أن يكون هناك أفق يرى نفسه في يوم ما في عمل يؤمن له حياة طبيعية كغيره من البشر؟ الغير، يبني أو يحلم بمنزل وأسرة وسيارة وسفر.. إلخ أي أن الأمل لا يزال يلوح لهم في الأفق، مهما كانت التحديات التي تواجههم، وهو يشكل لهم قوة معنوية للصمود في سيرهم الإنساني الطبيعي، بينما هم أي المحبطين واليائسين، حتى مصروف يومهم يتحصلون عليه بصعوبة، وفي حدوده الدنيا، إما من أخوات يعملن كمدرسات، أو من آباء متقاعدين تتزاحم عليهم الأولويات، فلم يعودوا يفرقون بين الأهم والمهم في حياة أسرهم، فهل سيظل التفاؤل ملازماً لمسيرهم في الحياة أم العكس؟ لن يكون التفاؤل في قاموسهم أبدًا، خاصة وهم يشاهدون شباباً من حملة الشاهدات العليا، ومن المبدعين في دراساتهم، في قائمة الباحثين عن عمل ويقضي بعضهم فيها ثلاث سنوات، وحالات أخرى تواجه عراقيل إدارية مُعرقلة، وأخرى محسوبيات تفصل الوظائف بمقاسات دقيقة – لا نعمم – في حسرة دائمة وعميقة للحالمين بفرص وظيفية تنافسية شريفة، نعرف حالات – نكرر حق المعرفة- قد اختفوا عن العامة، وأصبحوا حبيسي غرفهم حتى لا يسمعوا همز ولمز النَّاس، بعد عناء البحث والتعب عن العمل، أصيبوا بيأس تراكمي شديد، تغيَّر معها مجرى حياتهم، ومن صور التغيير، تهاونهم في الصلاة، حتى وصل بعضهم إلى تركها..إلخ وقد ضاقت بهم صدورهم، ولم تعد تتحمل حتى صحوة ضمائرهم الفجائية.. وكلما عاهدوا أنفسهم على العودة للإصلاح والفاعلية، يفشلوا في أول اختبار، ويعودوا للأسوأ، رفيقهم في محبسهم الإنترنت، ورفقة الشيشة في المقاهي أو رفقة الغرف المغلقة في بعض محلات ألعاب التسلية، حتى الفجر، وقد تناولناها أمس الأول في مقالنا المنشور بجريدة الرؤية تحت عنوان،، الغرف المُغلقة، وتأثيراتها على المُجتمع والدولة، قد استبد بهم الخوف، واستسلموا للخطر والوساوس، بسبب فراغ قلوبهم من القوة والإرادة التامة التي تستلزم الفعل، والأخطر هنا، أن هذه التداعيات لن تشغل الباحث نفسه، ولا أبويه، بل يمتد تأثيرها أيضًا إلى بقية الأبناء ومن ثم إلى أبناء الجيران، وأخيرا إلى عموم الشباب داخل المجتمع، سواء كانوا في طور الدراسة أو قائمة الباحثين عن عمل، فوجود شاب باحث عن عمل، يُسبب منذ الوهلة الأولى قلقاً أسريًا، يتحول هذا القلق كلما طال انتظار الباحث في قائمة الباحثين إلى إحباط ويأس للأسرة بكاملها، وكلما انتشر الإحباط واليأس في الباحثين عن عمل، ازداد عدد الأسر المُحبطة، وبارتفاع أعدادها، تصبح القضية، قضية المجتمع بأكمله، وبالتالي، ينبغي أن نتساءل عن مصير المجتمع في ظل انتشار حالات اليأس والإحباط سالفة الذكر؟ وكيف إذا تلاقت حالات الإحباط الأخرى من وقف الترقيات لمدة أكثر من ثمان سنوات... وكذلك حالات عدم الرضا من فرض الضرائب ورفع واستحداث رسوم جديدة، تلاقت مع حالة إحباط الأسر والمجتمع الناجمة عن باحثين يائسين عن العمل؟.
والمثير هنا، تغيب النظرة السياسية عن هذه الحالات، وعن حمولتها، وعن تأثيراتها على مرتبات أولياء الأمور، فهناك اعتقاد سياسي بعدم تأثير السياسات المالية الجديدة – رسوم وضرائب – على الأسر حتى الآن، والسبب تغييب نظرتهم السياسية عن تلكم الخلفيات، وكذلك الخلفيات التي أشرنا إليها في مقالنا السابق المعنون باسم،، معاناة أولياء أمور الباحثين عن عمل،، إنّه موقف تسطيحي لتلكم الخلفيات، وينم عن جهل أو تجاهل بأوضاع المواطنين الحقيقية، وقد قال لنا أكثر من مسؤول رفيع أثناء لقاءاتهم بنا – بناءً على دعواتهم – أين المشكلة لو ساهم المواطن الآن بقليل من ماله في موازنة الدولة بسبب الأزمة المالية؟ وهل تبعات السياسة المالية في واقعها الراهن، وفيما يخطط لها من تصعيد مُقبل، تدخل في مضامين مفردة المساهمة القليلة؟ إنها سياسة تقلب المسير المتعارف عليه، وتؤسس مسيراً جديداً، بتحديات غير مسبوقة تمامًا، لن نتشعب في هذه الجزيئة رغم أهميتها، وكفى بها استدلالا لتوضيح قصور النظرة السياسية في فهم واستيعاب كل التحديات التي تواجه الأسر، وكفى بها استدلالا كذلك على النظرة الفوقية لأوضاعنا الاجتماعية، إنهم ينظرون لأحوالنا كنظرتهم لأحوالهم، وهذا ظلم، يقيسون حجم تأثرهم بالأزمة المالية بحجم أوضاعهم المالية والحياتية الأخرى، وهذا أيضا ظلم، أو لنقل بعبارة أخرى، نظرة غير موضوعية، ولا تنفذ لعمق أوضاعنا الاجتماعية، وتعاطينا مع قضية سيكولوجية الباحث اليائس، وامتداد اليأس والإحباط لأسرته، ومن الأسرة إلى الأسر، ثم إلى المُجتمع، لدواعي التأمل والتَّبصر السياسي في هذا الواقع _ المحدود جداً الآن - واستشراف تداعياته، بغية تحريك الفعل الحكومي باتجاه الانفتاح الإيجابي الأكثر انفتاحا على قضية الحق في العمل، أو على الأقل عدم إغلاق كل أبواب الأمل في الوظيفة.
تظل هذه القضية ملحة الآن خاصة في جزئية عدد فاقدي الأمل في الوظيفة ومسيرة التداعي إلى هذا الواقع المؤلم على المدى القصير والمتوسط، مثلاً، كم العدد الذي ينضم سنوياً إلى قافلة اليائسين؟ وما هي مؤهلاتهم والأسباب الدافعة إلى اليأس؟ علماً بأنَّ غالبية الباحثين عن عمل تتراوح أعمارهم ما بين (25- 29) عامًا، ويحملون شهادات علمية، لعلنا نذكر هنا كذلك بعدد الباحثين عن عمل في صفوف المُهندسين البالغين أكثر من (2000) مهندس عُماني.. إلخ علماً كذلك، بأن مخرجات تخصص الهندسة تصل إلى 4 آلاف و920 مهندسًا عمانيًا سنويًا، وفق آخر إحصائيات وزارة القوى العاملة، ولدى كل طالب على مقاعد الدراسة تخوف مرتفع من عدم استيعابهم لسوق العمل، وينتقل هذا الخوف بالتبعية إلى الأسر... من هنا تكون بداية صناعة اليأس والإحباط، فهل فهمت رسالتنا يا وطن؟ لذلك، لابد من الإسراع بحلول عاجلة وغير تقليدية لحل قضية الباحثين عن عمل، وقد تناولنا في مقالات سابقة رؤى للحل.