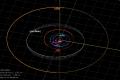سالم الكثيري
أثناء مراجعتي لإحدى الدوائر الحكومية، طلب أحد المراجعين من الموظف أن يبحث له في القائمة إن كان اسم "يافا" محجوزًا أم يمكنه تسجيل شركته بهذا الاسم. أجاب الموظف بأن تسجيل الأسماء "الأجنبية" غير مسموح. هكذا أتت الإجابة سريعة.
لا شك أنّ لهذا الرد أسبابه وقد يكون ضغط العمل وطابور الزبائن غير المنتظم أحدها. هذا إذا أحسنا الظن بأنّ هذا الشاب العشريني وأقرانه يدركون معنى يافا وقريناتها. ولكن يبدو أن الأمر أبعد من هذا بكثير.. فهل يعقل أن يعتقد شاب عربي أنّ "يافا" اسم أجنبي؟
هنا تبادر إلى ذهني مباشرة مقطع يوتيوب للشارع التونسي تسألهم فيها مذيعة تلفزيونية عن موقع دولة إسرائيل فتأتي الأجابة من الجميع رجالا ونساء في مختلف الأعمار واحدًا تلو الآخر وكأنّها متفق عليها بالنص "ما ثماش دولة إسرائيل.. هناك كيان محتل". وهذا ينم عن وعي تام بقضيّة فلسطين ورفض في الوقت نفسه لدولة الاحتلال، وبرأيي لم يتداول مستخدمو وسائل التواصل من المغرب العربي إلى مشرقه هذا المقطع إلا لإثارته جرحا ما كائنا في نفوسهم المضطربة حيث وجدوا فيه ضالتهم التي تجاوزها السياسيون بحكم الأمر الواقع.
والسؤال الملح إذا كان وعي إخوتنا المغاربة بالقضية لازال عروبيا، ماذا تتوقعون معي لو طرحت المذيعة سؤالها علينا في دول الطوق والخليج؟ شخصيا لا أطمح بأكثر من أن يستجمع أحدنا قواه المعلوماتية متخيلا الخارطة في ذهنه ليظفر بإجابة يحدد من خلالها ملء فيه موقع "إسرائيل" دون مواربة أو محاولة حتى لاستعادة تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي إعلاميًا ليستخدم كلمة الكيان المحتل بدلا من إسرائيل حفظًا لماء الوجه كما يقال.
يبدو أنّه لم يقتصر بنا هذا الوضع البائس إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة قائمة بحد ذاتها بل تمادى إلى طمس مدن فلسطين من ذاكرتنا. وفي اعتقادي أنه لولا مشروع التغييب الذي يتضح أنه قد حقق نتائجه المخطط لها، لما غابت عن ذاكرة شبابنا - ونحن معهم من دون شك - مدن مثل يافا وحيفا وعكا والخليل ونابلس ورام الله وغزة والقدس الشريف بطبيعة الحال. هذه العواصم العربية التي كانت محاضن لكل الحضارات القديمة: الكنعانية والآشورية والبابلية والرومانية وغيرها وصولا إلى حضارتنا العربية والإسلامية.
الملاحظ أنّ مشروع التغييب المذكور بدأ في المناهج الدراسية بحيث يتم حذف الدروس التي تتناول القضيّة الفلسطينية كقضية عربية وإسلامية مصيرية لا مساومة عليها تدريجيا من عام إلى آخر حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. إنّ غرس المبادئ يكون من الصغر وإذا لم يتعلم أبناؤنا شيئا عن قضيتهم هذه، فاللوم ليس عليهم ولكننا نحن الملومون بل والمذنبون وفي هذا السياق وتأكيدًا على هذا الأمر أنقل لكم من ذاكرتي صورة ذلك الطفل الفلسطيني الذي يحمل حجرًا في يده ليقاوم به دبابة بني صهيون التي أردته قتيلا غارقا في دمائه والتي لازالت ماثلة أمام عيني إلى هذه اللحظة التي أنسج فيها هذا المقال بخيوط من الأسى والحزن، لم يستسلم خالد بل كان مصرًا على الوقوف في وجه العدو حتى آخر قطرة من دمه الطاهر متوعدا إيّاهم بالنصر وإن طال الزمن..
هل تتخيلوا معي أيّها العرب الأحرار أنني أستعيد هذا المشهد منذ ما يقارب الثلاثين عاما كلما يأتي على مسمعي ذكر فلسطين أو قوات الاحتلال، وأنّ درسا يتيما تلقيته وأنا في الصف الثاني الابتدائي عام 1986م، أصّل في داخلي وأنا طفل في الثامنة من عمري رفض الاحتلال بكافة أنواعه وأشكاله وعدم القبول بغير تحرير القدس، ناهيكم عن نشيد "فلسطين داري ودرب انتصاري" التي طالما رددناها بحماس طفولي منقطع النظير حتى بحت أصواتنا حالمين بأخذ ثأر صديقنا خالد الذي قتله العدو بدم بارد أمام أعيننا دونما شفقة أو رحمة، غير مدركين بعد المسافات وتخاذل السياسات؛ هذا عن جيلنا، ومما لا شك فيه أنّ الجيل الذي سبقنا كان أكثر اقترابا من القضية الأم بل وكان ثوريًا من المحيط إلى الخليج لاستعادة جزء شريف من وطنه المسلوب. ولكن كل هذا تضاءل وتلاشى لتصبح يافا لدى جيل بأكمله في خبر كان وأخواتها. لقد ضاعت العربية.. المدينة واللغة.. ولا عزاء لرواد الفكر والسياسة!.