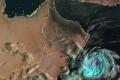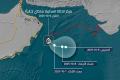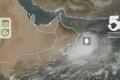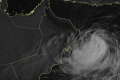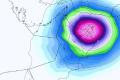أحمد الرحبي
وكأنّ الموت كان غريم الطفولة في تلك القرى والوحش المفترس الذي يتربّص بها، فالأطفال الذين لم يكن ينقذهم من براثنه شيء في وقت لم يكن يملك أهل هذه القرى طريقة لمدافعة شراسته، تملأ قبورهم الأرض وتعم المكان، في المساحة الواسعة من المنخفضات والمرتفعات، حول القرى، يزرعهم أهلوهم المثكولون في التراب تذكارا للفقد واللوعة.
أمام تواصل مسلسل موت الأطفال، مغادرين أحضان أمهاتهم، مخلفين على وجوه الأمهات الصدمة وقسوة وداع أبدي، تلوذ هؤلاء الأمهات المثكولات بصبر وتصميم، على معاودة الكرة المرة تلو الأخرى، للخروج من ثقب إبرة الموت الضيق ولو بمجرد طفل واحد فقط وهو التحدي الذي تمثل المواقع الأمامية في جبهته، المرأة، وحيدة في وجه موت شرس متجهم، يستهدف الحياة، مقتلعا النسغ الذي يمدها بالتجدد والانبعاث، من كل خلية محيلا النسمة الحية إلى تعطل مريع وقاس من الحياة، فبدلا من أن تمضي في مواصلة التقدم والنمو في حياتها، فتتخطى مراحل النمو بذات القوة والعنفوان، للصرخة الأولى للميلاد، تجدها تعود القهقرى إلى الوراء، لتستحيل إلى جثمان يستوطنه الموت وإلى رفات بائسة.
حزام واسع من الأجداث الصغيرة يحيط بهذه القرى ويسوّرها، تمثل آثاره معالم حزينة، للموت كفعل افتراس متواصل للجسد السكاني فيها، كل فصول السنة مفتوحة لضربات منجله، الذي ينزل دون رحمة على أجساد الطفولة البضة، مخلفا في كل بيت حزنا ولوعة، على فقد مبكر متكرر لفلذات الأكباد، الذين لم يتجاوزوا سنة ميلادهم الأولى بعد.. تكرار ممل لقصة قوامها فرحة مجهضة لن تكتمل، تذبل وتموت بسمتها قبل الأوان على شفاه الأمهات المثكولات.
أمام هذا الافتقاد المتكرر الفادح للأطفال، لم يكن دور المرأة بالدور الهين أبدا، خاصة إذا ما تصورنا مشقة ومتاعب الحمل والإنجاب المتكرر، على صحتها والذي تحاول فيه أن تسد فجوة ملعونة، سوداء يخلفها حدث الموت السادر بجبروته،
وقدره المقدر على تلك القرى أشبه بتراجيديا إغريقية أبطالها منذورون للشقاء والمعاناة والانسداد لأي بارقة أمل في حياتهم، فقد كان الموت الحدث الأبرز في حياة السكان، والثيمة الأكثر وضوحا في قصة حياتهم التي يعيشونها كأنما في مأتم متجدد، حزين.. ولادة فموت، يعقبها ويقطع الطريق عليها.
حدة الشراسة هذه التي كان يخلفها الموت، في القرى العمانية مستهدفًا بمخالبه مرحلة عمرية هي الأضعف مقاومة والأكثر هشاشة أمام حتميته وجبروته، مازالت معالمها ظاهرة للعيان، حتى وقتنا هذا في بقايا دارسة لأقبر صغيرة مقارنة بمتوسط طول الإنسان وقامته المعتادة، تنتشر هنا وهناك حول القرى بكثرة، ولا يكاد تمييزها (ماعدا عينا خبيرة، أو عينا بكت لوعة الفقد فوق ذلك الموضع ذاته) سوى بصعوبة فوق أديم الأرض، الذي ظل عرضة للتبدلات الكثيرة بفعل السيول وعوامل التعرية، طوال السنين الماضية.
وينظر إلى آثار هذه الأقبر حاليا في كثير من القرى في السلطنة، بقدسية تحض عليها ربما براءة تلك السن التي قضت فيها تلك الطفولة نحبها، فكثيرًا ما يحدث بأن يصرف النظر، عن الشروع في عمل بناء أو مد طريق لمجرد الشك بوجود جدث لطفل هناك، خشية إزعاج نومته الأبدية البريئة، والتعكير عليه في مرقده البرزخي.. هذه السطور مهداة إلى روح صغيرة رحلت في ذات فجر بعيد، مغادرة أحضان أم أعيتها الحيلة، في استمهالها ليوم جديد في الحياة.