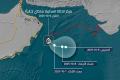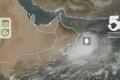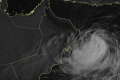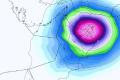جمال القيسي
هل ما يزال في القديم (كل القديم) عزاء وسلوى، أم أن هذا القول تحايل على الألفاظ، كي نأتي أو ندلف من تلافيف الحروف نحو العبارة، التي استهلكت حد الاهتراء؛ الحنين إلى "الزمن الجميل"!
والقديم، الذي أقصده، هنا، ليس القديم الشخصي أو ما يمتد إلى ما قبل ذلك بجيلين أو ثلاثة، بل ما نمر به جميعا من هذه المراحل العمرية الجامحة نحو النهاية، تلح علينا أبهاظ العمر، باعتبار الزمن الذي انقضى جميلا، رغم أنه كان قاسيا ومريرا على أرواح كثيرين ممن ينتابهم الحنين له.
دعوني أوضح أو أطلسم. لا أدري ما الذي يدفعني هذه الأيام إلى ما أنا عليه؛ هل الدافع هو فائض الوقت فقط، أم أن فائض الوقت مع التحايل عليه، هو ما جعلني في هذه الحالة، معبرا عن مرحلة عمرية، أكثر من معنى شخصي.
ولكن رغم عدم الإيمان التسليمي الاستسلامي بعبارة الزمن الجميل، إلا أن غياب قامات إبداعية وفنية وتبدل الزمن علينا، يجعلنا نرنو إلى زمن لم يكن جميلا، بل كان غنيا، ومتفردا، ومتفوقا.
منذ أسابيع وأنا أشاهد، بكثافة، الأفلام المصرية القديمة (قديمة أوي). وحيث أن دوامي ليلي، وينتهي عند منتصف الليل، تقريبا، فإني أعود إلى منزلي وحيدا أعزب صموتا، لا أدري ماذا أفعل من منتصف الليل إلى غروب اليوم التالي. وبالمصادفة ألزمني جانب بحثي في عملي الصحفي بالكتابة عن السينما المصرية ما جعلني أحظى ثانية بمقاطع فيديو على يوتيوب لأفلام أذكر أني شاهدتها على التلفزيون زمااان.
أفلام مصرية خمسينية وستينية، وسبعينية، دفعتني إلى تحميل العديد منها، وادخارها إلى الوقت الطويل، المرتبط بالسأم الجليل، فصرت أشاهد فيلمين كل ليلة، وأحيانا ثلاثة!! مع يرافق ذلك، من جلد للذات على عدم القدرة على القراءة والكتابة. شعور بتأنب الضمير الإبداعي والمعرفي. لكن لابد من الحلم مع النفس، بأن الأفلام معرفة أيضا وقراءة، وثقافة، وإن كانت ثقافة كسولة، إلى حد ما.
وبحكم تقاطعات الجيل القديم، وارتباطاته بتطور الوعي نحو دلالات ونجاح أو عثرات المرئي، فقد ترسخت لدي طقوس في هذه العادة الجديدة، حيث أني أختار الأفلام الأقدم، ما استطعت. ثم أدقق في وجوه الأبطال، وأحسب عمر كل واحد منهم سنة صدور الفيلم، ثم أدقق، بحسب معلوماتي أو عبر أستاذنا، اللامتناهي الذاكرة، جوجل، أحيانا كثيرة، في سنة وفاة البطل/البطلة. وفي العموم، حين يكون الممثل ما يزال على قيد الحياة، أقارن بين صورته في شبابه الجامح، وما آل إليه من بطش الزمن في بنيته وشكله، ولكم تنتابني الحسرة حين أقارن بين وجوه النجمات، فأحزن للراحلات (لا عليهن)، وأتعاطف مع الباقيات اللواتي، أفلت أقمارهن، ونال منهن تعب العمر، وإجهاد السنين.
والحقيقة، أن عكوفي على الأفلام القديمة، بدأ بعد وفاة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وقد حزنت لرحيلها، رغم قلة الأفلام التي شاهدتها لها، لكن ليلة وفاتها، رأيتني أشاهد فيلمها (أيامنا الحلوة)، ووجدتني وفيا لها على نحو ما. وكنت أتابع الفيلم الذي أبدعت فيه، فأحسست أنها تفوقت على القصة والسيناريو والكثير من مفاصل الإخراج. ولربما أنا شغلت عن ذلك كله، بها.
وبقيت أحسب: فاتن حمامة، ولدت عام 1931 وأدت هذا الدور عام 1955 أي كانت في الرابعة والعشرين، وتوفيت عام 2015 أي بعد 60 عاما على سنة عرض الفيلم. ولكن لفتتني عبارة في الفيلم حين تقول لها قارئة الكف: "عودك حيبقى على خضارو لحد القدر ما ياخد مقدارو.. تعيشي ستين سبعين"، فتقول ضاحكة متباهية: "حعيش لما يبقى عندي ستين سنة"!!
هل في كل ما سبق دعوة لاسترداد أرشيفنا الغني، ونحن نصدم كل يوم بأفلام ليس لها من حقيقة الأفلام سوى الاسم، وحتى في الأسماء لكم صارت الأسماء مضحكة مبكية! إن لم تكن مبكية فقط، وتدعو للشفقة!.