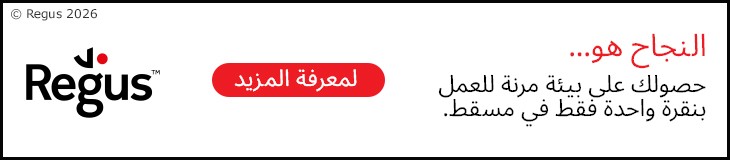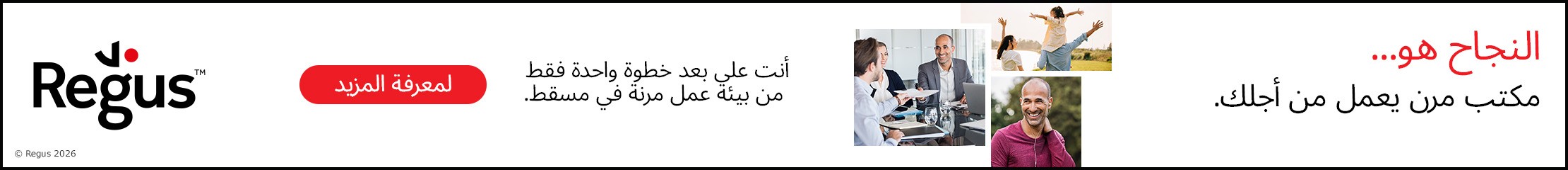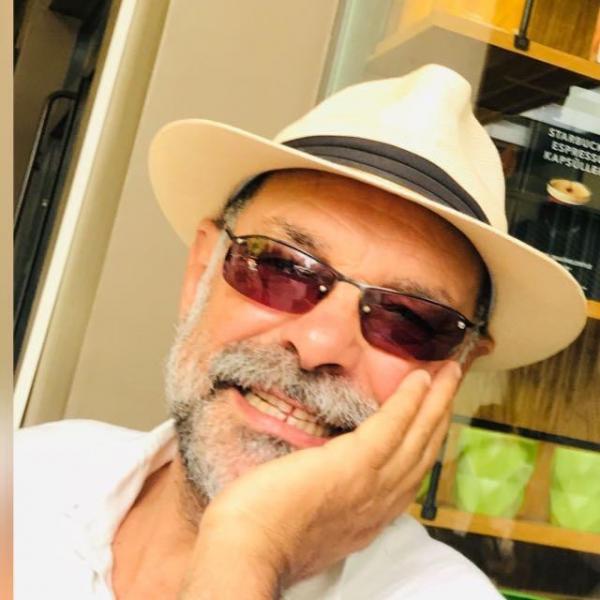د. عبد الفتاح الزين **
أشكر الإخوة العُمانيين على استضافتهم لي في الندوة القيمة التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثلاثين للمهرجان الدولي لسينما المؤلف التي عُقدت في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 نوفمبر 2025؛ هذه الدورة التي تُكَرّم فيها السينما العُمانية كضيف شرف، والشكر موصول لرئاسة المهرجان على هذا الاختيار.
وهي استضافة لي أيضا كرئيس لجمعية الصداقة المغربية العُمانية الفتية التي تأسست بدعم من فضاء الوساطة الهيئة العلمية التي تشتغل كوجيهة أكاديمية بين حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والمجتمع، والتي عملت على تنظيم اللقاء المغربي العُماني الأول حول موضوع "التبادل الثقافي المغربي العُماني: نحو النهوض بالتعاون في مجال الاقتصاد الثقافي"[1]. وقد تم تقديم أعمال هذا اللقاء ضمن فعاليات هذه الندوة.
ولا بُد من الإشارة إلى أن الصرامة العلمية تفترض التدقيق والتمحيص خلال مراحل تشييد المدونة المعتمدة عبر فحص نسقية مكوناتها، ومنهجية التفسير التي تفضي إلى نسق تحليلي له منطق مستقل قدر المستطاع يجتهد فيه المحلِّل إلى حد كبير من أجل الرفع من درجة الموضوعية وسقفها، ناهيك عن التأويل الذي يقدمه كرأي للقارئ قد تختلف حوله مرامي المؤَوِّلين لأن الدراسة العملية تروم تجاوز الظاهري للوصول إلى المعنى الكامن أو الخفي/الثاوي (وعموما في هذا المستوى، يمكننا اعتماد مناهج وتقنيات علم التأويل Hermeneutica خاصة وأننا بين حقلين يتقاطعان من حيث الجوهر ويشتركان من حيث النشأة؛ إذ كلاهما فن: السوسيولوجيا في نشأتها سميت "الفن الاجتماعي Social art"، بينما السينما نعتت بأنها الفن السابع ضمن سجل الولادات الفنية، إلّا أن الأولى اجتهدت من أجل أن تصير علمًا كباقي العلوم؛ بل إنها اليوم، وبفضل الثورة الرقمية التي أفرزتها المعلوميات، أصبحت تخصصاتها الفرعية تقوم على تخوم المعارف لا كتخصص بيني interdisciplinarity ولا حتى كتعددية المحتديات multidisciplinarity؛ بل كتخصصات عابرة للمحتديات transdisciplinarity بمعنى أنها تستَدْمِج مخرجات المحتديات التي تشتغل عليها في احترام لمقوماتها وخصائصها.
ودعوني أشير إلى الضمور - إن لم أقل الهشاشة المعرفية والتي تصل حدّ النُّدرة المعرفية - الذي نلاحظه في تقاطعات الحقلين السوسيولوجي والسينمائي، وأقصد بالذكر "سوسيولوجيا السينما". إنه ليس راجعا فقط لما اعتمده تأويليا الاستشراق عبر قراءة كانت فيها المدونة المعتمدة مشيَّدَة وفق شكلانية منهجية؛ بل كذلك لأن رقابة السوسيولوجي الذاتية كان لها دورها على الأقل في مرحلة ما بعد الحركات الاستقلالية؛ حيث المرحلة الاستقلالية ظلت محكومة بهاجس الاستعمار إلى حد يمكن الحديث عن مرحلة مابعدالاستعمار، وهو ما يسَّر على الشمال العالمي Global North أن يتأسس معرفيا كمهتم بما بعد الكولونيالية دون تقديم نقد ذاتي- على الأقل وفق البرتوكول الثاوي ضمن نصوص إدوارد سعيد- وذلك من أجل تخريب هذا المبدأ الذي لا زال موضوع اجترار ألا وهو مبدأ "تحرير العلوم الاجتماعية من المركزية الاستعمارية/ الغربية Liberating the social sciences from colonial/Western centralism "، والذي لا يزال يراوح مكانه حتى ضمن الهيئات العالمية الأكاديمية[2].
مسألة التجسيم لا تزال تُطل برأسها من بين ثنايا الفكر الإسلامي والذي يظل العربي رهينته بالرغم من أن العربّي ليس إسلاميًا خالصًا؛ بل تعتمل ضمنه مع البعد الإسلامي الديانات السماوية الثلاث على الأقل، ناهيك عن التدامج الحاصل بينهما وبين روافد محلية وسوسيوتاريخية أخرى[3].
وفي سياق التأريخ والتوثيق الذي تناوله الأخ محمد الكندي (المخرج والمنتج) في المجال السينمائي في مؤلفه "تحولات السينما العُمانية (1970-2020)"، ومن خلال عرضه القيِّم "السينما بين عُمان والمغرب رحلة لا تنتهي" الذي قدم فيه رؤية بانوراما للفعل السينمائي في سلطنة عُمان، والذي يمكن اعتباره خطاطة ومادة لمتحف للسينما بعُمان، وكذلك ما تفضل به الأخ قاسم السليمي في عرضه حول مقومات الفيلم العُماني، وما تزخر به السلطنة من إمكانيات طبيعية ومناخية في مجال التصوير السينمائي بما يجعل منها ضمن الخليج قبلة للتصوير وقاعدة مشرقية للصناعة السينمائية يمكنها أن تتكامل مع المغرب والاستفادة من تجربته بل وإغنائها. وبالنظر لاطلاعي على تجارب وأعمال سينمائية لعُمانيات وعُمانيين وكذلك اطلاعي على مؤلفات ونصوص عُمانية في الحقل السينمائي، وبفعل اهتمامي بالكتابة البصرية[4] في العلوم الإنسانية عموما، والسوسيولوجيا والأنثربولوجيا على الخصوص، كأسلوب يعتمد مناهج وتقنيات هجينة في عملية الاستفادة من تقنيات السمعي البصري audiovisual والسينما في معالجة الموضوعات من زاوية سوسيوأنثربولوجية[5]، وبحكم أنني أقمت بعُمان ما بين سنتي 2002 و2006؛ حيث اشتغلت كخبير لدى مكتب معالي مستشار صاحب جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي (مسقط)، وبما أنني لا زالت على تواصل مع عدد من الإخوة والزملاء العُمانيين من بين المثقفين والفنانين والمبدعين العُمانيين والذين كانوا جسر ربط ما كل ما عُماني داخل البلد أو خارجه، إلى جانب أنني أعتبرهم بوابة لي نحو الفضاء الخليجي عموما؛ فإنني ظللت أزور السلطنة من حين لآخر في إطار أنشطة فكرية وثقافية وفنية أو أستقبلهم بعضهم بالمغرب إلى جانب التعاون فيما بيننا؛ سأحاول المساهمة في تسليط الضوء على عدد من القضايا التي لها ارتباط بالسينما إلى جانب ما يقدمه الأخوان محمد الكندي والسينمائي قاسم محمد السليمي، ولكن في امتداداتها السوسيوثقافية والاقتصادية خاصة تلك التي لم يتناولها المؤلف المُشار إليه أعلاه ذي الطبيعة الموسوعية.
إضافة إلى ذلك، سأتقدم ببعض المقترحات في سياق تطوير هذا العمل الرائد للأخ محمد الكندي وما قدمه الأخ قاسم السليمي من أفكار وأطروحات سينمائية ليس فقط على المستوى الوطني داخل السلطنة، ولكن أيضا بين المملكة المغربية وسلطنة عُمان من جهة، ومن أجل إشعاعهما إقليميا ودوليا على اعتبار أن السينما والتعبيرات والممارسات الثقافية والفنية المرتبطة بها قطاعات مهمة في الاقتصاد الثقافي والإبداعي، وكذلك أداة من أدوات القوة الناعمة، خاصة وأن العصر هو عصر الصورة بامتياز ويقوم على كل ما هو رقمي.
وهنا لا بد أن أشير أنني لن أتحدث لا كسينمائي أو كناقد، ولا حتى كمتفرج، وإنما كمتلقي لنصوص سمعية-بصرية يمكن الاشتغال عليها كأي نص يعتمده الباحث كوثيقة وخزان لمعطيات ومعلومات يمكن الاشتغال عليها كمادة للتحليل وكوثائق قابلة للتعبئة في الاستشهاد والتحليل. فالوثيقة السمعية البصرية لم تعد لها وظيفة الشاهدة في النص العلمي والكتابة الأكاديمية في العلوم الاجتماعية عموما والسوسيولوجيا والأنثربولوجيا على الخصوص، ولكنا أصبحت أيضا تقنية كتابة تنتج المعرفة بما تمتلكه من وظائف تواصلية وكفاءات تبليغية، لكنها تعتمد كما باقي المناهج والتقنيات على مدى امتلاك الباحث لمهارات كفيلة بأن تدفع في التلقي والاتصال المعرفي بحدود الموضوعية والحد من ذاتية الباحث، أي الدفع بسيرورة التوضيع (= الوضع في موضوعية) Objectivation process.
وهنا لا بُد من الإشارة إلى أن الثورة الرقمية وما أحدثته المعلوميات من تحولات في التشجير المعرفي، دفعت بإعادة النظر في النص العلمي على أنه رواية علمية scientific narrative (=fiction) (وعلى الخصوص في العلوم الاجتماعية، وبالأخص في السوسيولوجيا والأنثربولوجيا؛ حيث كانت هذه الأخيرة في الطليعة، فيما يتعلق بتشييد التوضيع وتشييد موضوع الدراسة والبحث)، كنقيض للخيال العلمي Science fiction. فلئن كان هذا الصنف الأخير لا يمكن التعامل معه بالكذب أو الصدق (= الخطأ أو الصواب)، فإن الأول يتطلب تقديم معطيات قابلة للتحقيق verifiable data، ناهيك عن سؤال درجة الموضوعية في العمل البحثي، مادامت الموضوعية سراب صعب المنال واجتهاد في تجويد قيمتها.
وفق هذه الخطاطة العامة، سأسترشد بتجربتي العُمانية مع التعبيرات الفنية والثقافية عبر التطرق لأهم المحطات التي عشتها وفق سرد كرونولوجي تحليلي من خلال المحاور التالية:
- توطئة: عبور العتبة
أيام بعد حلولي بمسقط شهر مايو 2002، حضرت معرضا لمجموعة من الفنانين العُمانيين برواق مقر الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية كان موضعه "بين الحياة والموت". شدني الموضوع، وكتبت مقالة تحليلية حوله بخط اليد، ووقعتها باسمي ممهورا بصفة "باحث مغربي مقيم بعُمان". ثم أرسلتها لجريدة الوطن عبر البريد. وقد حملت المقالة عنوان "الدائرة بين الحياة والموت"[6]. لم تمر أيام حتى وجدتني ضمن مجموعة أصدقاء عُمانيين بحثوا عني جرّاء هذا المقال الذي اعتبرته "رسالة موضوعة في قنينة" رميتها في لجاج بحر التواصل من أجل ربط الاتصال. هكذا تعرَّفت على مجموعة من العُمانيين الذين بحثوا عني. تطورت علاقتنا إلى صداقة وطيدة صرنا فيها شلة من بين أفرادها: سماء عيسى الشاعر الإنساني والمفكر ذو النفحة الصوفية العميقة، والفنانين التشكيليين حسن مير الفنان الأنيق المنفتح على العالم رغبة في إشعاع عُماني مع تفكير في خَلف يحمل الرسالة، وأنور سونيا الزاهد في محراب الفن ومساءلة الروح بحثًا عن إنسانية تقتسم التجارب دون مقايضة، ود. عبد المنعم الحسني الفنان والباحث الرصين الذي يشارك ويساهم بكل أريحية دون فرض نفسه. لقد ربطت عبرهم اتصالا بزملاء عُمانيين سبق وأن تعرفت عليهم في المغرب خاصة المرحومين محمد الحارثي المثقف والأديب الصارم والجميل بشغبه الراقي الذي يدفعك لمراجعة مواضعاتك، والذي كنت أمزح معه بالتَّغْيورَة العُمانية حول الحُرث، فيبتسم ممسدا شاربه الخفيف، إلى جانب زاهر الغافري، صاحب البيريه السوداء والذي كنت أدعوه بسليل الشّنفرى، وغالبًا "تأبَّط خيرًا" لابتسامته الدائمة، ولأنه كان يحمل قلبه على كفه.
عبر هؤلاء وآخرون تعرفت كذلك على الأخ حاتم الطائي صاحب دار الرؤيا للصحافة والنشر آنذاك الذي أعتبر جريدته الرؤية نافذة المغرب على الخليج إلى جانب كونها جسرا عُمانيا يحفر مكانا للمهنية الإعلامية التي تمتح من التربة العُمانية، والسوسيولوجي الذي كان من أوائل العُمانيين الذي درسوا بجامعة محمد الخامس بالرباط الصديق د. سعيد الحارثي من الشرقية ... كما تشرفت بمعرفة شباب عُماني وقتذاك، والذين كان من بينهم ناصر المنجي البوهيمي بثقافته وأدبه الجميْن، وكان من أوائل من التقيت بهم. ومحمد الحضرمي الصحفي بجريدة عُمان والمشرف آنذاك على شرفات (الملحق الثقافي) الأديب المتواضع بأدبه وأخلاقه... مع هؤلاء، وأخريات وآخرين ممن لا أتذكر أسماءهن وأسماءهم، غير أنه لا زال هناك تواصل مع من ذكرت إلى جانب الأختين آمنة الربيع الباحثة والمسرحية، وبشرى خلفان الأديبة... وإن لماما.
عبر هؤلاء توسعت دائرة معارفي الخليجية وكذلك معرفتي بدول الخليج التي زرتها. ولازالت الروابط والاتصالات بيننا مستمرة ... بدأت ألتقي مع هؤلاء الأصدقاء الذين اكتسبتهم بعد زوال كل أربعاء عند نهاية الدوام، فيما كنا نسميه "جلسات الأربعاء".
وفق هذه السيرورة، تعمّقت معرفتي وعلاقاتي السابقة بسلطنة عُمان وبدأت أنشطتي الثقافية والفنية؛ حيث ولجت عتبة الصداقة إلى ردهات الفعل. وهنا سأتحدث عن عُمان من خلال كتابتها الفنية عموما والبصرية على الخصوص (الفيديو آرت Vidéo Art، والفن التركيبي Installation Art، ثم السينما) على اعتبار أن الاختلاف بين هذه الأنواع التعبيرية عن الأفكار والقضايا بشكل بصري أو سمعي بصري هو اختلاف صناعي من حيث المدة الزمنية للسرد الفني البصري، وكذلك مسألة سلم وتصنيفات قطاعية أكثر منها اختلاف في جوهر العمل ونواته.
- إضاءة:
ولتوضيح موضوع مداخلتي، وتموقعها النظري/التنظيري في المجال "العربي" ذي الروافد المتعددة والمختلفة وفق السيرورة السوسيوتاريخية والعلاقات الجيوثقافية[7]، واللذين يتناولان في نزوع من التوازي المقارِن للعلاقات بين السوسيولوجيا والسينما ومن خلال تجربتي المغرب وعُمان مع هذا الموضوع ذي الحساسية المعرفية التي تتطلب حسا نقديا وتمكنا إبستيمولوجيا من خلال كيف يستعمل السوسيولوجي الاشتغال السينمائي في "كتابة موضوعه بصريا"؟ وما مكانة البصري في بناء المعرفة، ومدى التحكم في استعمالاته؟ وسأتحدث عن حالتين على سبلي المثال لا الحصر، قد تسعف المهتمين من التقاط وفهم ما نحن بصدده:
- الحالة الأولى:
في أكتوبر 1990، كان هناك لقاء بين غابرييل غارسيا ماركيز Gabriel García Márquez وأكيرا كوروساوا Akira Kurosawa، دام ست ساعات، وذلك بمناسبة تصوير هذا الأخير لفيلمه "منتقيات ملحمية في غشت/أغسطس Rhapsody in August" بمدينة أماكَي-ياكَاشيما Amagi-Yugashima (منذ 2004 أصبحت هذه الأخيرة جزءاً من مدينة إيزو Izu بإقليم شيزيوكا Shizuoka باليابان). وقد نقلت لوس أنجلوس تايمز Los Angeles Times من هذا اللقاء بعض المقاطع[8]؛ إذ صرح ماركيز في البداية "لا أريد أن تبدو هذه المحادثة بين الأصدقاء وكأنها مقابلة، ولكنني ببساطة أشعر بفضول شديد لمعرفة المزيد عنك وعن عملك [...و] منهجيتك في الكتابة".
ويمكن القول بأن التفاعل الذي حدث بينهما كان موضوعه الرئيسي "فن السرد، والسرد البصري مقابل السرد الأدبي"؛ حيث تم التطرق لفلسفة السرد، واقتباس الأعمال الأدبية في صناعة أفلام سينمائية، وطبيعة كل من الفن والحقيقة، ناهيك بطبيعة الحال الحديث حول عواقب الحرب النووية وكيفية نقلها في الكتابة السينمائية والتي كانت موضوع الفيلم. هكذا تمت مناقشة الصعوبات المرتبطة بتحويل الصور الأدبية إلى صور سينمائية والطرق المختلفة لنقل المشاعر والأجواء، كما انتقل تفاعلهما إلى تناول الفن والحقيقة وسيرورة الإبداع.
إنه تفاعل بين عملاقين: أحدهما مخرج سينمائي عمل في شبابه في الصحافة (كيروساوا)، بينما الثاني، روائي عمل كذلك سيناريست، وفي النقد السينمائي ...
- الحالة الثانية:
تواصلَ الفرنسيان: السينمائي الفرنسي جان-لوك كَودار Jean-Luc Godard مع السوسيولوجي بيير بورديو Pierre Bourdieu أثناء تصوير، هذا الأخير، لفيلم "السوسيولوجيا: رياضة صراع La sociologie est sport de combat[9]". وهو نص بصري يختلف عن الفيلم التصويري أو حتى الوثائقي، والذي يثير فيه صاحبه إلى جانب مختلف الذين ساهموا فيه سؤال العلاقات بين السوسيولوجيا والسينما. وهنا لا بد من القول بأن أحد أوجه التشابه بين السوسيولوجيا والسينما هو بروزهما في سياق الثورة الصناعية وارتباطهما الوثيق بالقرن العشرين، بالإضافة على مكانتهما في التسلسل الهرمي النبيل للثقافة والمجتمع: الفن، إذاً، والعلم. ومع ذلك، هناك دائماً إمكانية التشكيك في الطابع الفني للسينما، في حين أن الرسم أو الموسيقى لا تعانيان من مثل هذا التشكيك. وينطبق الأمر نفسه على الطابع العلمي للسوسيولوجيا، مقارنة بما يسمى "العلوم الحقة"، من قبيل العلوم الطبيعية أو الكيمياء على سبيل المثال. وفي هذا الصدد، لا بد من التذكير أن السوسيولوجيا في أولى تعبيراتها الفكرية نعتت بأنها فن اجتماعي Art social/Social Art. وقد كتب كل من ماتيوه لوبيهان Matthieu LE BIHAN وستيفان هايس Stéphane HEAS عن هذا اللقاء[10] ما يلي:
كان جان-لوك كَودار يُحِبّ أن يذكر بتكوينه كإثنولوجي [= علم الأعراق]، ويستشهد على سبيل المثال بمارسيل موس Marcel Mauss بين صورتين. ويذكر بورديو كلمات كَودار: "هذه ليست صورة دقيقة، إنها مجرد صورة". فبورديو وكَودار كلاهما اسمان بارزان كل في مجالهما.
التقى الرجلان بمناسبة عرض فيلم "كَيكَيت Guiguet"، أعقبه غداء بين كَودار وبورديو. لكن الحوار بينهما كان صعبًا؛ إذ اقترح بورديو: "لننخرط معًا في أمور أخرى، في مجالات أخرى". وأصر كَودار بنوع من التركيز "لنعد دائمًا إلى السينما، "المسافرون" هم أشقاء "بؤس العالم"". بالنسبة لأولئك الذين كانوا حاضرين حول هذه الطاولة، كان اللقاء المباشر، الذي اتسم بالدهاء والفضول والدفاعية، "تاريخيًا" بكل ما في الكلمة من معنى. لم يكن هناك شك في التقدير والاحترام المتبادل، ولكن الخوف المتبادل من أن يتلاعب أحدهما بالآخر كان واضحًا أيضًا".
ودون اعتداد بهذا النص المعتمد من المفيد الإشارة إلى أن العلاقة بين السوسيولوجيا والسينما ثنائية الاتجاه: فالسوسيولوجيا مقاربة تحلل السينما كظاهرة اجتماعية وانعكاس للمجتمع، فضلاً عن كونها موضوعاً للدراسة الاجتماعية. وتركز سوسيولوجيا السينما على الإنتاج السينمائي، وتلقي الأعمال، والممارسات الثقافية المرتبطة بزيارة دور العرض وما يرتبط بها من ممارسات، كما أنها تستكشف الأفلام والقضايا الاجتماعية المرتبطة بها موضوعا أو فرجة، وتتأثر بالهوية الاجتماعية والمعايير الثقافية. كما أنها تعتبر السينما وسيلة اجتماعية لفهم المجتمع (من خلال اعتبارها مرآة تعكس القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية).
كلا الحالتين توضحان العلاقة الملتبسة بين السينما والسوسيولوجيا، وهي علاقة التباسها يقعِّدُه مدى الاحتكام إلى تمثل العلاقة التي تضبطهما – اعتمادا لما أشرنا إليه في الحالة الأولى- طبيعة الفن والعلم والحقيقة والتقاطعات بين الكل.
على ضوء هذين الحالتين، كنت عرّاب "مهرجان الفيلم السوسيولوجي" ككتابة سمعية بصرية تعتمد مناهج وتقنيات بصرية تقوم على الوقائع بصرامة، لكن مع الاجتهاد في احترام للكتابة السينمائية واستفادة من كبار مخرجيها ومدارسها. وقد تمت برمجة هذا المهرجان في دورته الأولى ضمن فعاليات المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا الذي انعقد بالرباط من 6 إلى 11 يوليوز 2025. ونحن نستعد للدورة الثانية لسنة 2026. وسيكون على فضاء الوساطة كعضو منخرط في الجمعية الدولية للسوسيولوجيا مواكبة مهرجانات وطنية مماثلة في بلدان أخرى لدعم استعمال المناهج البصرية ضمن الدرسين السوسيولوجي والأنثربولوجي أو ما أعتبره سوسيوأنثربولوجيا لأنهما وجهان لمعرفة متكاملة. ولهذا أسسنا مجموعة سوسيوأنثربولوجيا الشفوي والمكتوب والبصري والتي أصدرت أعمال اللقاء الأول الذي كان موضوعه "مكانة الشفوي، والمكتوب، والبصري في البحث العلمي". وسيصدر قريبا كتاب جماعي تحت عنوان "سوسيوأنثربولوجيا السينما والنقد السينمائي". نروم من خلاله فتح السينما كنص بصري على تقنيات البحث السوسيوأنثربولوجي، ما دامت الثورة الرقمية وتعددية الوسائط le multimédia قد أزالت الحدود بين المحتديات، وساعدت على التغيرات التي يشهدها التشجير المعرفي إلى جانب جعل الاجتهاد في استعمال تقنيات الكتابة الفيلمية[11] في الكتابة السوسيوأنثربولوجية مع احترام ليس فقط لمفهوم السينما عموما، ولكن مع التميز عنها وخصوصا لقواعد التصوير التي تجمع هذا النوع الأخير من الكتابة مع الحف=قل السينمائي بكل مكوناته، وذلك بما يجعل المتلقي يفهم السرد البصري ويلتقط الأفكار المكتوبة وفق تقنيات سمعي-بصرية محتكمة إلى الصرامة المنهجية التي تعتمدها العلوم الاجتماعية، وعلى رأسها كل من السوسيولوجيا والأنثربولوجيا.
- السوسيولوجيا والسينما في سلطنة عُمان: قراءة بانورامية
وفق ما أشرت إليه أعلاه، سأتطرق من منظور بانورامي للعلاقة بين السوسيولوجيا والسينما من خلال نموذجي عُمان والمغرب كمعالم قرائية لتعاون في إطار الاقتصاد الثقافي:
- افتتح قسم علم الاجتماع بجامعة السلطان قابوس (بمسقط) منذ إنشاء كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في 1987. ومع بداية دمج العمل الاجتماعي مع علم الاجتماع في عام 2001 تم تغيير اسم القسم إلى قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي. ومنذ 2023، بدأ التفكير في الانتقال من "علم الاجتماع في عُمان" إلى بناء "علم اجتماعي عُماني". وهنا يمكن للمدرسة المغربية في السوسيولوجيا أن تشتغل في سياق هذا التعاون المغربي العُماني من خلال لقاءات سنعمل على برمجتها وفق الإمكانيات المتاحة والدعم المقدم لنا كهيئة أكاديمية مدنية تعمل في إطار الديبلوماسية العامة.
- وبالنظر لكتاب "تحولات السينما العُمانية 1970-2020" للأخ محمد الكندي، وهو وثيقة تأريخية مهمة ترصد المراحل التي قطعتها السينما كإبداع وصناعة واقتصاد (حتى لا نقول كتجارة) ونشاط سوسيوثقافي في عُمان:
- البدايات: صور تسجيلية عن عُمان والتجارب الشخصية
- السينما كممارسة فُرجَوِيَّة تثقيفية
- السينما كنشاط فني ثقافي:
- الأنشطة السينمائية ذات الطابع الثقافي التكويني
- بداية الإنتاج والتكوين السينمائي الأكاديمي
- نشأة المهرجانات والمشاركة في المهرجانات الدولية
- بروز الجمعية العُمانية للسينما والأدوار الموكولة إليها
وهي تقريبا نفس المراحل التي مرت منها السينما بالمغرب مع اختلاف في الظروف السوسيوتاريخية لكل من البلدين، ناهيك عن القوى الاجتماعية التي كانت حاملة للمشروع السينمائي في أبعاده الفنية والصناعية وحتى الإيديوثقافية؛ حيث تبقى تجربة الأندية السينمائية بالمغرب مرجعا تأصيليا مهما سواء في بعدها الإشعاعي وطنيا (بناء سلم ذوق إلى جانب ثقافة سينمائية)، وإقليميا (مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة) أو دوليا (السينما الثالثة Cinéma3) ... أو في استثمار تركة برنامج "التربية الشعبية Popular education" الذي كان مشتلا للعديد من المهارات الفنية والثقافية قبل أن يتحول بعد 1965 إلى فَلْكلَرة Folklorization للثقافة والفنون في مقاربة تراثية تحنيطية من خلال تحويله إلى برنامج "الثقافة الشعبية Popular culture". فرغم أن المصطلحين يشتركان في صفة "شعبية" إلا أنهما يشيران إلى مفهومين مختلفين:
- فالأول هو منهجية وحركة عمل تهدفان إلى النهوض بالولوج إلى التعلم والمعرفة خارج نطاق النظم التعليمية المؤسسية التقليدية.
- بينما الثاني هو مجال دراسة ومجموعة من الممارسات الاجتماعية. ويُنظَر إليه كذلك ثقافة البوب/ pop culture أي بمعنى أنها ثقافة جماهيرية بالمعنى العصري.
- لازالت العلاقة بين السينما والسوسيولوجيا والمحتديات المرتبطة بها تحتاج إلى المزيد من التجسير والدعم ليس فقط في المغرب وعُمان بل حتى في باقي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (= العالم العربي). وهو ما يجعل سوسيولوجيا (وحتى أنثربولوجيا) السينما ضامرة كتخصص يمكنه أن يدعم النقد السينمائي وحتى الصناعة السينمائية عموما؛ حيث أنها لا تدرّس لا كتخصص قائم الذات أو حتى كمادة أساسية أو تكميلية في التخصصات السينمائية.
وفي هذا الصدد، يمكن تطوير هذه العلاقة من الاستفادة من بعض التجارب المغربية التي لازالت تحتاج بدورها إلى دعم يمكنه النهوض بالاقتصاد الثقافي عموما والمساهمة في الصناعة السينمائية.
- الخلاصات:
وفق هذه القراءة الأولية والاستعراضية لأهم خصائص العلاقات بين السينما والسوسيولوجيا (والعلوم المرتبطة بها) من خلال عُمان والمغرب، يمكننا تقديم الخلاصات الأساسية مبوّبة كالتالي:
- التقاطعات بين السوسيولوجيا والسينما في سلطنة عُمان:
- هناك توازِ بين الانتقال من "علم الاجتماع في عُمان" و"السينما في عُمان" إلى "علم الاجتماع العُماني" و"السينما العُمانية"
- إن الأرضية الخاصة بندوة "بين الحرية والوصاية منظور إليها من زاوية الحرية والرقابة الذاتية" والتي كانت من بين فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي (2018) إلى جانب مخرجاتها تشكل إرهاصا لهذا التحول وهذه العلاقة المطلوبة.
- وبالنظر لسوسيوأنثربولوجيا السينما يتطلب الأمر نظريا وإيديوثقافيا الانتقال من تمثل الهندسة المجتمعية وفق البناء النظري لعلم الاجتماع باعتباره اشتغالا حول المجتمع "كمفهوم مُعطى وقبلي" إلى البناء النظري القائم على السوسيولوجيا باعتبار أن المجتمع "مفهوم يُبنَى وفق الإشكالية التي يشيدها السوسيولوجي في احترام للمقتضيات المنهجية". وهو ما يساعد على تثمين الموارد الثقافية والتراثية بما يساعد على الانخراط السلس في النظام العالمي بشكل فاعل من خلال رفع التحديات وكسب الرهانات.
- وهذا الانتقال، سيوازيه حتما انتقال نحو سينما عُمانية كسرد بصري ذي مقومات فنية أصيلة.
- الاقتصاد الثقافي والسينما كموضوع:
- تشهد عُمان اهتماما كبيرا بالاقتصاد الثقافي الذي تجعل منه أحد أهم دعامات التنمية البشرية، اعتبارا من الاستدامة الثقافية كرافعة في النهوض بمؤشرات التنمية البشرية المستدامة والمندمجة. والسينما في تقاطعها مع العلوم الاجتماعية عموما والسوسيوأنثربولوجيا على الخصوص أحد أهم القطاعات والمجالات لأن العصر عصر الصورة. فالمجتمع الذي لا يتحكم في صناعة صوره، سيعيش صعوبات جمة تجاه الصور التي يضعها الآخرون له.
- من الضروري الإشارة إلى أن الاقتصاد الثقافي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات الثقافية، والتي يعتبر السينما أحد قطاعاتها الرئيسية. بينما الاقتصاد السينمائي يتميز بطبيعته غير النمطية، حيث يتأثر بشدة بمفهوم "الاستثناء الثقافي" الذي يميزه عن القواعد الصارمة للسوق الحرة. فالسينما نشاط اقتصادي مهم مدر للثروة ويخلق وظائف منها المباشر وغير المباشر. كما أن تمويل القطاع يعتمد على مزيج بين منطق التسويق التجاري وغير التجاري.
- التقاطعات بين السوسيولوجيا والسينما في سلطنة عُمان:
- هناك توازِ بين الانتقال من "علم الاجتماع في عُمان" و"السينما في عُمان" إلى "علم الاجتماع العُماني" و"السينما العُمانية"
- الأرضية الخاصة بندوة بين الحرية والوصاية منظور إليها من زاوية الحرية والرقابة الذاتية والتي كانت من بين فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي (2018) إلى جانب مخرجاتها تشكل إرهاصا لهذا التحول
- بالنظر لسوسيوأنثربولوجيا السينما يتطل الأمر نظريا وإيديوثقافيا الانتقال من تمثل الهندسة المجتمعية وفق البناء النظري لعلم الاجتماع باعتباره اشتغال حول المجتمع "كمفهوم مُعطى وقبلي" إلى البناء النظري القائم على السوسيولوجيا باعتبار أن المجتمع "مفهوم يُبنَى بالنظر للإشكالية التي يشيدها السوسيولوجي وفق المقتضيات المنهجية"
- هذا الانتقال، سيوازيه حتما انتقال نحو سينما عُمانية كسرد بصري ذي مقومات فنية أصيلة.
- الاقتصاد الثقافي والسينما كموضوع:
- تشهد عُمان اهتماما كبيرا بالاقتصاد الثقافي الذي تجعل منه أحد أهم دعامات التنمية البشرية، اعتبارا من الاستدامة الثقافية من أهم أدوات تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة. والسينما في تقاطعها مع العلوم الاجتماعية عموما والسوسيوأنثربولوجيا على الخصوص أحد أهم القطاعات والمجالات لأن العصر عصر الصورة.
** سوسيولوجي مغربي
[1] عبد الفتاح الزين (إشراف وتنسيق)، التبادل الثقافي المغربي العُماني: نحو النهوض بالتعاون في مجال الاقتصاد الثقافي. سلسة دفاتر الوساطة، 2025، مقاربات، المغرب.
[2] انظر جوفري بلاييرز Geoffrey Pleyers، الوقائع والصرامة في صميم الأخلاقيات السوسيولوجية. ترجمة عبد الفتاح الزين على الرابط التالي: https://alyaoum24.com/1992953.html أو النص الأصلي على الرابط التالي: https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/executive-committee/presidential-corner-23/facts-and-rigour-at-the-core-of-the-sociological-ethos
[3] انظر ديباجة الدستور المغربي المعتمد منذ سنة 2011؛ حيث هناك اعتراف بالروافد الإفريقية، والمتوسطية، والأندلسية، والعبرية، والحسانية ... على اعتبار أن الهوية المغربية هوية منفتحة، ومتسامحة، ودامجة.
[4] عضو لجنة البحث 75 المتعلقة بما يسمى السوسيولوجيا البصرية ضمن الجمعية الدولية للسوسيولوجيا والمنسق الوطني للهيئة المغربية للسوسيولوجيا.
[5] مؤسس ومسؤول عن مجموعة سوسيوأنثربولوجيا الشفوي والمكتوب والبصري ضمن فضاء الوساطة الذي يرأسه.
[6] نشر بجريدة الوطن، بتاريخ 28 مارس 2002.
[7] أي الجغرافيا الثقافية للمجتمع من مكوناته السوسيوديموغرافية؛ إذ هناك نقط تشابه بين المغرب وعُمان، دون تجاهل نقط الاختلاف والتي قد تفيدهما من خلال تدارسها وتبادل وجهات النظر حولها لبناء مقاربة قد تساعدهما في هذا السياق العولمي الذي يعيشانه.
[8] Los Angeles Times Archives, The Conversation--Kurosawa and Garcia Marquez, June 23, 1991. https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1991-06-23-ca-2154-story.html
[9] يمكن مشاهدة الفيلم على الرابط التالي:
[10] انظر الر ابط التالي: https://www.stephaneheassociologue.fr/wp-content/uploads/2006/06/RS-ACL-2006-15-texte.pdf
[11] الفرق الرئيسي بين السينمائي والفيلمي، هو أن السينما فن وصناعة ومؤسسة ثقافية في مجملها، بينما الفيلم (أو الشريط) يشير إلى العناصر التقنية والجمالية والنظرية التي تشكل فيلماً من بين أفلام أخرى أو الوسيط نفسه. وغالباً ما يتم الحديث عن "وقائع سينمائية" مقابل "وقائع فيلمية".