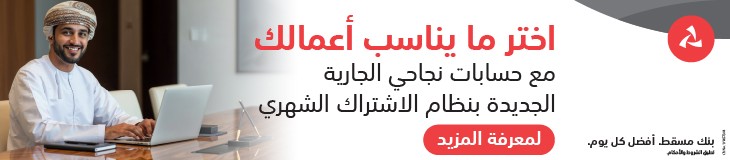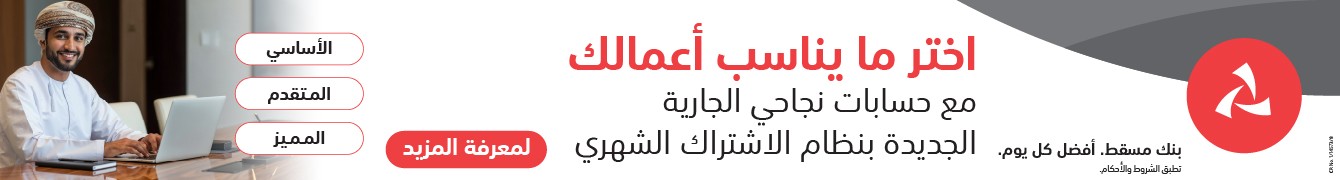تحقيق: ناصر أبوعون
قال الشَّيخُ القاضِي الأجَلّ عِيَسى بِنْ صَالِحٍ بِنْ عَامِرٍ الطَّائِيُّ:[(وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانَا مِنْ مَحَبَّةِ الظُّلْمِ والظَّالِمِيْنَ. وَقَدْ قَامَ بِإِزَالَةِ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الَّتِي بِظَفَارِ السَّيْدُ عَبْدِ الْقَادِرِ الزَّوَاوِيّ، وَطَلَبَ مِنَ السُّلْطَانِ يَمْنَعَ رَعِيَّتَه عَنْ ذَلِكَ فَأَسْعَفَهُ وَخَاطَبَهُمْ خِطَابًا مَعْقُولًا؛ فَأَجَابَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ هَذَا يَوْمُ أَغْرَقَ اللهُ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَّى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقَالَ السُّلْطَاُن: إِنَّكُمْ أَتْبَاُع مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم)، وَلَسْتُمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم)، وَشَرِيْعَةَ مُوْسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نُسِخَتْ بِشَرِيْعَتِه عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ)].
****
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ:[(وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانَا مِنْ مَحَبَّةِ الظُّلْمِ والظَّالِمِيْنَ)]
الفرق بين الحمد والشكر
أنهى الشيخ عيسى الطائي قضية الفتنة الكبرى بين الأمويين وآل البيت بـ[الْحَمْدُ للهِ] وطلب المعافاة. وأمّا (الْحَمْدُ) فهو (مصدر سماعي للفعل "حَمِدَ") دخلت عليه "ال".و"ال": إذا دخلت على الأوصاف وأسماء الأجناس، دلَّت على الاستغراق والشمول والاستقصاء)(01)، (الحمد) الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها، فلو أخبَرَ مُخبِرٌ بمحاسن غيره من غير محبة لها، لم يكن حامدًا، ولو أحَبَّها ولم يُخبِر بها، لم يكن حامدًا)(02)، فـ(الحمد لله): الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى، مع محبته والرضا به، فلا يكون المحبُّ الساكت حامدًا، ولا المُثنِي بلا محبة حامدًا؛ حتى تجتمع له المحبة والثناء)(03)، و(فسَّر بعض أهل العلم (الحمد) بمعنى الشكر، منهم المبرد(04) والطبري(05)؛ وقال الطبري: "العرب تقول الحمد لله شكرًا"، وقال الزمخشري: "(الحمد) إحدى شُعَبِ الشكر"(06). وقوله (لِلَّهِ) اللام حرف جر، وهي تفيد معنى الاختصاص والاستحقاق، ولفظ الجلالة مجرور بها، والجار والمجرور متعلِّقان بمحذوف هو خبر (الْحَمْدُ)، تقديره: مستحق، أو واجب أو ثابت لله. ونعثر على شاهده اللغويّ في شعر أبي جندب الهُذَليّ المشؤوم، يصف مطاردته الأعداء:[لَقَدْ أَمْسَى بَنُو لِحْيَانَ مِنِّي/ بِـ(حَمْدِ اللهِ) فِي خِزْيٍ مُبِيْنِ(07)]. وأمّا قوله: (الَّذِي عَافَانَا) فهو تعبير بالفعل المتعدي، ومعناه: دفع الله عنا السوء والمرض ونحوهما، ونقرأ شاهده اللغويّ في قول عبد الله بن رواحة الخزرجيّ الأنصاريّ:[إِنْ تَسْلَمِي الْيَوْمَ فَلَنْ تَفُوتِي/ أَوْ تُبْتَلِي فَطَالَمَا (عُوْفِيْتِ)(08)].
****
ستة معانٍ للظلم والظالمين
استعمل الشيخ الطائي في تعبيره[عَافَانَا مِنْ مَحَبَّةِ الظُّلْمِ والظَّالِمِيْنَ] المصدرَ الميميَّ (مَحَبَّة)، وجمعه (مَحَابّ)، ومعناه: (التعلّق والمودة والموالاة والمُظَاهرة للظالمين) ومنها قول الله تعالى:{لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ}[المجادلة/22]. وشاهدها اللغويّ نجده في قول عَدي بن زيادٍ العِباديّ:[فُكُلُّكُمْ مِنْ غَدٍ، يَرْعَى (مَحَبَّتَهُ)/ وَلَا يَزَالُ بِأَمْنٍ مُوْنِقًا دَارَا(09)]. و(الظُّلْمِ)، (مصدر) وفعله الثلاثيّ (ظَلَمَ)، وهو في سياق الكلام يتضمن أربعة معانٍ؛ أمّا الأول المعنى الأول (للظلم) فهو(الاعتداء بغير حقٍّ، ومجاوزة الحدّ)، ونقرأ شاهده في بيت شعر منسوب إلى الحارث بن كعبٍ المَذْحجيّ: [وَلَا تَبْدَأُوا بِالْحَرْبِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ/ مِنَ النَّاسِ لِلْعُدْوَانِ وَ(الظُّلْمِ) بَادِيَا(10)]، وأمّا المعنى الثاني (للظلم) فمعناه: (وضع الشيء في غير موضعه). ونقرأ شاهده عند الحارث بن حِلِّزة اليشكري البكريّ، الذي يستنكر فيه أخذ قومه بذنب غيرهم، كما يُذبحُ الظبي بدل الشاة قٌربانًا للصنم:[عَنَنًا بَاطِلًا، وَ(ظُلْمًا)، كَمَا تُعْـ/ تَــرُ عَنْ حُجْرَةِ الرَّبِيْضِ الظِّبَاُء(11)]، وأمّا المعنى الثالث (للظلم) فهو (الميل عن الحق بلا شبهة). و نقرأه شاهده في قول الله - عزَّ وجلَّ -:{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ}(12)، وأمّا المعنى الأخير للظلم في هذا الموضع من مخطوط الشيخ عيسى الطائيّ وفي سياق الكلام فهو الشرك بالله، ونقرأ شاهده في قول الله – سبحانه وتعالى):{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ}(13). وقوله: (الظَّالِمِيْنَ) اسم فاعل، جمع مذكر سالم وجمع تكسيره على صورتين: (ظَّلَمَة)، و(ظُّلَّام)، وهي هنا على ثلاثة معانٍ: أمّا المعنى الأول؛ فهو المائل عن الحق بلا شبهة. وشاهده اللغويّ في قول الله تعالى:{قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ}(14)، وأمّا المعنى الثاني؛ فهو الجائر على حق غيره وجاوز الحدَّ في معاداته. ونجد شاهده اللغوي في قول جبلة بن الحارث وهو يرثي مسعود بن شداد:[جَمَّاعٌ كُلَّ خِصَال الْخَيْرِ، قَدْ عَلِمُوا/ زَيْنُ الْقَرِيْنِ، وَنِكْلُ الظَّالِمِ الْعَادِي(15)]، وأمَّا المعنى الأخير (للظلم) فقد يكون بمعنى المشركين. وشاهده اللغوي في قول الله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ}(16)
****
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ:[(وَقَدْ قَامَ بِإِزَالَةِ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الَّتِي بِظَفَارِ السَّيْدُ عَبْدِ الْقَادِرِ الزَّوَاوِيّ)].
ثلاثة معان في (البِدْعة)
في قول الشيخ الطائيّ (إِزَالَة هَذِهِ الْبِدْعَة)، و(إِزَالَة) بمعنى (صَرْفُ أهلِ ظَفارِ وتنحيتهم عن اتخاذ يوم عاشوراء عيدًا). ونقرأ شاهدها اللغويّ في قول ابن عبّاس:[وَمَا أَقُوْلُ هَذَا أُرِيْدُ صَرْفَكَ عَنْ عَزِيْمَتِكَ، وَلَا (إِزَالَتِكَ) عَنْ مَعْقُودِ نِيَّتِكَ](17). وقوله:(الْبِدْعَة) مفرد، والجمع:(بِدَعٌ)؛ أي: (الاحتفال بيوم عاشوراء). ومعنى (البدعة) في هذا سياق هذا الموضع من مخطوطة الطائيّ جاء على ثلاثة ضروب؛ أمّا الضرب الأول؛ فـ(البِدعة) مصطلح في (أصول الفِقْه)، ويعني (مَا أُحْدِثَ في الدينِ ولم يكُن مما يَشْهَد له أصلٌ شرعيٌّ أو يقتضيه). وشاهدها في الحديث النبويّ:[إنَّه سَيَلِي أَمْرَكُم قَومٌ يُطْفِئونَ السُّنّةَ وَيُحْدِثُونَ بِدْعةً ويُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا. قَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ: وَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُم؟ قَالَ: يَا اِبْنَ أُمِّ عَبْدٍ, لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ. قَالَهَا ثَلاثًا](18)، وأمّا الضرب الثاني؛ فمعنى (البدعة) (الأمر المُحْدَثُ على غير مثال سابق). ونقرأ شاهدها في قول بشر بن أب خازم الأسديّ، يرثي أخاه سميرًا:[أَوْدَى فَلَا تَنْفَعُ الْإِشَاحَةُ مِنْ/ أَمْرٍ لِمَنْ قَدْ يُحَاوِلُ (الْبِدَعَا)(19)]، وأما الضرب الأخير لمعنى (البدعة)؛ فهي (الأمر العجيب المُنْكَر). ونقرأ شاهدها في قول المُثَّقِّبِ العَبْديّ:[أَرَى (بِدَعًا) مُسْتَحْدَثَاتٍ تُرِيْبُنِي/ يَجُوْزُ بِهَا مَسْتَضْعَفٌ وَحَلِيْمُهُا(20)]
****
تاريخ عائلة الزواوي في عُمان
أشار الشيخ عيسى الطائيّ إلى دور (السَّيْدُ عَبْدِ الْقَادِرِ الزَّوَاوِيّ)، وتعاونه مع السلطان تيمور في محاربة بِدْعة الاحتفال بيوم عاشوراء (واتخاذِهِ عِيدًا). والسيد عبد القادر هو أكبر أبناء (السيد الوجيه يوسف بن أحمد الزواوي)، وقد التقاه الصحفي والأديب عبد المسيح أنطاكي خلال زيارته لمسقط 1907م، وتحدث في صحيفته (العمران) عن هذا اللقاء، وهي الزيارة التي طبعتها مؤسسة (ذاكرة عُمان) في كتاب بعنوان (رحلة إلى مسقط) قال فيه: (السيد عبد القادر شابٌ في مقتبل العمر، لم يناهز الثلاثين على ما أظن، وهو نحيلُ الجسم، بشوش الطلعة، تدلك سيماء وجهه على ذكاءٍ ومروءة وشهامة، وقد أثنى عليه مولانا وليّ النِّعَم سمو السيد فيصل ثناءً كبيرًا، وقال إنّه خير شابٍ يؤمّل له التقدم والارتقاء). كما التقاه محمد رشيد رضا في زيارته لمسقط عام 1913 وأشار إلى نباهته وتفكيره في مشاريع تجارية كانت تُعد وقتها رائدة وغير مسبوقة مثل توصيل الهاتف. فقال عنه: (ونجله الكبير الشيخ عبد القادر له ذوق في النظام وميل إلى الصناعة، وقد مَدَّ من دارهم في (سِدَاب) إلى دارهم في مسقط (مسرة تليفون) فكانت هي الوحيدة في تلك القرية). ويُلقب (آل الزواوي بـ(السَّادة) لأنهم من الأشراف الأدارسة وينسبون إلى مولاي (إدريس بن ادريس بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليهم السلام)؛ ومنشأهم المغرب ومهاجرهم مكة المكرمة، ثم دخلوا بلدان الخليج العربي منذ زمن ليس ببعيد ولهم وقف بمكة المكرمة). وقد انحدروا من مكة المكرمة في الحجاز إلى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية في الأحساء وهناك أسسوا عين الزواوي (بئر ماء مشهورة)، واسم (الزواوي) جاء من وجودهم في زوايا الحرمِ المكيّ الشريف حيث أُنِيط لهذهِ العائلة الكريمة شرح مناسك الحجّ والعمرة، وشرحُ آيات القرآن الكريم للحُجَّاج والمُعتمرين، وقد كانت هي العائلة الوحيدة في مكة المكرمة التي يأتي منها (مفتي المالكية) و(مفتي الشافعية)، أما اسم العائلة الأصليّ فهو (الإدريسي الحسني) وارتبط وجود آل الزواوي في عُمان بهجرة جدّهم (الشيخ العالم محمد الزواوي الأحسائيّ الشافعيّ) الذي وفد إلى مسقط في أوائل عهد السيد سعيد بن سلطان (1804-1856) لاجئًا سياسيًا بعض التضييق عليه في موطنه بسبب الخلافات الفكريّة المذهبيّة، فنزل في (حي وَلْجَات) من (حِلَلِ بلدة مسقط)، في بيت صغير لطيف، ورحَّب به أهل المدينة، فأصبحوا من أشرافها وكرامِ عائلاتها، وقد كان السيد سالم بن سلطان يأنس بملاقاة الزواويّ، ويزوره في منزله مع عدد من رُوَّاد مجلسه، كما يُورد ذلك حميد بن رزيق في كتابه (الفتح المبين) وهو المؤرخ الذي عاصر الحدث، وكان مقرّبًا من السيد سالم ومن ندمائه وخاصّته)(21).
****
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ:[(وَطَلَبَ مِنَ السُّلْطَانِ يَمْنَعَ رَعِيَتَه عَنْ ذَلِكَ فَأَسْعَفَهُ وَخَاطَبَهُمْ خِطَابًا مَعْقُولًا)]
السلطان يمنع اتخاذ (عاشوراء) عيدًا
وَ(طَلَبَ) السَّيْدُ عَبْدِ الْقَادِرِ الزَّوَاوِيّ مِنَ (السُّلْطَانِ) تيمور أنْ يَمْنَعَ (رَعِيَّتَه) أهل ظفار (عَنْ ذَلِكَ)، أي عن (بِدْعة) الاحتفال بيوم عاشوراء واتخاذه عِيدًا. وكلمة (رَعِيَّته) مفرد، والجمع: (رَعَايَا) ومعناها: (الجمعُ المَسُوسُ من الناس، المُدَبّر أمرُه). وشاهدها نقرأه في قول عامر بن الظَّرِب العَدْوانيّ، يُخاطِب ملكًا غَسَّانيًّا:[أَيُّهَا الْمَلِكُ، مَا أَحْسَبُ أَنَّ رَغْبَتَكَ فِيَّ بَلَّغَتْكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي مُلْكَكَ، فَقَدْ قَبِلْتُ إِذْ وَلَّيْتَنِي أُمُوْرَ (رَعِيَّتِكَ)، وَقَوْمِكَ](22)،(فَأَسْعَفَهُ) فِعْلٌ مُتعدٍ. ومعناه (ساعَدَه السلطان تيمور وأعانَه) في إقناع أهل ظفار على تَرْكِ بدعة الاحتفال بيوم العاشر من المحرّم واتخاذه عيدًا. وشاهده اللغوي في قول الخنساء:[فَإِنْ (أَسْعَفْتُمَانِي) فَارْفِدَانِي/ بِدَمْعٍ يُخْضِلُ الْخَدَّيْنِ بَلَّا(23)].(وَخَاطَبَهُمْ خِطَابًا مَعْقُولًا)؛ أي:(خَاطَبَهُمْ) السلطان تيمور بلسانه، أي: كلّمهم وخصّهم بالحديث. وشاهد الكلام نعثر عليه في شعر الحارث بن ذبيان، حين كان يفاخر طريف بن العاص، قائلا: [إِيَايَ تُخَاطِبُ بِمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ؟ فوَاللهِ لَوْ وَطِئْتُكَ لَأَسَخْتك(24)]. وكلمة (خِطَابًا) مصدر ومعناه: (القول العادل الحاسم بين الحق والباطل). والشاهد فيه من قول عبيد بن عبد العُزّى السلامي الأزديّ:[فَمَنْ لِلْمَعَالِي، بَعْدَ عُثْمَانَ، وَالنَّدَى/ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، والْجَوابِ الْمُيَسَّرِ(25)]، وكلمة (مَعْقُولًا) اسم مفعول من (عَقَلَ)؛ أي أقام لهم الحُجَّة والدليل العقليّ على فساد بدعة اتخاذ يوم عاشوراء/ العاشر من المحرم عيدًا. و(الخطاب المعقول) يأتي على ثلاثة معانٍ مباشرة؛ أما المعنى الأول لكلمة (معقول)؛ فهو(العقل والفهم السديد)، ونقرأ شاهده اللغوي في قول الشَّمَاخ بن ضرار الذُّبيانيّ:[فَسَلَبْتِهِ (مَعْقُوْلَهُ)، أَمْ لَمْ تَرَيْ/ قَلْبًا سَلَا بَعْدَ الْهَوَىَ فَأَفَاقَا(26)]،وأمّا المعنى الثاني لكلمة (معقول)؛ فهو(مَا يُدرك ويُفهم).ونجد شاهده في قول الخليل الفراهيدي: [والْمَعْقُولُ: مَا تَعْقِلُهُ فِي فُؤَادِكَ(27)]، وأمّا المعنى الأخير لكلمة (معقول)؛ فنجده من مفاهيم علم الفلسفة فـ(المعقول من الأشياء) هو الذي يُعْلَمُ بِالعقلِ لا بِالحِسِّ. ومنه قول ابن البطريق:[عَقْلُ الْفَيْلَسُوفِ يَطْلُبُ عِلْمَ الأَشْيَاءِ الْمَعُقُوْلَةِ(28)]
****
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ:[(فَأَجَابَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ هَذَا يَوْمُ أَغْرَقَ اللهُ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَّى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ)]
أحاديث كاذبة وموضوعة
ويستند دُعَاة (الاحتفال بيوم عاشوراء، واتخاذه عِيدًا) إلى حديث متداول يقول:(إِنَّ هَذَا يَوْمُ أَغْرَقَ اللهُ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَّى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ). وبالبحث في أصل الحديث اتضح أنه مكذوب موضوعٌ على رسولنا الكريم(صلى الله عليه وسلم)، ومن أحكام المُحَدِّثين على هذا الحديث: قال ابن الجوزيّ:(هذا حديثٌ لا يشكُّ عاقلٌ في وضعِه، ولقد أبدعَ من وَضَعَه، وكَشَفَ القِنَاع، ولم يستَحْي، وأَتَى فيهِ المُستحيلَ؛ وهو قوله: (وأول يوم خلق الله يوم عاشوراء)، وهذا تغفيلٌ مِنْ وَاضِعِهِ؛ لأنّه إنّما يُسمى يومُ عاشوراء إذا سبقه تِسعة)(29). وقال ابن كثير:(والمُستغرَبُ ذِكْرُ نُوحِ)(30). وقال مرَّةً:(وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجهِ، ولبعضِهِ شاهدٌ في الصّحيح)(31). وقال الهيثميّ:(رواه أحمدُ، وفيه حبيبٌ بن عبد الله الأزديّ لم يَرْوِ عنهُ غيرُ ابنهِ)(32). وقال ضياء الرحمن: (وفيهِ نَكَارَةٌ في قوله: (وهذا يومٌ استوتْ فيه السفينةُ عَلَى الجُوْدِي فَصَام نُوْحٌ)(33). وضَعَّفَه مُحَقِّقُو (8717)(34).
أوزريس هو فرعون موسى
وقد جانب الصواب قول بعض من المشتغلين بعلم المصريّات من الأكاديميين المحليين والأجانب: بإن (رمسيس الثاني) هو فرعون موسى، وهو كما جاء بالعهد القديم في سفر الخروج أن رمسيس هو الذي اضطهد بني إسرائيل، وأن ابنه (مرنبتاح) هو الذي طارد اليهود، وهو الذي غرق في البحر، وأن جثمان أو مومياء كل من رمسيس ومرنبتاح ما زالتا محنطتين وموجودتين في المتحف المصري، وهذا ما قاله كثير من علماء الآثار المصرية أو علم المصريات، من مصريين وأجانب. وفي كتاب د. سعيد ثابت (فرعون موسى من يكون، وأين ومتى؟ طبعة دار الشروق، القاهرة، 1987). يُوجدُ رأيٌ عِلْميٌ أخر، يستند على الرؤية القرآنية، ومدعومٌ بالوثائق التاريخية؛ فقد أكد(د. سعيد ثابت) بالأدلة أنّ صفات أوزوريس تتفق مع صفات فرعون موسى كما جاء في القرآن الكريم: أولا- إنّ أوزوريس وإيزيس تبنيا طفلًا هو (حورس)، وأنهما التقطاه من اليمّ، أو النيل، وحورس يمثّل الخير كله، ويرمزون له بـ(الصقر)، وتستأنس الدولة المصرية منذ العصر الحديث بحورس المثالي القوي العادل خادم الخير، وهو شبه قريب بالنبي موسى، حيث تمَّ تربيتُه في القصر الفرعونيّ، وهو كان ابنًا بالتَّبَني، ونلاحظ أن الأم إيزيس تُمثل الخير أيضًا. ثانيا - ادَّعى أوزوريس الألوهية اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻨﻔسه، كما ادَّعى فرعون موسى الألوهية. ثالثا – إن أوزوريس ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮك ذوي اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺜﺮاء اﻟﻮاﺳﻊ وﺷﺪة اﻟﺒﺄس، مثل فرعون النبي موسى. رابعا- كان أوزوريس له صفة فرعون اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ في القرآن ﺑـ(ﺬِي الأوتاد). خامسًا- اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺤﺮ ﻓﻲ زﻣن ﻛلٍّ من (أوزوريس وفرعون). سادسا– أن أوزوريس ﻣﺎت غريقًا. سابعًا– لا يوجد أي أثر باقٍ لأوزوريس، ولايوجد له معبد معروف أو تمثال منحوت أو قصر موصوف مُحدَّد المكان والمعالم، وهذا ما تحدَّث عنه القرآن صراحةً في قول الله تعالى: {وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ}[سورة الأعراف، الآية:137]، أي عدم وجود أي أثر لهذا الفرعون.(35)
****
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ: [(فَقَالَ السُّلْطَاُن: إِنَّكُمْ أَتْبَاُع مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم)، وَلَسْتُمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم))].
الفرق بين (أتباع محمد) و(أمة محمد)
وفي قول السلطان تيمور (إِنَّكُمْ أَتْبَاُع مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم)، وَلَسْتُمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) إشارة إلى أن (أمّة سيدنا محمد(صلى الله عليه وسلم) أمَّتان: أمَّة دعوة وأمَّة إجابة، فـ(أمَّة الدعوة) هم كلُّ إِنْسيٍّ وجِنِّيٍّ من حين بعثته إلى قيام الساعة، و(أمَّة الإجابة) هم الذين وفَّقهم الله للدخول في دينه الحنيف، وصاروا من المسلمين، والمراد من (الأمَّة) في هذا الحديث أمَّة الإجابة، ومن أمثلة أمَّة الدعوة قوله(صلى الله عليه وسلم)"والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يَموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتُ به إلاَّ كان من أصحاب النار" رواه مسلم)(36)
****
يقول الشَّيخُ القاضِي عِيَسى بِنْ صَالِحٍ الطَّائِيُّ على لسان السلطان تيمور:[(وَشَرِيْعَةَ مُوْسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نُسِخَتْ بِشَرِيْعَتِه عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ)]
شريعة محمد نسخت شريعة موسى
وفي قول السلطان تيمور، كما نقله لنا الشيخ عيسى الطائيّ-: كلمة (شريعة)، مفرد، وتجمع على (شرائع)، و(شِرَع)، ومعناها: (الطريق الواضح والمنهاج المسلوك). وشاهدُها اللغويّ نقرأه في قول منسوب إلى الحارث بن كعب المَذْحِجيّ يوصي بنيه:[فَمُوْتُوا عَلَى (شَرِيْعَتِي)(37)]، أمّا معناها في (علم أصول الفقه): فتعني (ما سَنَّه الله - عَزَّ و جَلَّ - لبعاده من الدين والمِلّةِ المُتَّبَعَة وجعلَه طريقًا إلى الحقِّ والفلاح). وشاهدُها نقرأه في قول الله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍۢ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}(38). وَقوله:[شَرِيْعَةَ مُوْسَى]؛ أي: (التوراة). و(تختَلِفُ الكُتُبُ المُنَزَّلةُ فيما بينها في تفاصيلِ بعضِ الشَّرائعِ، فمثَلًا شريعةُ عيسى تخالِفُ شريعةَ موسى -عليهما السَّلامُ- في أمورٍ، وشريعةُ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) تخالِفُ شريعةَ موسى وعيسى عليهما السَّلامُ في أمورٍ)(39) قال اللهُ تعالى:{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}(40) (وَشَرِيْعَةَ مُوْسَى نُسِخَتْ) ومعنى (نُسِخَتْ) في اللغة (نسخ الحكم ونحوه: أَبْطَل الْعَمَلَ بِهِ عَلَى حَالِهِ الَّتي أُقِرَّتْ لَهُ أَوَّلًا. وشاهدها اللغويّ نعثر عليه في حديث(نسَخَ الأضْحى كلَّ ذبْحٍ، وصومُ رمضانَ كلَّ صَومٍ، والغُسلُ مِن الجَنابةِ كلَّ غُسْلٍ، والزَّكاةُ كلَّ صَدقةٍ(41)). ومعنى (النسخ) في علم أصول الفقه: مُحيت، ورُفِعَت لَفْظًا أَوْ حُكْمًا. وشاهدها في قول مقاتل بن سليمان الأزديّ: (وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فَرَائِضَ، فَعَمِلَ بِهَا الْمُؤمنون، ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدُ مَا نَسَخَ بِهِ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ، فَحَوَّلَهُمْ إِلَيْهِ، وَقَدْ غَابَ أُنَاسٌ لَمْ يَبْلُغْهُمْ ذَلِكَ، فَيَعْمَلُوا بِالنَّاسِخِ بَعْدَ النَّسْخِ(42)). وفي قوله:[(نُسِخَتْ بِشَرِيْعَتِه عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ)] وفي هذا المعنى قال ابنُ القَيِّمِ: (لا رَيبَ أنَّ الشَّيءَ يكونُ مَصلحةً في وَقتٍ دونَ وَقتٍ، وفي شريعةٍ دونَ أُخرى، كما كان تزويجُ الأخِ بالأُختِ مصلحةً في شريعةِ آدَمَ عليه السَّلامُ، ثم صار مَفسدةً في سائِرِ الشَّرائعِ(43))؛ فقد حرَّم اللهُ على اليهودِ أُمورًا ثم جاء عيسى - عليه السَّلامُ - فأحَلَّ لهم بعضَ ما حُرِّم عليهم، ثم جاءت الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ – شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم) الخاتِمةُ لِتَكونَ القاعِدةُ العامَّةُ: إحلالَ الطَّيِّباتِ وتحريمَ الخبائِثِ. قال اللهُ تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ(44)}؛ قال البيضاويُّ: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ مِمَّا حُرِّم عليهم كالشُّحومِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ كالدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ، أو كالرِّبا والرِّشوةِ. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ويخَفِّفُ عنهم ما كُلِّفوا به من التكاليفِ الشَّاقَّةِ؛ كتَعيينِ القِصاصِ في العَمْدِ والخَطَأِ، وقَطْعِ الأعضاءِ الخاطئةِ، وقَرْضِ مَوضِعِ النجاسةِ. وأصلُ الإصرِ: الثِّقْلُ الذي يأصِرُ صاحِبَه، أي: يحبِسُه من الحِراكِ لِثِقلِه(45))
****
المصادر والمراجع:
(01) انظر: "جامع البيان" (1/ 138)، "المحرر الوجيز" (1/ 63)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 133)، "مجموع الفتاوى" (1/ 89)، "البحر المحيط" (1/ 18)
(02) انظر: "مجموع الفتاوى" (8/ 378).
(03) انظر: "الوابل الصيب من الكلم الطيب" (ص88)
(04) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 133).
(05) انظر "جامع البيان" (1/ 135 -138).
(06) انظر: "الكشاف" (1/ 7).
(07) ديوان الهُذَليين، تحقيق: أحمد الزين وآخرين، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1995م، 3/90
(08) ديوان عبد الله بن رواحة، تحقيق: وليد قصَّاب، دار العلوم، الرياض، مطبعة المتوسط، بيروت، ط1، 1981م، ص: 154
(09) ديوان عدي بن زيد العِبادي، جمع وتحقيق: محمد جبار المعيبد، شركة دار الجمهورية، بغداد، 1965م، ص: 54
(10) شعراء مَذْحَج في الجاهلية، صنعة: مقبل التام عامر الأحمدي، مجمع اللغة العربية السعيدة، صنعاء، ط2، 2014م، ص:446
(11) ديوان الحارث بن حلزة اليشكريّ، صنعة: مروان العطية، دار الإمام النووي، دمشق، دار الهجرة، دمشق، بيروت، ط1، 1994م، ص: 71
(12) سورة النمل، الآية: 14
(13) سورة الأنعام، الآية: 82
(14) سورة الأنعام، الآية: 33
(15) كتاب الأمالي، 2/359
(16) سورة الشورى الآية: 8
(17) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد(ت، 656هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء التراث
(18) الراوي: عبدالله بن مسعود، المُحَدِّث: الذَّهبي، المصدر: المُهذَّب في اختصار السنن، ص أو رقم: 2/1061، خلاصة حكم المُحَدِّث: إسناده صالح، أخرجه ابن ماجه (2865)، وأحمد (3790) باختلاف يسير، والبيهقي (5542) واللفظ له.
(19) ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي/ تحقيق: عزة حسن، وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ، دمشق، 1960م، ص: 126
(20) ديوان المثقب العبدي، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، 1977م، ص: 253
(21) تاريخ عُمان، السيد يوسف الزواوي إحدى الشخصيات العُمانية البارزة، إعداد/ د. محمد بن حمد العريمي، صحيفة أثير الإلكترونية، December 29, 2019 at 7:32PM/ https://www.atheer.om/archive/513908/
(22) كتاب المعمّرين، أبو حاتم السِّجستانيّ(ت، 255هـ)، تحقيق: إيغناس غولد زيهر، مطبعة بريل، ليدن، 1899م، ص: 52
(23) الأمالي، أبو علي القالي (ت،356هـ)، تحقيق: محمد عبد الجواد الأصمعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1975م، 1/ 103
(24) الأمالي، أبوعلي القالي(ت، 356هـ)، تحقيق: محمد عبد الجواد الأصمعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1975م، 1/103
(25) منتهى الطلب من أشعار العرب، جمعه: ابن ميمون البغداديّ(ت، 597هـ)، تحقيق: محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، ط1، 1999م، 8/292
(26) ديوان الشماخ بن ضرار، تحقيق وشرح: صلاح الدين الهادي، دار المعارف، القاهرة، 1968م، ص: 261
(27) كتاب العين، الخليل الفراهيدي(ت، 175هـ)، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، القاهرة، د.ت. 1/159
(28) أجزاء الحيوان، أرسطوطاليس، ترجمة: ابن البطريق(ت، 200هـ)، تحقيق: وشرح: عبد الرحمن بدويّ، وكالة المطبوعات، الكويت، 1978م، ص: 47
(29) الموضوعات، لابن الجوزي (2/ 201)
(30) البداية والنهاية (1/ 273)
(31) تفسير ابن كثير – ط العلمية (4/ 281)
(32) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (3/ 184)
(33) الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (4/ 719)
(34) مسند أحمد (14/ 335 ط الرسالة).
(35) رؤية بحثية قرآنية لفرعون موسى، د. علي أبو الخير، مجلة المعارف الحكمية، معهد الدراسات الدينية والفلسفية، لبنان، بيروت، https://maarefhekmiya.org/quranic-vision/
(36) فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله، عبد المحسن البدر، دار ابن القيم، الدمام، السعودية، ط1، 2003م، ص: 130
(37) التذكرة الحمدونيّة، ابن خلدون (ت، 562هـ)، تحقيق: إحسان عباس وبكر عباس، دار صادر، بيروت، ط1، 1996م، 3/341
(38) سورة الجاثية، الآية: 18
(39) الرسل والرسالات، عمر الأشقر، ص: 250، رسائل في العقيدة، ص: 290.
(40) سورة المائدة، الآية: 48
(41) الراوي: علي بن أبي طالب، المُحَدِّث: محمد الأمين الشنقيطي، المصدر: أضواء البيان، ص: أو رقم: 5/669، خلاصة حكم المُحدث: ضعيف، أخرجه الدارقطني (4/279)، والبيهقي (19491) واللفظ لهما، وابن عدي في (الكامل في الضعفاء) (6/386) باختلاف يسير.
(42) تفسير مقاتل، مقاتل بن سليمان الأزديّ(ت، 150هـ)، دراسة وتحقيق: عبد الله محمود شحاته، مؤسسة التاريخ العربيّ، بيروت، ط 1، 2002م، 2/200
(43) يُنظر: إغاثة اللهفان، 2/ 1102
(44) سورة الأعراف، الآية: 157
(45) يُنظر: تفسير البيضاويّ، (3/ 37)