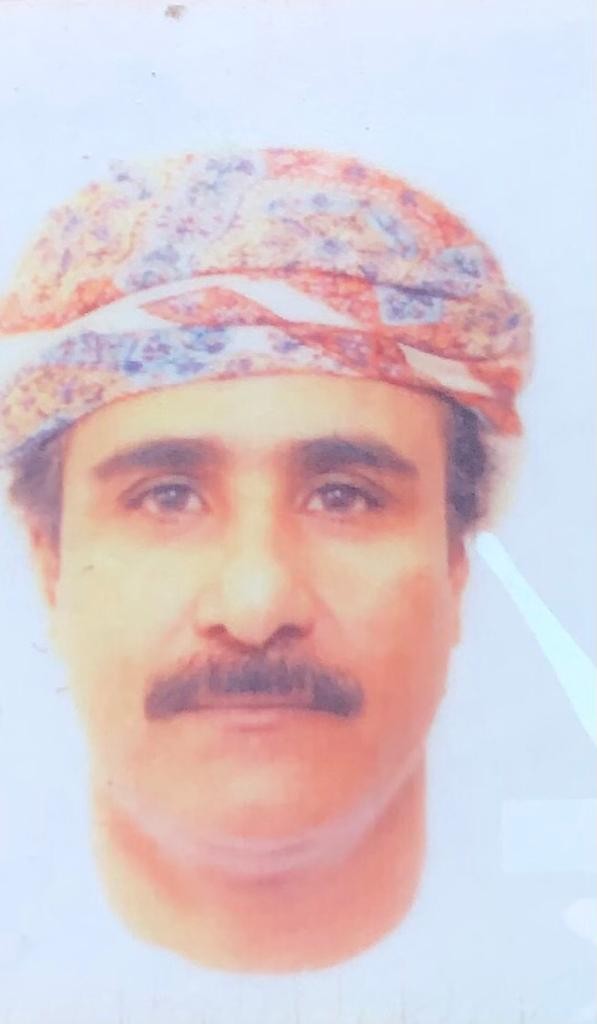مسعود أحمد بيت سعيد
لا تحتاج الحقائق الملموسة إلى براهين للتدليل على إفلاس مشروع الدولة الريعية في كل الإقليم، التي استنفدت أغراضها ولم يعُد لديها ما تُقدمه سوى المكابرة وعدم الاعتراف بالفشل.
إلى أي حد يمكن استمرارية ذلك في ظل التحديات الراهنة؟ وإلى أيِّ مدى البدائل واضحة والرهان عليها مجدٍ؟ ومن الذي بمقدوره تجاهل آثارها ومسايرة انعكاساتها؟
إذا عدنا بالذاكرة قليلًا إلى الوراء، سنكتشف دون عناء أن القوى الوطنية في المنطقة التي كان طموحها كبيرا حينها قد فرضت على الأنظمة وحلفائها تحت ضغط اللحظة التاريخية وحرارة الاشتباك السياسي الإسراع في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي دون استراتيجية علمية بعيدة المدى. وقد أوجد ذلك شريحة طبقية تسللت تدريجيًا إلى مفاصل الدولة الحديثة النشوء، وأصبحت جزءًا من تكوينها الذاتي، وتضع أمام إمكانية التصحيح والتقدم الاجتماعي تعقيدات إضافية تحولت إلى عائق حقيقي؛ حيث خلقت "ميكانزم" خاصة تستولد شروطا موضوعية تعيد إنتاج ذاتها باستمرار. فقد خلقت رعاية تلك الشريحة وقائع وعادات وأنماطا حياتية وعلاقات أبوية، مستعصية على الإفلات منها بيسر. لاحقًا وجدت السلطات- في دول الخليج نفسها بوعي أو دون وعي أسيرة إستراتيجية حماية شريحة طبقية محددة تغلب مصالحها على حساب الوطن، وقد جاءت الأزمات الاقتصادية التي وضعتها وجهاً لوجه أمام معضلات جدية لم يعد بالإمكان التهرب منها أو تأجيلها.
والآن توجد فرصة لمراجعة صادقة وجريئة وشفافة وهي جارية إقليميا بدرجات متفاوتة. فقد وضعت العهود الجديدة أمام محك عملي لا تحسد عليه، وبما أن المجتمع يعيش في حقيقته تحولات اجتماعية بسبب غياب تعبيراته الاجتماعية والسياسية فإنَّ السلطة بالضرورة منحازة لهذا الطرف أو ذاك.
وإلى أن يتضح ذلك للجميع، سيظل هناك هامش معقول لإظهار أنها تقف على مسافة واحدة من الكل وستظل اجتماعيا مطالبة بتقديم الشواهد العملية في التوظيف والخدمات العامة. ولا شك أن الشريحة الطبقية التي نمت في أحشاء السلطة مستنكفة عن تحمل مسؤولياتها وعن إشاعة مناخ إيجابي في هذه المرحلة في محاولة اعتراضية على مسارات التصحيح الواضحة وإن كانت غير كافية، وهو ما يعكس المستور من مكنونات الغضب وعدم الارتياح وهي لا تخفي امتعاضها والتشكيك في المستقبل، وإن كانت لم تفقد الآمل بعد في لفتة حنونة، وتعيش صراعا داخليا وتناقصات حادة.
إنَّ استمرار هذا الوضع قد يضر بشرايينها وقلبها المعتاد الرقة واللطف والحنان والمكرمات السخية التي خلقت منها وجاهات اجتماعية تعيش على مأدبة المجتمع، بينما كل الشرفاء والمخلصين الذين قدموا كل شيء في سبيل الوطن بصرف النظر عن ملاحظاتهم على السياسات العامة اتفاقًا واختلافًا والذي هو أمر طبيعي في مجتمعات قائمة تاريخيًا على الاختلاف والاجتهاد وتعدد الآراء من على قاعدة وطنية ثابتة وهي ظاهرة حميدة دعونا وندعو إلى استمرارها وتنظيمها وإنضاجها وتغطيتها بالحماية الدستورية والقانونية حتى ترتقي بالأداء الوطني الشامل. وستبقى مسؤولية الدولة على الدوام أكبر من رعاية شريحة طبقية. والسؤال الجوهري ماذا أخذت وماذا قدمت هذه الطبقة للوطن؟ سيبقى هذا السؤال مطروحا ومفتوحا. البرجوازية العالمية تاريخيا ورغم كل عيوبها وجشعها وطغيانها ساهمت في عمليات التحديث والتطوير أقلها في مشاريع البنى التحية من أجل تسهيل بضائعها إلى الأسواق العامة ..أما البرجوازية في بلدان العالم الثالث فهي طفيلية تعيش على ما تقدمه الدولة من تسهيلات وهي بالطبع ملحقة بالرسمالي العالمي ولا تملك أفقا وطنيا، وتبدو بحاجة إلى ضمان اجتماعي.
كم نحن بحاجة إلى رؤى جديدة واضحة قادرة أن تفتح نوافذ الأمل أمام الأجيال القادمة ولا تكون على حساب المعدمين، وما لم نمتلك الشجاعة الأدبية لممارسة نقد جاد للتجربة الماضية بكل ما فيها سلبًا وإيجابًا بحيث لا تُقيّد أحلام المستقبل بمراعاة أخطاء الماضي، سنبقى ندور في الحلقة المفرغة.
إنَّ التجارب البشرية ليست مقدسة ولا منزهة وليس هناك عمل بشري خاليا من الشوائب والأخطاء.