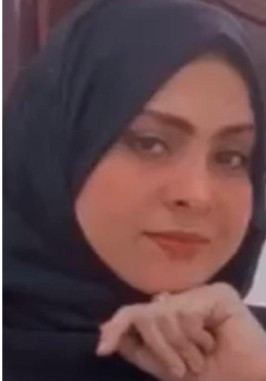سعيدة بنت أحمد البرعمية
لعلّ أبرز تعريف للثقافة هو ما وصل إليه إدوارد تايلور، مؤسس علم الأنثروبولوجيا الثقافية، في كتابه "الثقافة البدائية"؛ يث عرفها بأنها "تلك الكلّية المعقّدة التي تشمل المعرفة، والفن والأخلاق والإيمان والقانون والعادات، وأي قدرات أو عادات يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع" وهو التعريف الأكثر شمولية.
إنّ الثقافة لا تعني الحصول على قدر من المعرفة فحسب؛ بل هي بقدر الإلمام والاكتساب من ذلك من الكل المعقد الذي أشار إليه تايلور، فالثقافة لا تُقاس بحجم التحصيل العلمي والأدبي واقتناء الكتب ورصّها في الأرفف والزوايا، ولا بعدد الكتب التي تم تصفحّها كمجلاّت وحسابات الأزياء والأخبار الرياضية، دون أنْ تتحقق الشمولية من الكلّية التي يرمي إليه تايلور: "فالمثقف هو من يحمل الحقيقة في وجه القوة"، وهذا ما أشار إليه نعوم تشومسكي، أيّ أنّ دور المُثقف فعّال في إبراز الحقيقة؛ فهو على قدرٍ عالٍ من الوعي والإدراك الذي تجاوز تخصصه ومهنته وأرتقى به من كونه مُتعلّما أو مُهنيّا، إلى كونه مُؤثرا ومُقوما للسلوكيات وحل المشكلات المجتمعية، من خلال قدراته التي تؤهله على التفاعل مع الأفكار والثقافات المختلفة، لصنع اتجاه راشد يؤثر في اتخاذ القرارات.
أين أنا من هذا التعريف؟
ما زلتُ أربط معنى الثقافة بكمية الكتب التي قرأتها، فأجتهد كثيرًا في جمع الكتب وترتيبها بشكل أنيق، وجعلها خلفية لمزهريتي وأكواب قهوتي، التي أُجيدُ اقتناءها عند كلّ زيارة لمحلات بيع الأدوات المنزلية؛ فأشكالها وألوانها تجذبني وتسحر أنظار متابعيَّ فينبهرون بذوقي.
تعددت شخصياتي وتلوّنت كألوان ثيابي، كما اعتدت أنْ أرتدي النرجسية، كلما جلستُ بين الناس، وأميلُ أنْ أجعلُ أحاديثي فلسفية، وملامحي ونظراتي تتحد معا، لتُوهم من حولي أنني على قدرٍ من الثقافة!
ولكن تفاهاتي كانت تخونني؛ فأجد نفسي بعض الوقت خارج نرجسيتي المُبتذلة، قبل أن أُكمِل التمثيلية، فألوم نفسي وقد لا ألومها أحيانا؛ لخلو المجلس في ذلك اليوم من المثقفين الذين رضعوا الثقافة.
مرّت السنوات ومازلت على هذا الحال؛ فالربع الخالي الذي أحتويه أصبح بحجم الصحراء الكبرى، يزداد عمقا ويلتهم ما بقي مني كتمساح شَرِه، تزداد شراهته كلما اقتنيت كتابا جديدا ليُكمل الخلفية.
تحاملتُ على نفسي ذات يوم وحاولتُ أن أقرأ شيئا، فذهبت إلى المطبخ وأخذت كوباً بشكل هندسي مُلفت وأردت أن أجهز قهوتي؛ مجاراة لطقوس القراءة والكتابة التي يتحدث عنها المثقفون، ثم جلست على أريكة مريحة في زاوية هادئة كما يفعلون، وصورت القهوة مع الكتاب في ذلك الركن الهادئ، وبدأت أرتشف القهوة وأتصفح الكتاب من صفحة إلى أخرى حتى وصلتُ النهاية، ختمتُ السيناريو بتغريدة على تويتر مضمونها "أنهيتُ قراءة رواية "دون كيشوت" للأديب الأسباني ميجيل دي ثيربانتس، لقد كانت الرواية ممتعة وعميقة، أنصح بقراءتها".
تلقيتُ بعدها مزيدًا من اللايكات على التغريدة، وبعض التعليقات حول الرواية، التي بدوري لم أفهمها؛ لذلك تجاهلتُ كلّ التعليقات، بحكم انشغالي، فلا وقت لدي لَّلردّ على أحد، يكفي أنني صورتُ أول عمل روائي في العصر الحديث، وأضفته إلى قائمة الكتب العالمية التي تشدّقتُ بقراءتها!
الحقيقة أنَّ تلك الرواية أثقلُ كثيراً منيّ، ففكري البالوني، لم يستطع أنْ يستوعب فكرتها؛ لكنّي قرأتُ أسفل التغريدة تعليق لأحد المتابعين الوهميين، يمدح الرواية وأنها تحكي حكاية رجل أراد أن يكون فارسًا مثل الفرسان، الذين قرأ عنهم في الكتب، فارتدى درعًا وأطلق على نفسه اسم "دون كيشوت"، لكنه لم يجد الأشرار الذين يجب مُحاربتهم؛ فتخيّل طواحين الهواء وحوشًا وقام بضربها!
وأشار إلى أنَّ هذه الرواية يُضرب بها المثل لمن يُحارب في الاتجاه الخاطئ، أو يتوهم أنَّه على حق؛ فيبدو بفعلته تلك كأنه يُقاتل طواحين الهواء.
حاولتُ ألاّ أكثرث للتعليق؛ بالرغم من أنه غثّني، وأشعرني أنّ هذا المغرّد لا يعلم حقيقة الرواية فحسب؛ إنما يعلم حقيقة ثقافتي الخاوية، التي تخلو ممّا توصل إليه تايلور وتشومسكي.