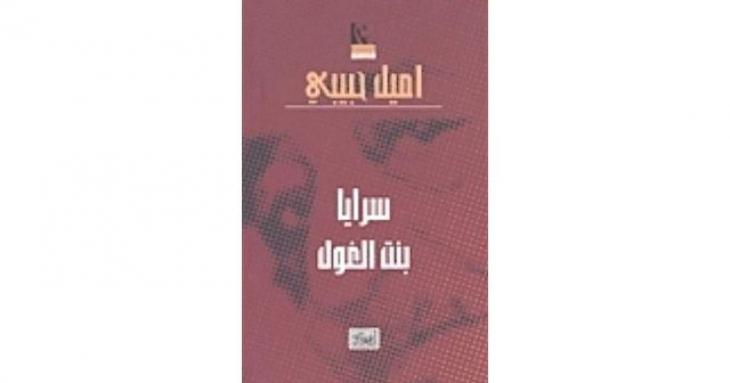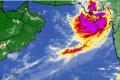أ.د. يوسف حطّيني | ناقد وأديب فلسطيني بجامعة الإمارات
لقد كانت سرايا في طفولة السارد أكثر قدرة على الفعل، وظلّت كذلك حتى بعد مرور خمسة وثلاثين عاماً من غيابها، في حين أنّ عجزه ظلّ يتنامى، ويزداد تردده، فلا يستطيع حتى أن ينادي عليها، حين يراها عند الصخرة، فيعقد السيف الضوئي لسانه، ويمنعه من الكلام. وعلى النقيض من ذلك فقد سمع صوتها عندما لوحت له تلويحة الوداع، بينما بقي هو على عادته في التردد:
"ونطقت العاصفة تناديه: بيا يابا .. يابا.
ورآها، آخر ما رآها، واقفة وسط الوادي، تلوّح له تلويحة الوداع"، ص58.
لقد اتّخذت سرايا الخطوة الأولى دائماً، وتردّد السارد عند الخطوة الأخيرة دائماً، حتى إنه لم يسع إلى الشبح الذي خُيل إليه أنه "أقعى في حفرة ماء صخرية واقعة ما بين رمل الشاطئ وصخرته. لم يستقر الضوء سوى برهة، ثم تركه والظلام الدامس وتلك الحفرة"، ص43. وهو في عجزه وتردده مؤمن بالحل الخارجي، الماورائي، حالماً بحياة أخرى يستمد منها الأمل، معرباً عن ذلك بقوله: "ولا أتخيّل الموت يأتيني قبل أن تأتيني سرايا لعلنا نتفق على لقاء، في الدورة القادمة، أطول مدى من فراقنا في هذه الدورة"، ص59، بينما تجتهد سرايا في تأكيد الحلّ الواقعي، أي العمل من أجل تحقيق الحلم عبر الصمود والتشبث، لأنها غير مشغولة بماورائياته التي تفترض العجز عبر إسناد فكرة الأمل إلى قوة غيبية:
"ـ وأنا؟
ـ وجدتُكَ تنتظرني في مينا حيفا.
ـ كيف رجعتِ؟
ـ وليه أنا رُحت؟ اللي يروح، يابا، لا يرجع"، ص115.
خامساً ـ الأسلوب الروائي:
تترجّح هذه الخرافية بين نوعين من أنواع الرواية، ومن السذاجة إخراجها من روائيتها، بتسويغ أنّ الكاتب أطلق عليها اسم "خرّافية"، فهي تشبه من جهة الرواية الأسطورية؛ إذ تعتمد في بيتها الأساسية على أسطورة فلسطينية ذائعة الصيت، وهي تشبه من جهة أخرى الرواية السيرية، كون كثير من محاورها يتناول إزاحة الستار عن فصول حياة إميل حبيبي نفسه. ويشار هنا إلى أن الحِرَفيّة التي يمتاز بها الروائي مكنته من الابتعاد عن البناء الأسطوري الموازي للأسطورة ذاتها، وعن رواية السيرة التي تسبغ السرد عادة بطابع شخصي؛ إذ انتصرَ لروائية السرد على حساب تاريخيته، على نحو ما فعل واسيني الأعرج في سيرة المشتهى التي تعدّ بحقّ نموذجاً متوهّجاً للرواية السيرية.
يسرد هذه الخرافية سارد أساسي، هو صاحبها، أو صاحب السيرة لا فرق، ويستعين للتمويه والتنويع في بعض الأحيان بالفعل قال، أو يستغني عنه؛ ليحدّثنا عن فصولها التي تتوالى على شاطئ قرية الزيب؛ حيث ما يزال طنين الحروب الستة يملأ أذنيه، وما زالت آثار الدمار تملأ عينيه، وصورة سرايا تملأ قلبه وعقله وروحه.
ويقترب الأسلوب الروائي من التراثي من خلال تراكيب وألفاظ تعود بنا إلى عصور سالفة، دون أن ينسى العودة بين حين وآخر إلى اللهجة الفلسطينية؛(1) فهو يسمّي المقدمة خطبة، ويوثّق معلوماته التاريخية والأدبية بالهوامش التي تطرز هذه الرواية وغيرها، وينطلق على عادة بعض الأقدمين (كالجاحظ مثلاً) من فكرة إلى أخرى، مستطرداً بسلاسة نحو فكرة لغوية أو تاريخية أو فلسفية، مسوّغاً ذلك بأنه لا يخطط لتداعيات روايته، تاركاً للاوعيه فسحة سردية واسعة: "فإنني، كعادتي في رواياتي السابقة، لا أخطط لتداعيات الرواية قبل الشروع في كتابتها، بل أرخي العنان للاسترسال الباطني حتى التسيّب أحياناً"، ص11.
وينتقل به الاستطراد انتقالات زمنية ومكانية على السواء، فإذ يشطّ خيال السارد عن شط عكا يسافر إلى شطآن بعيدة، متذكّراً خروجه مع الفجر ليصطاد سمكاً على شاطئ البحر الأسود: "خرجت مع طلوع الفجر في قارب صغير، أحركه بمجدافين سعياً وراء صيد السمك المنتشر في هذا البحر، وهو نوع من السمك نسميه في بلادنا الغُبُّس"، ص34.
ثم يستطرد بالحديث عن اليهود المغاربة الذين يسمونه بنانا تشبيهاً له بالموز، ثم إلى الروس الذين يسمونه "ستافريدا"، وإلى البلغار الذين يسمونه "سافريد"، ثم ينطلق إلى وصف رحلات الصيد في البحر الأسود (ص34)، قبل أن يعود إلى حكاية صيده في هذا البحر التي هي أصلاً استطراد عن أصل حكايته في شاطئ بحر عكا، واصفاً ريشاً ملوناً يستخدمه الصيادون؛ ليهجم عليه السمك، ويعلق في السنارة بسهولة.
ثم يذكر في استطراد آخر أن الصيادين هناك يهتدون إلى مواقع احتشاد السمك بالنوارس التي تلتقطها عن وجه الماء، كما يذكر قصة طريفة له مع النوارس التي تبعها، فقد اصطاد سمكاً وفيراً، وألقاه في بطن القارب لوفرته، وفرح حين رأى النوارس فوقه؛ لأنّ ذلك (فيما خمّنَ) إشارة إلى كثرة السمك في المنطقة، وما كان يدري أنه وفّر على النوارس عناء البحث في الماء، فانقضّت على سمكه: "فأدركتُ أني واقع لا محالة في ورطة أشد مدعاة إلى الإحباط من الورطة التي وقع فيها الصيّاد العجوز في رواية أرنست همنغواي"، ص36.
وهكذا يبني على استطراده المكاني (شاطئ عكا/ البحر الأسود) استطراداً شخصياً ذا طابع ثقافي (حبيبي/ همنغواي) بالإشارة إلى مغامرة صياد همغنواي في رواية (الشيخ والبحر) باحثاً عن أوجه الاختلاف بينها وبين مغامرة السارد الذي يشير إلى أن النوارس لاحقته؛ حتى ألقى إليها سمكة أخيرة كانت عالقة في بطن القارب، مكتفياً من الغنيمة بالإياب: "وفيما استطاع شيخ همنغواي أن يعود إلى الشاطئ بهيكل عظمي، هو ما أبقاه لك سمك القرش من الحوت العظيم الذي اصطاده، فقد عاد صاحبنا إلى البرّ خالي الوفاض وخالي البطن ـ بطن القارب ـ لا أسماك ولا عظام أسماك"، ص37.
وثمة استطرادات زمنية، تتجه إلى التاريخ القريب والبعيد، يهدف الروائي من خلالها إلى تأصيل الفلسطيني في أرضه، فيذكر في أحد استطراداته عائلات عكا، كالرومي والسلباق والبكراوي والحاج وأبو ناب وأبو سنة والشنبا، ثم ينتقل للحديث عن الشنبا الذي هو الرمان الأمليسي (الرمان الذي ليس له حب)، إنما هو "ماء في قشر"، ص57، والرمان الحَبيبي، نسبة إلى الحَبّ لا إلى الحُبّ، دون أن يصرّح إلى أن عائلة حَبيبي التي ينتمي إليها كنيت بذلك لهذا السبب، ولكنه يشير إلى أن جدّه أبو درويش لديه (مَرْمَنة) شهيرة في شفا عمرو مخصوصة بهذا النوع من الرّمان. ص57.
وإذ يتحدث عن مدرسة البرج في عكا، يستطرد عميقاً في الماضي مشيراً إلى أن البرج "شيّده ظاهر العمر الزيداني في العام 1760"، ص85، ثم يشير إلى أن نابليون أقام فيه بعد أن ردّته أسوار عكا عنها، ص85 أيضاً، وأقام فيه إبراهيم باشا الأرنؤوطي ليلة أو ليلتين، ص ص 85ـ 86؛ لينتقل بعدها إلى استطراد قريب: "وكان سكان جيفا الجديدة أو التحتا، يسمونه باسم برج السلام، وبعضهم باسم برج أبو سلام، وكانوا يسمون مدرسته بهذا الاسم تارة، وبذاك أخرى. ويبدو لي أن هذا الاسم علق بذهني من ذلك الزمن السحيق. حتى إذا رزقت بولد ذكر سميته باسم سلام، فدُعيت بأبي سلام"، ص86.
وهو ينتقل من حكاية صديقه بدران الذي يستنجد به دائماً، فيلبيه، حتى حين يطلبه في سرّه، حيث يجده أمامه: "ما كنت أقع في ورطة بحرية، أمام بحر، أو في عرض البحر، وأستغيث ـ في سري ـ بالولد بدران إلا وينشقّ الصخر أو البحر عنه مقبلاً أو مدبراً أو عائماً لخلاصي"، ص56.
وقد سمّى السارد صديقه بدران باسم عيسى العوام تشبيهاً له بالبطل التاريخي الذي يحمل الاسم نفسه، ذاكراً حكاية خيالية لبقائه وبقاء أهله في فلسطين: "كان الولد الأسمر، بدران، صياداً ابن صيادين من القلائل من أهل عكا الذين استطاعوا الغوص في بحر عكا وحبس أنفاسهم حتى مرت العاصفة،(2) فخرجوا وتسلّقوا صخور الشاطئ عائدين إلى فليكاتهم، فلما ردّوهم غاصوا تحتها وحبسوا أنفاسهم"، ص55.
ومن الطبيعي أن يستطرد إميل حبيبي الذي عوّدنا على أسلوبه؛ ليذكر قصة عيسى العوام كما نقلها مؤرخو الحروب الصليبية، فيروي عنهم "أنّ عوّاماً كان يقال له عيسى. وكان يدخل إلى البلد بالكتب والنفقات على وسطه ليلاً، على غرة من العدو، وكان يغوص، ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. وكانت ذات ليلة شدّ على وسطه ثلاثة أكياس فيها الف دينار وكتب للعسكر"، ص ص57ـ58، غير أن الأجل وافاه، فقام بأداء الأمانة حياً وميتاً: "إذا البحر قد قذف إليهم ميتاً غريقاً. فافتقدوه فوجدوه عيسى العوام، ووجدوا على وسطه الذهب وشمع الكتب. وكان الذهب نفقة للمجاهدين. فما رؤي من أدى الأمانة في حال حياته، وقد أداها بعد وفاته، إلا هذا الشاب"، ص58.
وربما يأخذه استطراده آخر إلى الفترة نفسها، فيذكر حكاية والدة أسامة بن منقذ،(3) حين عاد من وقعةٍ مع عربان، أغاروا على قلعته في شيزر، فوجد أخته جالسة على روشن يشرف على الوادي، فسأل والدته:
"ـ وأختي إيش تعمل هنا؟
فقالت: يا بنيّ، أجلستها على الروشن، وجلستُ برّاً منها. إذا رأيت الباطنية قد وصلوا إلينا دفعتها رميتها في الوادي، فأراها قد ماتت ولا أراها مع الفلاحين والحلاجين مأسورة"، ص24.
وإذا كنا نستسيغ الاستطرادات ذات الصبغة التاريخية التي يمكن ربطها بشكل أو بآخر بمواقف حكائية تؤصل وجود الفلسطيني في أرضه؛ فإننا نجد صعوبة في الاستطرادات الفلسفية التي يلجأ إليها الروائي أحياناً للوصول إلى فكرة محددة عبر مماحكة ذهنية تعوّق السرد. ويمكن هنا أن نشير تمثيلاً إلى إنفاقه خمس صفحات (173ـ 177) قارئاً في جمهورية أفلاطون، مناقشاً قضية من قضاياها، ليستنتج في لغة ذهنية جافة أن الضحية قد تقتل منقذها.
(يتبع...)
...................
هوامش:
1) يستخدم السارد مفردات بمعنى (يشُقّ عليه، أي يزوره)، و(بعدين؟ بمعنى: وماذا بعد؟)، ومن ذلك السياق التالي: "فيعود العواء من ورائه فينتهره صارخاً: وشت! فإن كان مواءً فالصرخة بِسّ"، ص45.
2) 1948، والهامش من الأصل.
3) أسامة بن منقذ: مؤيد الدولة، أو عز الدين أسامة، ويُكّنى أبا المظفر، (1095ـ1088): فارس ومؤرخ وشاعر، ولد في شيزر قرب حماة السورية، وهو أحد قادة صلاح الدين الأيوبي. من أشهر كتبه (الاعتبار).