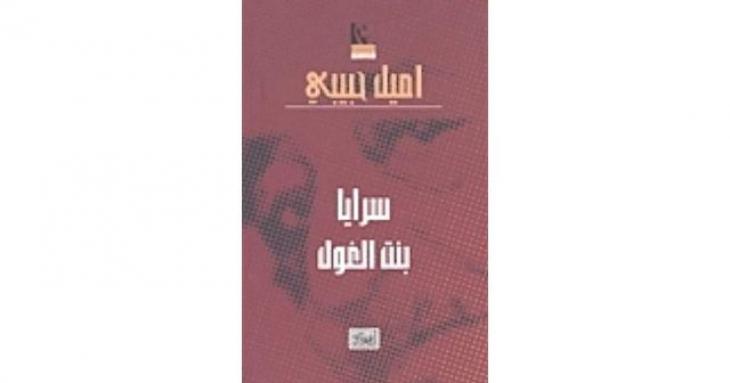أ.د. يوسف حطّيني | ناقد وأديب فلسطيني بجامعة الإمارات
إنّ الدوائر الثلاث الموجودة في العصا، بعيداً عن الجري وراء التحليلات المعقّدة، ترمز إلى الثالوث المقدس، على اختلافه بين المذاهب والأديان، فقد يكون رمزاً للآب والابن والروح القدس، وقد يكون رمزاً للجسد والروح والنفس، أو الزوج والزوجة والابن، كما يرى إبراهيم نفسه:
"كانت أطواق عصاه الثلاثة رموزاً منذورة أو مستورة، وكانت في ملته واعتقاده، ترمز إلى عقد شتّى. ولكنها دائماً ثلاثة ثلاثة ـ منذ إيزيس وأوزيريس وحوراس.(1) وأما الطوق التحتاني فهو عقدة أوديب، وأما الطوق الفوقاني، فهو عقدة إسحق، وأما الطوق الوسطاني فهو عقدة برج بابل"، ص152.
ويخيّل إليّ أنّ هذا الثالوث لا يرتبط بدلالة معينة، بمقدار ما هو مفتاح لتثليث دلالات تقترحها الشخصيات، ويقترحها القارئ؛ إذ يقترح العم إبراهيم معنى للدوائر التي يجعلها أطواقاً، فكل طوقٍ يخفي مرآة "وأما مرآة الطوق الأسفل فغير صقيلة. فتنعكس عليها صورة الإنسان الحيوان، وأما مرآة الطوق الأعلى فصقيلة، فتنعكس عليها صورة الإنسان الإنسان. وأما مرآة الطوق الوسطى فمقعّرة، حتى تتلاشى جميع الصور في حقّها، وتبقى هي وحدها وتحرق سبحات نورها كل ما أدركته. فتنعكس عليها صورة الإنسان النبي"، ص110.
وبعيداً عن هذا المعنى الصوفي تبسط الحكاية المفاهيم، وتقترح للدوائر الثلاث موضوع الغياب، فقد غابت عنه السُّعادان بالموت، بينما غابت سرايا بالاختفاء، وتأسيساً على هذا الغياب ينفخ السارد روحه في الدوائر الثلاث:
"وأنصب العصا عمودية أمام صدري، وما فوقه حتى ما فوق الرأس. وأنفخ من روحي نفخات ثلاث في الدوائر الثلاث.
في الدائرة الأولى باسم سعاد الأولى.
وفي الدائرة الثالثة باسم سعاد الثانية.
وفي الدائرة الوسيطة باسم سرايا بنت الغول"، ص ص70ـ71.
أمّا المقبض فيرسمه السارد على النحو التالي:
ويتسابق السارد وأسرته على فك طلاسمه، "فمن قائل إنه المطران، ومن قائل إنه الإمام، وأراه أشبه برجل فضاء سقط على أرضنا بعدّته الكاملة"، ص153. أما العم إبراهيم فشرح رموز المقبض على النحو التالي:
"هيئة المقبض هي علامة الاستفهام البدائية الأولى: اكسر الطرف الأيسر او الطرف الأيمن من الطوق فتظهر لك علامة الاستفهام العصرية.
ـ والذراعان يا عماه؟
ـ علامة الشطب. ممنوع"، ص154.
فإذا وقفنا أمام دلالة السرد وشخصية السارد رأيناه يحيل إلى سؤالين أساسيين من أسئلة الحياة، وإذا كان الاستفهام هو قضية إبراهيم الكبرى؛ فإنّ نتيجته هي الشكّ الذي زرعه في نفس ابن أخيه/ السارد منهجاً للحياة.
ثالثاً ـ في دلالات السرد:
إن الغائب الأساسي في هذه الرواية هو فلسطين، أو بشكل أدقّ، فلسطين الحرة المستقلة التي تستطيع أن تمنح أهلها الباقين حرية العيش بكرامة على أرضها، وتمنح أهلها الراحلين حضنَ العودة، وللقارئ أن يتتبع المسارين المشار إليها قبل قليل، وأن يلمس مدى التوازي بينهما وبين المسار الحكائي؛ فقد كان السارد يجلس إلى الصخرة عام 1983، بُعيد انتهاء الحرب السادسة، وقد "تراءى له طيف سرايا بعد غيبة امتدت خمسة وثلاثين عاماً"، ص123. أي أنّ اختفاءها (أو اختطافها من قبل الغول) كان عام 1948، والطريف في الأمر أنّ الزمن الذي يجري على السارد لا يجري على معشوقته، فكأنْ لا حياة لها في ظل الاحتلال، أو كأنّها تلك الحبيبة التي تحافظ على شبابها، وتستعيد حكاية عشق عذري قديمة، بطلها جميل بن معمّر العذري الذي يصف جري الزمان عليه، دون بثينة، فيقول:
قريبان مرتعنا واحدٌ فكيف كبرتُ ولم تكبري
فإذ يتحدث السارد عن حكاية "الهولة" العجوز التي كانت تظهر للمسافرين في الليل في الوهاد، يتساءل فيما إذا كانت سرايا هولةَ الجبال: "فهل هولة الجبال سراب سرايا ـ صبية ذات صباً لا يزول ـ أشبه بسراب الواحة الذي يظهر للصعاليك الباحثين عما دفنوه في الرمال"، ص50.
وتتلبّس فلسطين لبوس سرايا مرى أخرى حين يؤكد السارد شعوره بتأنيب الضمير، لأنه صمت تجاه معاناتها كل هذه السنين الطويلة، منذ اختُطفت عام 1948، فيقول: "كنت غارقاً، لتوّي، في أتون من تأنيب الضمير على صمتي المزري عن استغاثات سرايا بنت الغول التي تكررت واختلط عليّ أمرها، فالقلب ينبض بنوعين من النبضات: النبض الطبيعي ونبض التأنيب والحسرة"، ص171.
ولكنه يشير إلى أنّه لن يكون هناك استقرار لجبل ولا بحر إلا إذا عاد الطفل إلى أمه، هي إذاً ابنته وعشيقته وأمه، إنها فلسطين التي تختصر كل النساء:
"وخيل إليه أن ابنة فرعون ترد الطفل إلى أيدي كل الأمهات سوى أمه.
فلا تقرّ عين الكرمل ولا تقر عين البحر ولا تقر عين سرايا.
ولا يقرّ ولا يستقرّ قصر حُبست فيه سرايا بنت الغول"، ص207.
ويذكر هنا أنّ الروائي، تأسيساً على ما تقدّم، لم ينشغل بحكاية سرايا الفردية، بل فتح نوافذها في سرده السيري والاسترجاعي والاستطرادي على معاناة الشعب الفلسطيني الذي عاش أسير الاحتلال أو أسير الغربة التي أنتجها الاحتلال العنصري الذي يجعل من أصوات الجرحى سيمفونية رائعة يسمعها مذيع إسرائيلي باستمتاع، ص22، ويوثّق حبيبي ذلك في الهامش مشيراً إلى أن السياق يتحدث عن مجزرة السموع التي تقع في جبال الخليل؛ حيث ارتكبت المجزرة كتيبةٌ خاصة بقيادة آرئييل شارون في 13/ 11/ 1963. (2)
ذلك الاحتلال الذي أثّر على عائلة السارد، مثلما أثّر على المجتمع الفلسطيني بأسره، فها هو ذا السارد يقول: "لقد تفرقت عائلتنا الكبيرة أيدي فلسطين" (3)، ص126. وبسبب هذه التفرقة بين المقيمين وأهل الشتات صار لزاماً على من يريد أن يرى ابن وطنه أن يضرب في الأرض باحثاً عن أقاربه وأحبابه:
• "وما هبطت في مطار أوروبي عابراً (ترانزيت) إلى مطار أوروبي آخر إلا وتفرست في وجوه النازلين والطالعين عساني ألتقي واحداً منهم أسأله عن جده وإن كان يعلم بأن له (عمّة) اسمها سرايا"، ص126.
• "كان عليك السفر، يا عبد الله، حتى موسكو كي تلتقي أبا خالد، (4) وحتى واشنطن، كي تلتقي أبا سلمى".(5)
وقد قدّم الروائي أثراً طريفاً، يبدي فيه براعة التقاط هائلة، لأثر الاحتلال على الأطفال الذين صارت ألعابهم أكثر ميلاً للحزن، فهو يشير إلى إدراك حزن والدته على ابنها نعيم الذي رحل إلى الدار الآخرة، من خلال لعبة تلعبها طفلتاه في لقطة إنسانية نادرة:
"وما علمتُ بحنينها الجارف هذا إلا حين استمعتُ، عرضاً، إلى ابنتيّ الطفلتين تلعبان لعبة (تيتا). وجدتهما جالستين على صخرة تحت شجرة زيتون في جنينة عباس المجاورة لبيتنا. كانتا تتظاهران بالبكاء وتمسحان عيونهما من دموع غير منسكبة، مقلدتين جدتهما: يا نعيم، واينك يا حبيبي"، ص125.
ويمكن أن نشير هنا إلى أشكال القمع التي كان يمارسها المحتلون ضد البشر والشجر والبحر، وغيرها، مبتدئين بالإشارة إلى ما عانته العمّة العجوز نزيهة، وهي على سرير المرض، بينما تهم بالسفر إلى الولايات المتحدة عبر مطار بن غوريون؛ إذ "يحيط بها المفتشون والمفتشات من كل حدب وصوب، ويحملها عدد منهم إلى غرفة التفتيش مرة ثانية، وهي مستلقية على العرش هذه المرة، كانت وجوههم متعددة الأشكال، كأنهم ملائكة الكاروبيم تحلّقوا حول النقالة"، ص137، خوفاً من أن تكون قد أخفت "في طية من طيات ثوبها، أو تحت شنتيانها زجاجة مولوتوف أو قنبلة عنقودية تلقيها عمتي نزيهة فوق مطار إيدلوايد (كنيدي الآن) في نيويورك"، ص138.
وفي لقطة سردية أخرى يصوّر حبيبي معاناة صغار السمك من الاحتلال، إذ يمارس المحتل على مدى الليل كله صولات ضوئية على الشواطئ وباتجاه البحر، كي تحرس فلسطين من المشتاقين إليها، بواسطة ضوء باهر "فكأن الجندي الذي يحرّكه سيّاف ضوء يخوض بسيفه معركة مع جحفل لجب من غيلان الظلام"، ص42. وهذا ما يؤدي إلى إيهام صغار السمك التي لا تمتلك خبرة الحياة بعد "فتنطّ فوق الماء ظانة أن الفجر قد طلع"، ص42.
بالإضافة إلى ذلك يكشف الروائي ممارسات الاحتلال في محو المدن والقرى وتدميرها (ممثلة بقرية الزيب التي سبق ذكرها)، وفي تغيير أسمائها، وطمر الآثار التي تدلّ على أصحاب الأرض الحقيقيين:
• "أوقف سيارته في نهاية الشارع الذي كنا نسميه شارع العشاق، ولأمر ما سموه من بعدنا شديروت هتسفي (جادة الظبي)، وقد أقفر من أهله الظباء"، ص107.
• "ثم طمرَتْهُ [مدخل القبو] حكومةُ الانتداب على فلسطين قبل أن تنطمر، فورثته حكومة إسرائيل مطموراً. فأبقت عليه مطموراً، وطمرت غيره من آثارنا التي لا تدل إلا علينا"، ص129.
لقد شكّلت ممارسات الاحتلال جزءاً من ماضي السرد، مثلما شكّل ماضي سرايا جزءاً لا تنفصم عُراه عن روح السارد. وثمة سياقات استرجاعية كثيرة تحتلها تلك المرأة، منذ كانت طفلة الذاكرة التي لا تشيخ، فقد كانا يتشاطران القفز والتلويح وتفاح الجنّ والأحلام وخرير الماء:
• "وعن عرائس أحطن بصخرة فوق الكرمل كنا نجلس في ظلها نتشاطر، سرايا وأنا، تفاحة من (تفاحات الجن)(6). نقف ونرقص مع هذه العرائس دائرين حول الصخرة، وخائضين في ماء العين تحتها، وكنا نتراشق ماءها، وتنشاطر خريرها، ونلف، وندور"، ص30.
• "وكنتُ أصعد إلى سطح بئر قائمة على يمين الدرج. أحمل كتاباً أو دفتراً، وأنتظر على طرف السطح. وكنت تشاهدينني قبل أن أشاهدك أحياناً. فتقفزين عالياً في السماء، وتلوحين لي بيديك عالياً في السماء"، ص116.
كما يستذكر السارد أمه وأولادُها، وهو منهم، وراءها: كل منهم يتعلق بثوب الآخر، فتبدو معهم مثل قاطرة من أفراخ الحجل، ويستذكر أخاه جواد الذي كان "عربجيا على حنطور يقف في ساحة الحناطير"، ص91، وأخته الكبرى، وحكاية الحب في الملاحات التي يرويها عن سعاد/ (دلّوعة جواد)، تلك (الدّلّوعة) التي ماتت غرقاً، وأعطت اسمها لابنة جواد التي تموت بصعقة كهربائية، ولتصبح ذاكرة الاسترجاع هي ذاكرة الفقدان ذاتها:
• "وكانا يقضيان وقتهما في الملاحات سباحة في مصب النعامين. وقبل طلوع فجر أحد الأيام، جرفهما ماء النهر إلى عرض البحر. وخرج من الماء وحده."، ص69.
• وسمّى ابنته سعاد الثانية على اسم سعاد الأولى، ولكن الثانية ماتت، "وهي طفلة بمس كهربائي غير متعمّد"، ص70.
وكأنّ حبيبي يريد أن يجعل من جواد قصة موازية للتاريخ الماضي المستلب، فجعله مثالاً للفاقد الذي لا يسترجع شيئاً، لقد فقد فلسطينه وحبيبته وابنته وزوجته، تاركاً للسارد الطفل أن يتمسك (بحقّه!) من هذا الفقدان:
"وفقنا مذهولين أنا في الداخل، وهم في الخارج. فأوهمني هذا الفارق المنخفض في الموقع الجغرافي أنني رأيت في عيونهم حسداً، فصرت كما أم العروس، فاضياً مشغولاً، وبين الصرخة والصرخة الخارجة من أفواه الندابات، كنت أخرج إليهم وأبعدهم عن المأتم الذي هو مأتمي"، ص90.
(يتبع...)
...............
هوامش:
1) الثالوث هو اتحاد ثلاثة عناصر ليكوّنوا معاً وحدة واحدة، وقد تكون ثلاث كيانات إلهية، أو ثلاث صفات، أو أو ثلاث كلمات أو ثلاثة أشكال، فالإنسان عند المصريين القدماء مؤلف من البا/ الروح والكا/ القرين والآخ/ الجسد، فإذا توفي تصعد البا في الأفق، وتظلّ الكا طليقة، بينما يفنى الآخ او يتم تحنيطه. والثالوث الأوزيري مشهور عندهم، وهو الزوجة والزوج والابن: إيزيس وأوزوريس وحوراس. وثمة في المسيحية ثالوث مقدّس هو الأب والابن وروح القدس. وفي الأثر الإسلامي هناك مثلثات كثيرة من مثل: آية المنافق ثلاث/ وإذا مات ابن آدم ارتفع عمله إلا من ثلاث.. إلخ.
2) نستطيع أن نقرأ مثل هذه السياقات العنصرية البغيضة الشامتة بالدم العربي في أماكن عديدة، فقد نشر الجندي الإسرائيلي مائير هارتزيون في الصحافة الإسرائيلية عام 1969م مذكرات أشار فيها إلى اعتزازه بمجازر ارتكبها مع رفاقه بدم بارد، ضد مدنيين فلسطينيين.
3) يقال في الموروث: تفرّقوا أيدي سبأ، أي تفرّقوا كما تفرّق أهل سبأ في الأرض، وهنا يفترع المؤلف سياقاً جديداً؛ ليشير إلى أثر النكبة في تشتيت الفلسطينيين.
4) فؤاد نصّار. الهامش من الأصل.
5) عبد الكريم الكرمي. الهامش من الأصل.
6) ثمة رواية فلسطينية ذائعة الصيت تبنى حكايتها الأساسية على تفاح الجنّ، هي رواية (تفاح المجانين) ليحيى يخلف؛ حيث يبحث بدر العنكبوت عن سرّ القوة: "كانت تبدو شهية... طافحةً... تقدم نفسها بشراهة، فأكلتها، أكلتها دفعةً واحدة وفي الحال تحولتُ إلى جمرةٍ. ناولني ثانية. وثالثة، فصرتُ سفوداً أحمر يقترب من درجة الذوبان (...) وأكلنا المزيد من تفاح المجانين... وعند العصر كنتُ أتحوّل إلى قطار بداخله طن من الفحم الحجري الذي يحترق": يحيى يخلف: تفاح المجانين، دار الحقائق، بيروت، 1982، ص49.