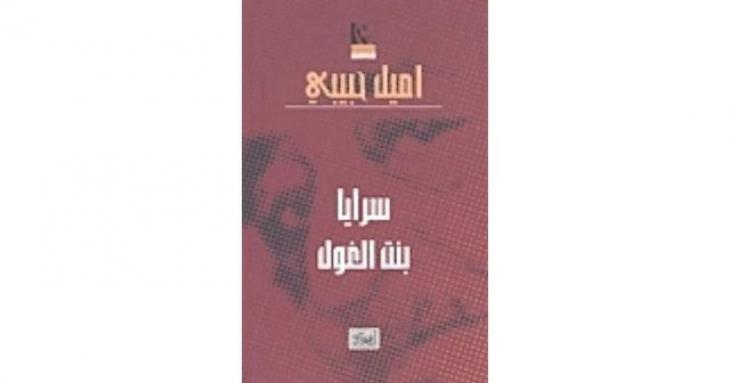أ.د. يوسف حطّيني | ناقد وأديب فلسطيني بجامعة الإمارات
أولاً ـ تمهيد:
(خرّافيّة سرايا بنت الغول) (1) للكاتب الفلسطيني إميل حبيبي نص سردي تختلط فيه الرواية السيرية بالأسطورة، يحكي وقائع حكاية جرت في فلسطين، على شاطئ قرية الزيب عن فلسطينيين تهدمت بيوتهم فوق رؤوسهم، ولم ينج منهم إلا القليل، "ونجا منهم إلى سوريا من كان ساعتها في حقله، فلم يدفن تحت الردم، ولم يبق من بيوتها سوى بيت المختار القائم على هضبة مشرفة على البحر"، ص25، وقد حوّله (ابن عمّ لنا) "إلى متحف جمع فيه آثار الزيب العربية، من أحجار الرحى، حتى الجماجم)، ص25، معلناً "دولة الزيب الحرة المستقلة".
هناك حيث يقرّب الظلامُ السّماءَ من الأرض، ويُلبِس الضبابُ البحرَ بالهواء أمام الناظرين، جلس السارد فوق صخرة، وراح يروي خرّافيته مازجاً تفاصيلها الأسطورية بمرجعيات واقعية عن أناس عادوا؛ ليفقدوا ما بقي من الأطلال، ومن قبور الأحبة، وليغادروا، من ثمّ، بقلوب مكسورة.
تظهر سرايا، أو يظهر ظلّها، أو شبحها، في محرق زمني (2)، لا يملّ السارد تكراره مرة بعد أخرى، فنقرأ مثلاً: "لم أفاجأ حين فاجأني ظلّه الباهت مضطرباً على سطح البحر المضطرب أمامي. فقد كانت ترامت على مسمعي وشوشات غامضة عن (شيء) يظهر لهواة الصيد الليلي على شاطئ الزيب ـ امتداداً من خرائب الزيب حتى رأس الناقورة شمالاً"، ص ص26ـ27.
وقبل أن يسترسل في متابعة هذا الظلّ يستطرد أو يسترجع أو يلتفت؛ ليعود من جديد إلى اللحظة المحرقية الفاصلة التي تشده إلى مشيمتها، والتي يكرّرها نحو عشر مرات، مضيفاً في كل تكرار تفصيلاً جديداً يزيد اللحظة إيهاماً والمتلقي تشويقاً. ويمكن لنا هنا أن نشير إلى بعض السياقات التي تجعل زمن ظهور سرايا محرقاً زمنياً:
• "كنت سارحاً بخواطري، هذه السرحة، وكنت أعالج قرينتي القصبة حتى أفكّها عني حين فاجأني ذاك الظلّ الباهت مضطرباً على سطح البحر المضطرب أمامي. حسبته للوهلة الأولى، ظلّ سمكة القرش تسعى في الماء تحته قائلة: خذني! وهي التي تسعى لتأخذني.. لولا همهمة صدرت عن الظل قادمة من ورائي. وكانت همهمة أنثوية.
خلتُ أنها نادتني بيا يابا!"، ص39.
• "قال: حتى جاءت تلك الليلة المهولة من ليالي نهاية الصيف غير المقمرة من العام 1983"، ص26.
• "كان الظلام يحبو حبوته الأولى، متردداً بين السماء والأرض في ليلة من ليالي أواخر الصيف امتزج ظلامها بضبابها، المثقل بالماء، حتى اختلط الأمر بينهما"، ص30.
• "كانت ليلته الدخانية، تلك، ليلة من ليالي الصيف ـ الأول الذي جاء بعد صيف عين الحلوة فجفّت مآقيها، وصبرا وشاتيلا، فجفّت مقاثيها"، ص31.
• "قال: فلما ظهرت لي، خيالاً على شاطئ الزيب، اشتهيت أن أعود إلى الكرمل أبحث عنها: صبية نائمة تنتظر قبلتي فتستيقظ، فنعود"، ص112.
ومن حكاية حزن إلى حكاية قهر، ومن استطراد إلى آخر يتنامى ظلّ الحكاية بطيئاً ممتداً، مرتداً إلى تفاصيل لقاءات السارد بسرايا؛ حيث اللقاء الأول في "عين سرايا"، وحيث تراشقا بالماء تعارفاً، ويكون على سارد الخرافية أن يملأ، متأنّياً، خمسة وثلاثين عاماً من الغياب بذكريات عن أمه وأبيه وعماته، وعمه إبراهيم، وعصاه ذات الأطواق التي أورثها أخاه الأكبر "جواد"، وهموم المقيمين والمهجرين، دون أن ينسى سراياه التي كانت تتمشى في الغابات ثم خطفت (من قبل الصهاينة المحتلين)، تماماً كما اختُطفت سرايا/ الأسطورة من قبل الغول، حيث أنقذها ابن عمّها في نهاية المطاف الأسطوري، أما في نهاية المطاف الخُرّافي فلا تظهر "سرايا" بل آثارها: من خلال ورد تنثره على قبر "سعاد" الصغيرة، ومن خلال مجيئها إلى مكتب السارد مع "فراشة" ثم اختفائها، ومن خلال ظهور "سرايات" وفراشات بأسماء متعددة على الحدود. وهكذا تنتهي الحكاية مثلما بدأت مثل قبض ريح، دون أن يخسر المؤلف الأمل، أو الأمل الفني على الأقل، وهو يتجلى في انتظار يوم تعود فيها "سرايا"، ليروي عنها خرافية أخرى:
"ولو كان لي بيت قريب لجئتكم من مؤونته بطبق من زبيب.
أو من تفاح الجن.
فإلى اللقاء في الخرافية القادمة.
قولوا إن شاء الله"، ص211.
ثانياً ـ في رحاب الفضاء الجغرافي والطباعي:
في تلك القرية الساحلية التي تقع على الساحل ما بين عكا ورأس الناقورة يقوم السارد بتأهيل المكان سردياً لاحتضان الخرافية، بعد أن أثثها بالتاريخ والجغرافية وجمال الطبيعة، وشدّها إلى تاريخ قديم، يمنحها حصانة حضارية، لا تمكّن الأعداء من اقتلاعها، فالزيب "قرية قديمة قيل إن العرب الكنعانيين هم الذين أسسوها، وكانت في القرون الوسيطة محطة للسائحين في طريقهم من عكا إلى صور، وأقام فيها الرحالة الأندلسي ابن جبير"(3)، ص25.
ويؤثث سارد "الخرافية" المكان كذلك بالبشر، مشيراً إلى أنّ أهل الزيب كانوا قد اشتهروا بصناعة الصباغ الأرجواني الذي استقطروه من الأصداف، مضيفاً في معلومة توثيقية، يعيدها إلى كتاب مصطفى مراد الدباغ "بلادنا فلسطين" إلى أن "ثمن ثوب مصبوغ الأرجوان في القرن الأول للميلاد ما يعادل ألفي دولار في عملتنا الحالية"، ص24. وربطاً للماضي البعيد بالماضي القريب يذكر السارد عائلات عكا، وأصول أروماتهم، كالرومي والسلباق والبكراوي والحاج وأبو ناب وأبو سنة والشنبا، مؤكّداً أن هذا التاريخ المكاني المؤثث صخرة يمكن الاستناد إليها في طريق الأمل: "فلا تقولوا يا أحبائي: لم يبق شيء نخسره! فوالله إن الوقوف على الأطلال، أمام بلوطة محرمة أو أمام صخرة في الحبس الانفرادي، لأفضل من حياة القصور المشيدة فوق ضباب الغربة"، ص77.
ومثلما ينبش السارد تاريخ الزيب وعكا ينبش أيضاً تاريخ الجغرافيا العكاوية، وكيف لا يفعل ذلك، وهو الذي "فوق صخرة في وادي العشّاق في الكرمل دوّرت رأسه زغاريد جنيات وحكايا شجر وأغاني عيون ماء"، ص46. هنا يبحث السارد عن أكثر مظاهر الطبيعة ثباتاً؛ ليشدّ الفلسطيني إلى أرضه، فلا يجد أبهى من جبل الكرمل الذي لا يحول ولا يزول:
"أما الكرمل فقد وُجدنا، وهو موجود من قبلنا، ننام وهو ماثل أمام أنظارنا، فنستيقظ غير ملتفتين إليه؛ لأنه موجود، كما السماء فوقنا موجودة، والشمس في النهار موجودة (...) ولا يختفي كما تختفي نجوم السماء، أو تغيّر من رسومها، ولا يشرق أو يغرب، ولا هو قمر يهلّ هلاله، ثم يصبح بدراً، ثمّ يأفل ذلك البدر. فالكرمل هو الكرمل"، ص104.
وقد أشار السارد مرة أخرى إلى خلود جبل الكرمل، وانتمائه إلى زمن كوني، مترافقاً مع فكرة التناسخ التي تساعده على الخروج من زمن الاحتلال، لذلك يقول:
"وسرحت الطرف فيما حولي من جبال أشاهدها عن كثب لأول مرة فاكتنفتني، كما السكينة المطبقة علي من كل جانب، ألفة قديمة إلى هذه الجبال، أيقظت في نفسي ـ المستريحة على حتمية الفناء ـ هواجس المساءلة الذاتية: في أية حياة، في أي زمن، كنت ألِفْتُ هذه النواحي؟"، ص51.
إنه يعيش تناسخه؛ ليؤكّد أن فلسطين كانت له في زمن آخر، في زمن أزلي يتناسخ مثله، لذلك "دهمته الخيالات نفسها التي دهمتنا حين كنا طلاباً في مدرسة الجبل في حيفا، إذ أبلغونا لأول مرة، عن أحلام الفيلسوف الإغريقي القديم فيثاغورس عن تناسخ الأرواح"، ص52.
وإذا كان الكرمل قد بدا في السرد مشدوداً إلى ثنائية الأزلية والأبدية، بما يتخطّى وجود الإنسان، وإذا كان تأزيله وتأبيده جاءا على حساب انفصاله عن الفعل البشرى في السرد، فإن البحر ـ على الرغم من امتلاكه تلكما الصفتين ـ بدا حميمياً ومنفتحاً على تجارب الشخصيات وخبراتها، وربما يعود السبب إلى عمل السارد في الصيد، واقترابه من البحر إلى حدٍّ استطاع خلاله أن يمّيز الأصوات البحرية بعضها من بعض:
"تعوّد منذ طفولته على أصوات البحر النهارية (...) من خشخشة أصداف الشاطئ الرملي، الهمزة اللمزة، حتى ارتطام زخات المطر بالموج الكافر الذي يتطاول على سماواته السبع مرتكباً خطيئة برج بابل (...) أما أصوات البحر الليلية فشيء آخر؛ فالظلام يفك عقدة لسان البحر، فيعوي ويتأوه، ويوشوش أحياناً"، ص ص44ـ 45.
ويبدي إميل حبيبي اهتماماً بالغاً بالفضاء الطباعي، ابتداء من الغلاف الذي كتبت خطوطه بالأبيض والأسود والذهبي، وتضمّنت لوحة غلافه كائناً أسطورياً مجنّحاً، مروراً بعتبة الكتاب، وانتهاء بعتبات الفصول. فقد أشارت عتبة الكتاب الأولى إلى جملة مفتاحية من جمل الأسطورة الفلسطينية هي "سرايا يا بنت الغول.. دلي لي شعرك لأطول"، ص5؛ ليتم الانتقال من ثمّ إلى "خطبة المؤلّف" التي حملت عنوان "شجرة الإجاص زُرعتْ لتطعمنا أجاصاً"، ص9، بينما تشير عتبات الفصول إلى منصوصات دينية وفكرية، مقتبسة من رسالة يوحنا الرسول الأولى. ص19، ومن ألبرت أينشتاين"، ص63، ومن أخناتون، ص121، ومن القرآن الكريم، ص165.
ولم يكتف الكاتب بما تحتوي عليه هذه العتبات من الغنى الفكري، وبصلاحيتها للتمهيد لمضامين الفصول الأربعة، فقد عمل على ربط العتبة الأولى بالأخيرة؛ فإذا كانت العتبة الأولى تطلب من سرايا أن تدلّي شعرها حتى ينقذها ابن عمّها، فإن العتبة الأخيرة (عتبة الفصل الرابع)، تأتي لتكون برداً وسلاماً على قلب السارد، وربما على قلوب المتلقين أيضاً، لا سيما أنها تقابل كلمة (الغول) التي شغلت عنوان ذلك الفصل؛ إذ يجعل إميل حبيبي عتبة الفصل آية قرآنية تشير إلى عودة موسى إلى أمه، بما يوازي عودة سرايا إلى حبيبها، أو عودة الفلسطينيين إلى ديارهم:
"فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ"، سورة القصص، الآية 13.
ولا بدّ لنا ونحن بصدد الحديث عن الفضاء الطباعي أن نشير إلى (عصا إبراهيم) التي اجتهد النقاد في تحليل دلالاتها، وقد أورد الكاتب صورتين لها: الأولى صورة أفقية للعصا كاملة، وأما الثانية فقد اقتصرت على مقبضها. وقد شغلت العصا جانباً مهماً من الحكاية، وملأت كثيراً من الفراغات التي تركتها حكاية سرايا، فهي جزء من شخصية إبراهيم/ عم السارد، يتوكّأ عليها، ثمّ يورّثها لجواد/ أخي السارد:
"وكنت أتجول معه متوكئاً على ذاكرته، فيما كان يتوكأ هو على عصا عتيقة وغريبة الأطواق مضت تبش أطماراً ومزابلاً من النسيان من فوق ذاكرتي منذ وقعت عيناي لأول وهلة وهو خارج من بوابة العبور في رأس الناقورة، يتوكأ عليها"، ص6. (يتبع....)
..............
هوامش:
1) إميل حبيبي: سرايا بنت الغول (خرّافيّة)، رياض الريّس للكتب والنشر، لندن ـ قبرص، ط1، يناير، 1992.
2) المحرق الزمني: لحظة، أو مدّة قصيرة، تكتسب أهميّة خاصّة في حياة الشّخصيّة الفنّيّة، يقوم المبدع بتبئيرها، فيحدّدها ويسلّط الضّوء عليها، بسبب ما تعنيه للشّخصيّة ذاتها، إنّها لحظة تنويريّة، بالنّسبة إلى الشّخصيّة لا إلى المبدع، وحين يركّز المبدع عليها فهو يستسلم لغواية شخصيّته.
3) راجع كتابنا: مصطلحات السرد في النقد الأدبي الحديث، عالم الكتب الحديث، عمّان، 2018، ص199.
• أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي الشاطبي البلنسي، ولد في بلنسة سنة 539هـ (1144م) وكانت وقاته سنة 614 هـ (1217م)، اشتهر بكتابه الذي عرف باسم "رحلة ابن جبير"، وهو ثمرة ثلاث رحلات إلى المشرق، أهمها رحلته الأولى بين العامين 578 هـ (1182م) و581 هـ (1185م). وزار عكا في أثناء هذه الرحلة، وعرّج على الزيب. (الهامش من الأصل).