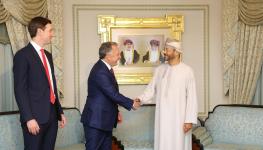دراسة في شعر أحمد ظاهر (1)
د. السيد العيسوي عبد العزيز – مصر
مدير النشاط الثقافي بمتحف أمير الشعراء أحمد شوقي- مصر.
يمكن القول إن هذه هي الحلقة الثالثة من دراسة أوسع لظاهرة فرضت نفسها على الإبداع العربي المعاصر من سلسلة أطلقت عليها من قبل عنوانًا عامًا هو "أدب الحرب" وأقصد به ما نشأ من إبداع خاص تفجر في ظل أزمات الواقع العربي التي تفجرت في إثر ما يسمى بموجات الربيع العربي أو الثورات العربية منذ عام 2011 في عدة دول عربية بصرف النظر عمن أسماه ربيعا، ومن أسماه خريفا نظرًا لتوجه كل فريق، المهم أننا أمام ظاهرة تفجرت إبداعًا خاصًا لا مثيل له في الأدب العربي من قبل.
والسبب أن المسألة اتسعت ودخلت فيها أطراف عدة، وتحولت إلى حروب في معظم الدول التي طالت فيها أزمات هذه الموجة سنوات طويلة، لا نستطيع أن نقول إنها حروب أهلية، ولا إنها حرب ضد المستعمر، ولا إنها حرب طوائف، ولكنها أخذت من كل ذلك بطرف ، وشكلت ظاهرة معقدة، وكان الناتج انفجارًا مهولاً، لا يمكن أن تصوره كلمات، فما يحدث في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه أكبر من أن يستوعبه عقل، أو يخطط له شيطان، أو تسطره صفحات التاريخ، هو ما يشبه القيامة الصغرى، دمار وتشتيت وتهجير وغربة ومنافٍ وتشرد وموت وتطاحن ومكايدة وانقسامات لا تنتهي، وأجيال فقدت حياتها أو جزءًا كبيرا من حياتها، ذهب مع أطرافها أو مع ما ذهب من أجسامها القعيدة نتيجة القذف العشوائي وغير العشوائي على المناطق السكنية في حروب لا تنتهي. الخسارة الحضارية لا تقدر بثمن، والخسائر البشرية مهولة، والخسائر النفسية لا يمكن إحصاؤها.
ومن ثم لا يمكن أن ندرس هذا الشاعر بعيدًا عن هذا السياق، ولكن ما الذي يميز الشاعر أحمد ظاهر عن شاعر سوري آخر متميز على سبيل المثال هو الشاعر عمر هزاع، درسناه من قبل مثلا في إطار هذه الظاهرة من خلال ديوان كامل سماه "السابعة حربا بتوقيت دمشق"؟ هذا هو السؤال الذي ندلف من خلاله إلى الدراسة.
الشاعر أحمد ظاهر شاعر سوري متعدد المواهب، فهو شاعر، وفنان تشكيلي، وباحث في التراث الشعبي الفراتي (وهو التراث المتعلق بمجموعة القيم والتقاليد الشعبية والعادات والأعراف الاجتماعية والحرف والفن والشعر الشعبي المتوارث) ولعل هذه النبذة التعريفية تمثل مفتاحًا من مفاتيح تذوق شعره وشخصه، حيث يجتمع في شعره الرقة والعذوبة والشفافية ورسم المعنى والارتباط الشديد بالأرض. يتضح هذا في أعماله الشعرية والتشكيلية والبحثية. حيث تعكس المنطقة التي نشأ فيها في سورية خصوصية ما، وهي "الرقة"، فالمعروف أن نهر الفرات يذكرنا بالعراق، ولكنه يدخل سوريا أيضا من مدينة جرابلس ويعبر الرقة ودير الزور ، يعبر في سوريا 650 كيلو متر. وأبناء هذه المنطقة جزء من بلاد الرافدين، وإن كانوا سوريين منذ القدم. وفي هذه المنطقة الشرقية تختلط لهجة السوريين بلهجة العراقيين بشكل كبير، ولا يستطيع تمييزها إلا أهل المنطقة.
كما لاحظنا أن كثيرا من شعراء البلاد الواقعة على ضفاف الأنهار والتي تنتشر فيها الخضرة والبساتين والحدائق يتميزون –عادة- بمعجم شعري أرق، وروح آسرة، وسوف نجد هذا علامة مميزة أيضا في شعر الشاعر.
كل هذه المعلومات ليست هباء، فنحن هنا في حاجة إلى الاستعانة الأولية بالمنهج الاجتماعي التاريخي لفك جزء كبير من شفرة الشاعر.
إن مفتاح هذا الشاعر هو الارتباط الشديد بالأرض والنهر وتمازج الروح السورية والعراقية في شعره، كأنه من نسل حضارتين امتزجتا في دمه.
الارتباط الغريب بالنهر يمثل تيمة في شعره، وإبداع أهل منطقته أيضا، فلا يكاد يخلو عمل إبداعي من ذكر النهر بشكل رئيسي أو عرضي.
وهذا يفسر لنا نشوء هذا التراث الشعبي الفراتي. ومن ثم يفسر لنا التيمة الثانية: الارتباط بالأرض، فالمعروف أن المناطق التي لها تراث هي المعمرة في تاريخ البشرية وحضاراتها، ومن ثم يكون لأهلها خصوصية، تعكسها أشياء كثيرة، من أهمها التراث، والتراث يعني التجذر في الأرض.
في شعر أحمد ظاهر تيار عميق هادر يعبر في الأعماق، ولقد عرفنا سره بعد هذه المقدمة، وهو لا يني ينحت جدران قلبه، ويشكل ضفاف وجدانه، وهو أنسب مدخل لدراسة هذا الشاعر، وقد يختلط هذا التيار بنهر الدم المتدفق فتتغير الألوان في لوحته الشعرية التي تتشكل باستمرار. ثم يضاف إلى ذلك ما قلناه من قبل عن شعره بما فيه من رقة وعذوبة وشفافية ورغبة في رسم المعنى، لا سيما أنه فنان تشكيلي يدرك مدى فضاء اللوحة الشعرية وأثره في تلوين المعنى.
وإذا أضفنا إلى هذا التيار فكرة ارتباط الشاعر بالتراث ودراسته إياه من منطلق بيئته التي تتميز بخصوصيتها الجغرافية والحضارية أو من خلال عشقه له وتجذره الشخصي فيه، وربطنا هذا بما سبق -نستطيع أن نفسر سر انتشار الرؤية الطللية للوجود في شعر هذا الشاعر بالذات في مقابل إعمار الروح بالفن كنوع من التعويض، والوقوف الطويل أمام النهر كرمز للحياة في مقاومتها للموت والفناء، من هنا تتشكل دراما الموت والحياة في شعر هذا الشاعر.
ذاك هو المدخل الذي من خلاله ندرس هذا الشاعر كما ينطق شعره ولا سيما في هذا الديوان بعد أن استقصينا قدرا لا بأس به من تجربته الإبداعية الكلية، بالإضافة إلى المداخل الفرعية التي يقتضيها الوقوف أمام نصوص معينة تمثل علامة بارزة في هذا الديوان.
***
ولنبدأ بنص خاص ومركزي في هذه الرؤية يجمع لنا أطراف ما قلناه، ويشكل مفتاحًا مهما لمن يريد أن يقرأ هذا الشاعر بعمق، ألا وهو نص "من حكايات الرحيل":
يقول فيه:
ســـلامُ الـــروحِ لـلـطـللِ الـحـزينِ ... عــلـى رســمٍ غـفـا بـيـن الـجـفونِ
تُـسـائـلُ عـنـهـمو الـكـثبانَ عـيـني ... بــهـتّـانٍ وســيـلٍ مـــن شـجـونـي
طـوتـهـمْ تـلـكـمُ الأحــقـافُ لــيـلاً ... وأوسـعـنـي الـفـراقُ مــن الـحـنينِ
ألا يــا ربــعُ خــبِّــرْ أيــــنَ ســـاروا ... وهــلْ طــولُ انـتظاريَ يـحتويني
فـأرخى الشجوُ فوقَ الرسمِ شوقاً ... وكــانَ الـدمـعُ يـقـطُرُ مــنْ أنـيـني
فــســالَ مـيـمـمـاً وديـــانَ قـلـبـي ... وضجَّ الصمتُ في فوضى الظنونِ
وطـالَ الـصمتُ فـي جـمرِ الثواني ... فـكـلّـت فـــي انـتـظارهمُ مـتـوني
تـسـائـلني الــديـارُ عــن انـتـظاري ... أقـــولُ بـهـجرهمْ قــد أوقـدونـي
دعـيـنـي أبـــكِ أظــعـانَ الـمـطـايا ... ومــن فــي جــوفِ نـارٍ أسـكنوني
دعــيـنـي أســــألُ الــعُـبّـارَ عـنـهـمْ ... فــقـدْ ضــاعَ الـرفـاقُ وضـيّـعوني
تركيا - 2014
يمثل معجم النص وصوره صورة تراثية معتقة، حتى ليكاد النص ذاته يكون معادلا لطلل الشاعر نفسه كشخص لا كنص.
قصيدة متدفقة أسيانة أيضا، شأن كثير من إبداعات الشاعر أحمد ظاهر، وهي من القصائد التي تبدي لنا كيف أن البحر الشعري العربي يتسع لإيقاعات نفسية عدة يكتشفها الشاعر بحدسه وبتفاعله مع حالته ثم يضمنها شعره، فتبطن النص بحالة خاصة، وهذا النص نص حالة خاصة، إنه ممتلئ بالحزن، كنهر متدفق جياش حزين، وقد جاءت القافية بحرف رويها النون لتؤكد حالة من الشجن والحزن، فالنون هنا تشبه فتحة العين الدامعة، والقلب الجريح، والجرح النازف، مع كسرها بما يوحي – داخل السياق- بانكسار الشاعر أمام تقلبات الزمن، وتحوله إلى طلل.
يبدأ الشاعر نصه بكلمة مؤثرة وقوية يجب ألا تمر علينا مرور الكرام، خاصة حينما يفتتح بها نصه:
ســـلامُ الـــروحِ لـلـطـللِ الـحـزينِ ... عــلـى رســمٍ غـفـا بـيـن الـجـفونِ
(سلام الروح) فهو ينشد الأمن والسكينة، وعبر مستويات عميقة (الروح)، وتلك هي الوحدة النفسية المفتقدة، تطغى على السطح ويكون لها الصدارة. وهو يتمناها حتى للجماد الذي يخلع عليه الصفات الإنسانية (الطلل الحزين) ثم لنتأمل (عــلـى رســمٍ غـفـا بـيـن الـجـفونِ) فكأن الشاعر يستصحب كل الأطلال وهو يرحل ، ثم تُثَبَّت الصورة في مخيلته ولا تفارقه أبدا.
وقد نجح الشاعر أيما نجاح باسترفاد رمز الطلل في قصيدته، لأنه رمز حي في القصيدة، وذلك لأنه واقع حي في الأساس قبل أن يكون رمزًا، فقط تناوله الشاعر وأجرى عليه بعض التعديلات والمدخلات الشعرية ليخرج لنا طللا رمزًا، وإن نبت الواقع من صلبه، ليتفاعل الواقع والشعر في النص.
تتحول الحياة إلى طلل، والوطن إلى طلل، والحب نفسه طلل في الطريق، والرفاق الذين ضيعوا الشاعر وضاعوا إلى غير رجعة وسط ويلات الحرب- طلل أيضا. لم يبق من الحياة إلا كل مُشوَّه. هكذا يتحمل الرمز كل هذا التشويه الناتج في وجه الوطن.
ناهيك عن استدعاء الروح التراثية للطلل، ولكن علينا أن نؤكد أن الشاعر لو فعل هذا فحسب، لكان مقلدًا، ولكنه انطلق من الواقع الحي، ثم تناص مع التراث في الطريق، لأنه شاعر أصيل وصادق.
وهكذا امتلأ الرمز بكل هذا الزخم الحزين، وتشكل به مع الوقت.
ويستمر الشاعر في التعبير عن هذه الحالة الطللية ، حتى لنشعر أن كل ما يقابله طلل، ولم لا، لقد تحول الوطن مادةً ومعنًى إلى حالة طللية تقابلك، ما بها إلا غربان الروح والواقع تنعق فوق رؤوس الخراب، هكذا تقول آلة الحرب.
حتى يقول:
وطـالَ الـصمتُ فـي جـمرِ الثواني ... فـكـلّـت فـــي انـتـظارهمُ مـتـوني
هنا تتحطم المعاني على صخرة الانتظار، تكل متون الشاعر ويتساقط حزنا في الطريق.
تـسـائـلني الــديـارُ عــن انـتـظاري ... أقـــولُ بـهـجرهمْ قــد أوقـدونـي
دعـيـنـي أبـــكِ أظــعـانَ الـمـطـايا ... ومــن فــي جــوفِ نـارٍ أسـكنوني
الديار والأظعان والمطايا مفردات توحي بالأسفار والفراق والتعب الروحي العميق حتى الاشتعال.. الحرب تمزق العلاقات الأليفة بين الناس والكون، وتفقد الإنسان كامل انسجامه، وتوصله إلى هذه الحالة من الاشتعال النفسي المستمر، حيث تتحول النار إلى (سكن).
ثم يأتي البيت الختامي مفجرا على نحو فريد:
دعــيـنـي أســــألُ الــعُـبّـارَ عـنـهـمْ ... فــقـدْ ضــاعَ الـرفـاقُ وضـيّـعوني
هكذا تنقلنا الحرب إلى متاهة يضيع فيها الشاعر والرفاق، ويصبح لكل منهم وجهة أبدية وسؤال أبدي غير مكتمل دون عثور على الماضي الجميل. وهكذا يقدم الفن الأصيل إدانة للواقع وانتقادًا للأوضاع بمجرد بث الحالة ونقل الأجواء ووضع شريحة من الحياة أمام الأبدية بكل ملابساتها وموقف الشاعر الباطني منها، وهو ما يميزه عن الخطب والوعظ والسياسة والفلسفة وخلافه. الشعر حياة تنتقد الحياة بأسلوب خاص وأدوات خاصة. وهذه القصيدة نموذج على هذا رغم بساطة تراكيبها وشفافية تعابيرها.
هذه قراءة عامة للنص، وإذا وضعنا النص تحت ميكرسكوب الرؤية الطللية التي أشرنا إليها فمن الممكن أن نخرج بقراءة أعمق، مفادها أن النص يمثل حالة الشتات الروحي، نفس الحالة التي رجع لها الشاعر القديم واقفا على الأطلال. لم يجد الشاعر الجديد أي معادل موضوعي لحالته فانتكس، أي عاد لحالة الشاعر البدائي، الذي وجد أطلال الأحباب، ليخلع الواقع النفسي والجدلية التي تحدثنا عنها: الواقع والحياة، فخلع على معنى الطلل معنى أوسع، ليس الأثافي وبقايا الآخر؛ المعنى على اتساعة أو إطلاقه.
من جانب آخر انتكاسته للغة التراثية هي انتكاسة العائز الباحث عن أي شيء من جذوره حتى لو كانت لغته (تُرى هل تحولت لغة التي حطمته الحرب ولغة العربي المعاصر إلى طلل لغوي يستحق الوقوف عليه؟!) اللغة التراثية هنا مقصودة، فالقصيدة ليس بها صورة واحدة إلا وتستقي التراث، هذه ليست حالة عابرة، هل مقصودة، شعوريا أو لا شعوريا، وهذا التكثيف والقصد والنجاح في نقل الحالة الباطنية يعني أنها عصرية، حولت الحالة الطللية إلى رمزية عصرية.
الأمر الآخر في القصيدة أنها تنطوي على موقف انتظار:
وطـالَ الـصمتُ فـي جـمرِ الثواني ... فـكـلّـت فـــي انـتـظارهمُ مـتـوني
تـسـائـلني الــديـارُ عــن انـتـظاري ... أقـــولُ بـهـجرهمْ قــد أوقـدونـي
وإن كان الشاعر التراثي لم يكن منتظرا، بل باكيا وفاقدا للأمل، يتعلل بالذكرى، فقد كان يعلم أن كل شيء قد قضي، وانتهى الأمر، ولكن هنا بكاء المنتظر، الذي يرادوه بصيص الأمل وإن كان ضيئلاً. وهنا الفرق بين بكائيته وبكائية الشاعر القديم، وما يمنح تجربته –في ذات الوقت- بعدًا عصريًّا.
ثم امتدادًا للجدلية وتفاعلاتها العنيفة: هل هو المنتظر أم الوطن، هو من رحل أم الوطن؟
فالمزية في النص أنه اشتغل على هذه الجدلية من أوله، جدلية الظاهر والباطن، النص يبدو تراثيًا لكنه غير تراثي على الإطلاق، هو مفعم بالألم والخذلان وهو يتدثر بالتراث عله يدفأ في ضوء عري الواقع.
إن حالة العمق الشاعري تجعل الشعر عميقًا، فحين يستخدم الإرث التراثي بهذا الشكل فهو عنده مغزى، أضف لذلك ما يعتمل في عمق النص من جدلية ومفارقة بين البداية والنهاية؛ بين (سلام الروح) في البداية ثم ضياع هذا السلام في النهاية (فقد ضاع الرفاق وضيعوني) كأنه كان ينشد بجلوسه على الأطلال شيئا من السلام، من هنا نشأ التوتر.
وأخيرًا يمثل معجم النص وصوره صورة تراثية معتقة، حتى ليكاد النص ذاته يكون معادلا لطلل الشاعر نفسه كشخص لا كنص، شخص ينمحي من الوطن ويبقى طلله ماثلا هناك، ليبكيه عبر هذا النص، ومن ثم يبكي طلل كل مغترب ومهجَّر ومشرد.
***
من العلامات والسمات التي وجدناها في أدب الحرب لدى أكثر من شاعر هو هذا الوجدان الجريح الذي تنكأ جراحَه أقلُّ المؤثرات، والذي تتلبسه حالة من الحزن الجريح، تبحث عن معادل موضوعي لأقل مناسبة، وهذا ما يراه الشاعر "ذاتَ مطر" في نص قصير يحمل هذا الاسم:
لا لـيـسَ قـطراً مـنْ ربـابٍ هـاطلٍ...لـكِـنّـهُنَّ عــلـى الـزُجـاجِ دمـوعـي
بـلْ هذهِ القطراتُ بعضُ سواكبي...حينَ العواصفُ أوغلتْ بشموعي
أو ربـمـا حـمـلَ الـغَـمَامُ دُمُـوعَـها..أمي الحزينة في انتظار رجوعي
أم يـاتـرى مُـقَـلُ الـسـماءِ هـواملٌ..مِــمـا ألـــمَّ بـمـوطـني الـمـوجوعِ
مـطـرٌ ويـرسمهُ الـزجاجُ قـصيدةً...آهــاتُــهـا مــعــزوفـةٌ بــضـلـوعـي
تـركــيـا – 2014
نحن أمام مقطوعة مؤثرة جدا، اكتنزت بالشاعرية وعبرت عن بعض إمكانات الشاعر الثرة، حيث تتكاثف المشاعر داخل الوجدان، واستمرار تكاثفها حتى لحظة التفجر، نجد هنا المثير الشعري، وهو حبات المطر الساقط على الزجاج، حيث إن كل قصيدة لها لحظة استدعائها الخاصة، فمن القصائد ما يكون لها مثير خارجي يستدعي مثيرًا داخليا، ومنها ما يستدعيه مثير داخلي نتيجة عدة تفاعلات نفسية، وبمقدار قوة المثير وحيوته وقدرة الشاعر على الامتلا ء به والشحن النفسي ثم قدرته على التعبير وتجسيد الشعور الداخلي عبر فنية عالية بمقدار ما يكون بارعًا ويكون لقصيدته من التأثير والجمال والفاعلية ما يضمن لها البقاء والدوام.
وقد حقق الشاعر الكثير مما سبق من خلال هذا النص الوامض المشع المكتنز بحالات شعورية عدة كلها تركز لحظة الانفجار.
جاء النص عبر إيقاع شعري أسيان، دامع ، حيث يبدو لي أن جدار الزجاج هنا الذي يسيل عليه المطر هو جدار قلب الشاعر الذي يسيل عليه الدمع. هكذا دخل بنا الشاعر في مقدمات معادل موضوعي، وإن لم يكن كاملاً. ولكنه استطاع أن يطرح مشاعره على الوجود من حوله، ويحول الطبيعة والواقع المحيط إلى جزئيات مشعة في إبداعه تتخذ إطارًا من المشاعر.
يبدأ الشاعر بإثبات حالة ثم نفيها:
لا لـيـسَ قـطراً مـنْ ربـابٍ هـاطلٍ...لـكِـنّـهُنَّ عــلـى الـزُجـاجِ دمـوعـي
بـلْ هذهِ القطراتُ بعضُ سواكبي...حينَ العواصفُ أوغلتْ بشموعي
حيث يثبت واقعة هطول المطر وتدافع القطر الذي يرتطم بزجاج النافذة، ويترك لنا حيزًا من الخيال، يمكن أن نتخليه يطل على الواقع النفسي البعيد، تائها مشرد الوجدان ، حيث الضباب الراحل قطعانا في الفضاء، وأبرع الشعر ما ترك للمتلقي مساحة يكمل بها أفق النص وخيال الشاعر وجو القصيدة، ليضفي واقعه الخاص على النص منتقلا من عام الشاعر إلى خاص نفسه. فما من أحد منا إلا ومر بهذه اللحظة.
يثبت الشاعر واقعة هطول المطر وتدافع القطر ثم ينفي في ذات الوقت، منتقلا إلى الواقع الداخلي لوجدانه، فما المطر هنا إلا دموعه الحزنية.
هكذا يقدم لنا الشاعر مشهدًا من الطبيعة، ولكن ما يلبث بعد إعمال الشاعرية وإدخال الطبيعة المعمل الشعري للقصيدة إن صح التعبير أن يحول المشهد لواقع داخلي، ولقطعة من وجدانه وواقعه النفسي. وهكذا تنتقل الطبيعة بكل طقوسها الأسطورية والحزينة إلى واقع داخلي متفجر بالعواصف والرياح والأمطار، ما يعني تدافع الحالة النفسية، وهو ما نراه في البيت الثاني:
بـلْ هذهِ القطراتُ بعضُ سواكبي...حينَ العواصفُ أوغلتْ بشموعي
فالطبيعة تزمجر داخله أكثر، ويبدو الواقع الخارجي أقل بكثير مما يعتمل في قلب الشاعر. ماذا يعني هذا؟ يعني أن قلب الشاعر هو طبيعة أخرى، تمتلئ بكل الظواهر الطبيعية وأكثر، ويعني أن قلب الشاعر من نوع خاص، إنه الكون مركب في أعماقه.
بعض الكلمات قد تبزغ في الشعر فجأة ثم تختفي فجأة، ولكنها لا تخلو من دلالة عميقة يجب التقاطها على مستوى التلقي، من ذلك كلمة (شموعي) وهي كلمة تعني الكثير من الدلالات، قد تعني شموع الفرح، وقد تعني شموع الحزن، وقد تعني شموع القداسة (المعبد).. في كل الأحوال نحن أمام واقع نفسي بعيد يستدعيه الشاعر في منفاه وغربته البعيدة عن وطنه... حيث تتكاثف المشاعر وتتقطر وتصبح وطنًا آخر لا يمكن للشعر مقاومته.
وبقانون الاستدعاء يتحول الشاعر لأكثر من خاطر ملح:
أو ربـمـا حـمـلَ الـغَـمَامُ دُمُـوعَـها..أمي الحزينة في انتظار رجوعي
فدموع الأم يحملها الغمام ثم تسقط على زجاج نافذة حجرة الشاعر منتظرة رجوعه في حنين وانتظار، حيث شعور الأم الذي لا يمكن وصفه. هكذا ينقلنا الشاعر لمشهد آخر في لوحته الدامعة.
ثم ينتقل إلى خاطر آخر :
أم يـاتـرى مُـقَـلُ الـسـماءِ هـواملٌ...مِــمـا ألـــمَّ بـمـوطـني الـمـوجوعِ
حيث ينتقل الحزن للطبيعة، لتصبح أما أكبر للوطن المفجوع
ثم ينتقل الشاعر إلى الأعم والمطلق:
مـطـرٌ ويـرسمهُ الـزجاجُ قـصيدةً...آهــاتُــهـا مــعــزوفـةٌ بــضـلـوعـي
حيث يتحول الحزن إلى قصيدة... قصيدة محفورة بوجدان الشاعر لا تكف عن سكب الدموع، وتتحول الأضلاع إلى أوتار يعزف عليها الحزن أوجاعه، حيث صار الحزن تغنيا من شدته.
وهكذا يتحول الشاعر من الخاص إلى العام إلى الأعم تاركًا قصيدته أو مقطوعته تحلق في المطلق بنجاح كبير، لولا بعض المباشرة في صياغة بعض الجمل، ومع ذلك لا نكاد نشعر بها، لثقل الحالة وسيطرتها على مناخ النص.
ومرة أخرى يعبر النص عن أن أدب الحرب لا يستدعي بالضرورة النبرة الحماسية، بل قد يلجأ إلى الهمس الشعري الجارح في هذا النص، وكما رصدنا هذه الظاهرة من قبل لدى شعراء آخرين عاشوا نفس الواقع المأساوي، نرصدها هنا أيضا، مؤكدين أن الشعر هو الصلة الوثقى والعميقة بالحياة، وهو النزيف الأبدي الدائم أمام مؤثرات الحياة يسترجعه الشاعر في لحظات حزينة وعميقة، وقد يفور في لحظات أخرى أكثر التهابًا كنهر جارف كاسح. في كل الأحوال لا نرجو من الشعر سوى أن يكون صادقًا وعميقًا ومستوفيا للحالة التي يتناولها وفق قانون اللحظة وأدوات الشاعر الفنية. فنحن هنا أمام حالة خاصة من التماهي وذوبان الذات في الواقع، وذوبان الواقع في الذات تنتج لنا هذا النص المؤثر.
***
ولأن الديوان كله يمثل حالة، وتعد كثير من قصائده امتدادا لهذه الحالة الطللية التي تسيطر على أرض الواقع والقصيدة، نجد الحالة السابقة تمتد في القصيدة التالية أو المقطوعة التالية، بعنوان "صهيل الشوق"، وهي قصيرة أيضا كالسابقة تبلغ خمسة أبيات فقط:
وغـادرتُ الـديارَ وكانَ صمتي
ضـجيجَ الـروحِ مـابينَ الترائبْ
ولـملمتُ الـغُبارَ وحـزنُ بيتي
وطـعمُ الـقهوةِ السمرا يعاتبْ
وحَـبُّ الهالِ يدمعُ في وداعي
كما الصبحُ الذي يبكي الركائبْ
وذكـرى من صبايَ غدتْ ركاماً
يـدثِّرُها المشيبُ معَ المصائبْ
وألجَمَتِ الدموعُ صهيلَ شوقي
فأسْرَجْتُ الحنينَ على الحقائبْ
ولنلاحظ هنا كيف يخلخل الشاعر بنية القصيدة تعبيرا عن خلخلة الواقع وزلزلته، من خلال بنية الحركة والسكون، والصمت والصوت في مطلع النص:
وغـادرتُ الـديارَ وكانَ صمتي
ضـجيجَ الـروحِ مـابينَ الترائبْ
مشهد مغادرة الديار هو المشهد الأم في أكثر من عمل للشاعر، لا يغادر مخيلته أبدًا، والحق أنه مشهد أسطوري يفيض بالدمع والحزن وأهوال الفجيعة، ولا يني يسترفد كل المشاعر المصاحبة لهذا المشهد في أكثر من قصيدة وبيت، ويستقطر مشاعره التي لا تنتهي. وهو يخلخل المشهد من خلال اشتباك الحركة والسكون (غادرت الديار× صمتي) المغادرة حركة، والصمت همود وسكون، ثم من خلال اشتباك مزودج (كان صمتي×ضجيج الروح) حيث الصمت الظاهري، والتفجر الداخلي ... هكذا يخلخل الشاعر بنية الشعر ويمنحه حيوية عن طريق هذا الازدواج ليعبر ببساطة آسرة عن واقع داخلي استثنائي. مع حساسية مفرداته المنتقاة ( ما بين الترائب) ما يوحي بالاختناق، فالضجيج الداخلي يرتفع صعدًا حتى درجة الاختناق وعدم التحمل.
والبساطة الآسرة من سمات شعر أحمد ظاهر فشعره –غالبًا- شعر البساطة الآسرة، ويعد ملمحًا مهمًّا في شاعريته. حين يجيده يحول القصيدة إلى رحيق ساحر، وحين يتفلت منه قد تهوي القصيدة إلى المباشرة والنثرية. لذا عليه أن يراعي حساسية مثل هذا الموقف، وهو وغيره ممن يتخذون نفس النهج الشعري.
وإذا عدنا للنص.. وعلى ذكر الحالة الطللية، نجد هذا المشهد أيضا :
ولـملمتُ الـغُبارَ وحـزنُ بيتي
وطـعمُ الـقهوةِ السمرا يعاتبْ
يا له من تعبير بسيط وعجيب (لملمت الغبار) هل هو غبار الروح المضطرمة شجنا وهياجا؟ هل هو غبار الحارات والشوارع يعبئه في الحقائب يتنسم رائحته كلما حن؟ هل هو غبار الأطلال الذي يملأ الجو مغبَّرًا بدخان آلة الحرب العملاقة؟ الإجابة مفتوحة...
ثم تأتي تقنية المشاهد التي يلجأ إليها الشاعر كثيرا والتي تسعفه في استرجاع اللحظة، وكثيرا ما يكون الشعر شعرا بهذه التقنية خاصة عبر كل عصوره، سابقًا بها فنون السينما والدراما، يقول:
وذكـرى من صبايَ غدتْ ركاماً
يـدثِّرُها المشيبُ معَ المصائبْ
تحول الذكرى إلى ركام أيضا صورة طللية صعبة، لأنها تتجاوز مرحلة الطلل إلى مرحلة المحو, ما يقفز بالشاعر إلى مرحلة من المشيب المبكر.
***
وكما بين الشاعر والواقع صلة وثيقة، كذلك بينه وبين الشعر صلة وثيقة، لأن كليهما واحد في الحقيقة، فمن أبيات تحت عنوان "القصيدة" يقول:
إنَّ الـقـصيدةَ
حـين يـكتبها الـعنا
حـتماً سـيأتي
في مواكِبها
السّنا
وكأن القصيدة تكافئ صاحبها، تحول سواد الحزن إلى بهجة ونور ولو حزين، الشعر يعالج الروح، روح صاحبه وروح متلقيه، وهذه قضية خطيرة، تفسر لك كيف يدمن الناس الشعر والفنون كتابةً وقراءةً وتلقيًا.. وهذا أمر توفره الفنون ولا توفره أشهر العيادات النفسية. لأن الفن يخاطب في النفس منطقة إلهية ملغزة، بما أنه نفحة من الله، ونحن فينا جزء إلهي خَلقي، حينما نفخ فينا من روحه، بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، والمعنى كما أراد. القصيدة تعالج هذا الجزء الإلهي: الروح.
وهذا يعني –أيضا- أن القصيدة تكتب الشاعر كلما كتبها، وتلك هي ثنائية القراءة (يـكتبها الـعنا ×في مواكِبها السّنا)، فكأن القصيدة تعيد صياغة صاحبها نورًا، تكتبه نورًا، ترتقي به جماليا وذوقيا، وكل قصيدة إن لم تفعل هذا فليست بقصيدة حقة، هي نتاج جمالي فحسب، بحسب هذه القراءة، وبحسب رأيي القصيدة.. قاصدة ومقصودة، قارئة ومقروئة، كاتبة ومكتوبة، بهذا التفسير.
ولذا يتفاءل الشاعر بالقصيدة، ويريد أن يعطيها كما تعطيه:
طوعاً
سأمـزجُ مـن دمي
بترابها
طـيباً
وانـفخُ عِطْرَ روحيَ
سوسنا
هو يبغي التوحد، حتى الإنبات، ومن هنا فالمعجم ارتقائي: أنفخ- عطر- روحي- سوسنا.
ولأن الشعر والفن الحقيقي يمنح الإنسان طاقة نادرة وليس مجرد كلمات عابرة، ينقلنا الشاعر –لا شعوريا- إلى الجانب الإيجابي في الإبداع :
وأُحيكُ ضوء
الشمس ِ
في رُدهاتها
وأصوغ ُ
من صخر ِ
المُحالِ
الممكنا
الشعر –في تصوري- طاقة إلهية نادرة وإذا كان الأمر كذلك، فهي قادرة – بما أنها كلمة خاصة ذات فاعلية خاصة- على منح الوجود طاقة إيجابية كبيرة ذات زخم شعوري وروحي ورؤيوي. ومن ثم يبلغ الشاعر بالمعجم الارتقائي للمفهوم الشعري الذروة مع ختام النص.
***