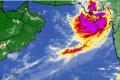أ.د/ إيمان محمد أمين الكيلاني - الجامعة الهاشمية – الأردن
في الوقت الذي نغني فيه لطفلنا في مهده عن طير الحمام, وريش النعام , ثم نصرِّحُ بعد ذلك أننا نكذب عليه لينام، مستخفِّين بعقله، زارعين في لاوعيه وذاكرته الأولى الأحلام الكاذبة التي تداعب المعدة لا الوجدان، هذه التهويدة التي من شأنها أن تدعو إلى نوم عميق، وطير موعود ليؤكل، كانت تهويدة جيل النكسات المتعاقبة، جيل النوم في أعماق الديجور، في حين كان "فرخُ" تشيرنخوفسكي شاعر الصهيونية الأول في قصيدته" تهويدة مهد" يُربَّى على حلم الاستيلاء على الأردن وحمل السلاح لتحقيق حلم الصهيونية؛ ليصبح جارحاً يقظاً فقد كتبها شاؤول في أوديسا بـ"روسيا" عام 1896م، أي قبل تأسيس دولة إسرائيل بـ"52" سنة، رسم المستقبل للطفل الصهيونيّ، فكان بتفصيلاته كما أراد، وكما أرادت الصهيونية، وحقق الجيل الذي تربّى على شعره حلمه. وبالمقابل نرى هنداً بنت عُتبة قبل ألف وخمسمائة عام تهدهد وليدها وهي ترقصه بتهويدة الماجدين، بل "تعويذة الماجدين":
إنّ بُنيَّ مُعَــــرِقٌ كـــريم
محــببٌ فـي أهـله حــليمٌ
ليــس بفحَّــاش ولا لئـيم
ولا بِطُخرورٍ ولا شـؤوم
صخرُ بني فهرٍ به زعيمٌ
لا يُخلِفُ الظن ولا يَخـيم
إن هذه التهويدة من الأدب المُوَّجِّه الذي من شأنه أن يزرع قيماً خاصة, وشخصية خاصة كما أرادتها الأم الحرة لوليدها، وهي تنطلق من قيم المروءة العربية القبلية، فهي تُعزّز في الطفل منذ نعومة أظفاره التميز، ولكن دون أن تُحوِّل هذا التميزالى تمييز عنصري ضد الآخرين، وتعلمهم قيم الفروسية والبطولة، ولكن ليس ضد أحد أو جنس أو قوم، تعلمه فضائل الأخلاق والزعامة دون أن تزرع فيه الحقد على غيره. إن مثل هذا الأدب الإيجابي إنما ينصب على صناعة الطفل نفسه، وتزويده بأدوات التفوق دون تزوير أو تلفيق أو كذب وأول هذه القيم التي تزودها أم قررت أن يكون ابنها سيداً لا لقومه فحسب، كما كانت النبوءة والفراسة، بل لغير قومه أيضاً – صفة العراقة في الأصل، فهو امتداد لذلك الأب الحر الذي اختارته، وهو امتداد لها هي الأم الحرة التي تأبى الدنيّة، ولا ترضى لولدها كما لم ترض لأبيه من قبل أن يقعد عن مكرمة أوشرف، فقد روي أن ملك اليمن أهدى "عشر جزائرَ إلى مكة، وأمر أن ينحرها أعزّ قُرّشي، فَقَدِمَتْ وأبو سفيان عروس بهند بنت عتبة، فقالت له: " أيها الرجل، لا يشغلنك النساء عن هذه المكرمة التي لعلها تفوتك، فقال لها: يا هذه دعي زوجك وما يختاره لنفسه، والله ما نحرها غيري الا نحرته، فكانت في عقلها حتى خرج أبو سفيان في اليوم السابع فنحرها" .
وفي الوقت الذي تؤكد فيه في الشطر الأول من البيت عراقته وكرمه نراها تتبع ذلك صفتين تحدان هذه العراقة والكرم، وهما صفتان تمنعان أن تنتفخ الأنا، فتصبح مرضاً يتجاوز حد العزّة الى الغرور؛ لذلك هو يجمع الى ذلك شيماً تجعله محبباً في أهله مقابل هيبته في غيرهم، وهو وإن كان جريئاً على غيرهم فإنه حليم عليهم، يذكرنا بالميزان العاطفي الإلهي الذي أراده للمسلم أن يكون عليه "أشداء على الكفار، رحماء بينهم"، إنها لغة مُتّزنة متوازنة تحرص على أن يجمع سيد المستقبل إضافة إلى الإحساس بالعراقة منظومةً قيميّة. إن هذه الكلمات على قلتها تتضمن دستوراً كاملاً للقيم العليا التي تطمح كل حرة أن تكون في ولدها، فليس بغريب إذاً أن تكون هند واثقة من ولدها، وقد ربَّته من لحظاته الأولى؛ ليكون سيداً يجمع المجد من أطرافه.
وفي يوم ما "سُئلت هند عن معاوية فقالت: والله لو جُمِعَت قريش من أقطارها ثم رُمِيَ به في وسطها لخرج من أي أعراضها شاء".
لقد اختارت لابنها أن ألا يسود قومه فحسب، بل العرب جميعاً، بل الدنيا. ورسمت له وخطت طريقه، وزرعت في لاوعيه تلك القيم وهي ترقصه على أنغامها لتزين دلالتها في نفسه؛ فتصبح قيمة قيّمة راسخة ومبعثاً وراسخاً في المستقبل. أرادت له أن يكون سيداً مذ كان طفلاً فلقنته ذلك، وزرعته في كفايته وكانت كما أرادت له أن يكون. فطوبى لهند، ولمن كانت كهند.
وعليه فإنه ليس كما يرى بعض الباحثين أن أدبنا العربي القديم "قد خلا من أدب الطفولة باستثناء ذلك الأغاني الموسومة بـ" أغاني المهد"، أو أغاني ترقيص الأطفال" والتي تكثر في كل اللغات، وتنتشر بصفة خاصة في اللهجات العامية، وإذا جاز القول بأن تلك الأغاني تشكل نوعاً من أدب الأطفال, فهو أدب تنغيميّ قد يهم الموسيقيين ودارسي الألحان الفلكلورية "ربّما" بما يهم الدارسين من الأدباء ..."
إن القيم التي تلقن للطفل وهو يُرّقص، بكلمات ذات إيقاع خاص، تصبح تلك القيم مرتبطة ارتباطاً وجودياً، لا تُمحى ولا تزول، وهذه الأغاني من الأدب سائر مألوف منذ الجاهلية يسمى "التزفين" حفظت لنا كتب التراث منه ما يكفي لدراسته وتحفيظه لأطفالنا.
ثم إن كثيراً من الشعر العربي كان يلَّقن في الأصل للأطفال، حسب أعمارهم ومراحلهم، وكثير منه يخاطب به الابن أو الابنة، وقد كان العرب من الجاهلية يصنعون الشعراء صناعة بأن يُرَوُوهم الشعر، ثم بعدها تتفتق قريحتهم عن إبداع خلاّق. وليس أدل على ذلك من قول السيدة عائشة – رضي الله عنها- "روّوا أبناءَكم الشِّعرَ، تُعذُبُ ألسِنَتُهم".
وبعد, فهل تنتج السادةَ والأشرافَ نساءٌ لا تنظر إحداهن الى نفسها على أنها أكثر من مجرد دمية، ولا هم لهن سوى ملاحقة الصرعات المستوردة من زي ومكياج لا يليقان – في كثير من الأحيان – بقيم الشرف؟ وهل تربي الأحرار امرأةٌ تجزع لظفرها الطويل حين ينكسر وتبكيه، في حين لا يرّف لها جفن,، وتستمر في برد أظافرها وتلوينها وهي ترى أمتها تنكسر وتنهار؟ وهل يصنع الفرسان والأحرار رجالا لا يهمهم من الحياة إلا النساء، ولا يهمهم من النساء إلا المنظر دون المخبر، والشكل دون العقل، ولا يكلفون بمنبت أو منشأ أو ثقافة.....الخ؟ وهل تصنع أغاني الصغار التافهة التي تتردد على أسماعنا ليل نهار، بل وأغاني الكبار- بشراً سوياً؟ وهل سيظل مصدر الثقافة الأول عندنا في هذا الزمان يقدم ثقافة الطبل والزمر، وثقافة التعري وقرقعة القدور التي لا تصلح سوى لهز الخصور، وتمييع الأمة ثم تضييعها رجالاً ونساءً؟ وهل سنظل نصنع من طفلنا الذكي إنساناً متخلفاً عندما يكبر؟ وهل سنظل نقدم الغث له بدعوى أن عقله الصغير غير قادر على أن يفهم الفصيحة أو المضمون الهادف؟ وإلى متى سنظل نربي أولادنا على غير بصيرة، نربيهم كما تربى الخراف للتسمين ثم للذبح؟ ومتى ندرك أن المستقبل كله رهين بتثقيف طفلنا الثقافة النزيهة الحقيقية؟ ومتى نعود الى الذات فنقرأ تراثنا قراءة واعية، ونستلهم منه منظومتنا التربوية الخاصة؟