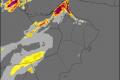محمد علي العوض
في إحدى جلسات البرلمان المصري والتي خُصصت لمناقشة أحكام قانون العقوبات الخاصّ بقضايا النشر والنصوص الخادشة للحياء العام؛ وصف أحد نوّاب البرلمان المصري أدب نجيب محفوظ بأنّه "خادش للحياء".. في إشارة منه إلى روايتي "السكريّة" و"قصر الشوق".
المثقفون المصريون قابلوا حديث النائب البرلماني بموجة من الرفض والاستنكار، حيث عدوا ذلك الوصف إهانة تاريخيّة لنجيب محفوظ خاصة وللأدباء العرب على وجه العموم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد انبرى مجلس الوزراء لحديث النائب وأصدر تصريحا رسميًّا علق فيه على الحادثة قائلا: "نجيب محفوظ قامة عالميّة ثقافيّة كبيرة لا يمكن إهانتها"..
حديث النائب أخرج المارد من قمقمه فقد غصّت الملتقيات الأدبية وصفحات الصحف والمواقع الإسفيريّة بالكتابات التي طفقت تتناول أعمال محفوظ وقراءتها من وجهات نظر نقدية جديدة..
تساءلت الكاتبة العمانية نادية اللمكيّة في مقالتها المنشورة بمجلة آفاق أخرى: هل للأدب قواعد أخلاقيّة عامّة لا يجب على الأديب تخطّيها؟
قائلة إنّ هذا المشهد المصريّ يذكرها بثورة المجتمع العماني على مجموعة قصصية لاقت الامتعاض نفسه؛ في إشارة منها للمجموعة القصصية "ملح" لبدرية الإسماعيلية، والتي نفذت منها إلى أنّ الخطاب المُوجّه للمرأة لم يتجاوز جسدها، وأنّ المتعة هي التي تحدد مسار خطط الرجال- وأضافت أنه بالرغم من كون القيمة الأدبية بينهما بعيدة جدا، إلا أن الحديث الأهمّ هنا هو حول مستويات التعبير الأدبي عمّا يعدّه المجتمع "مسكوتا عنه"، مع الإشارة إلى أنّ تحديد مستويات مختلفة وتفضيل أحدها على الآخر لا يتنافى مع الحريّة التي يجب أن نبقيها للأدب. ورأت أنّ الإبداع الأدبيّ يكمن في توظيف اللغة الرمزيّة والجماليّة لوصف أو سرد أو تحليل ما يودّ الكاتب الحديث عنه، حتى تلك المشاهد التي يرفض المجتمع عرضها، بينما يريد منها الأديب "تصويرا للواقع أو لما يشعر به" لا تستوجب الإغراق العميق بالطريقة التي تفقدها جماليّتها وتخرجها من "المتعة الأدبيّة" إلى "السطحيّة والمباشرة".
وتخلص اللمكيّة إلى أنّ مطالبة الأديب بأن يكون وصيّا أخلاقيّا على المجتمع، أو أن يقوم بدوره في ترسيخ الأخلاق والقيم، أو أن يراعي قواعد الآداب فيما يكتب هو خروج بالأدب عن جوهره، ليصبح الأديب في مرحلة ما مقيّدا بأطر المجتمع والثقافة والدين، ويصبح ما يكتبه انعكاسا مباشرا لما يحدث لا قراءة أخرى له. لكنّ هذا كله لا يجعل الأدب منسلّا من دوره الأهم؛ وهو تشكيل الوعي عبر "خلق الاتجاهات وترك الترسبات"، أو عبر رسمه صورة الحياة والكون وما بعدهما، أو من خلال استنهاض الشعور الإنساني، وهو -فيما ذكرنا وفي غيره- لا يقدم دوره بصورة مباشرة، بل تظهر انعكاسا لتصورات الأديب واتجاهاته وخبراته، ما يجعل العلاقة بين ما يكتبه على أنّه أدب متحرّر من سلطة ما حوله وبين ما يؤديه هذا الأدب من دور؛ علاقة غير قابلة للانفصال.
ووجدت اللمكيّة الموقف فرصة للنظر للوجه الآخر من الأدب؛ وهو النقد فقالت: إذا كنّا نتحدث عن الحريّة التي يجب أن يمنحها المجتمع للأدب، نتحدث أيضا عن مستوى الحريّة التي يجب أن تمنح للنقد بمعناه السّهل الذي يراد منه "الكشف عن مواطن الجمال والقبح في العمل الأدبي"، وعلى هذا فإنّ كل النصوص الأدبية مشرعة مسبقا للنقد؛ إذ تصبح المعاني ملكا لقارئها وذلك بمجرّد نشرها بعدما كانت فكرة أو شعورا في ذهن الكاتب، وللقارئ الحقّ في الفهم والتحليل والتلقي ما دام يمتلك أدواته بالطبع، ومن أدواته الأوليّة؛ الذوق الأدبي، والقدرة على فهم الرمز، وقراءة العمل كاملا في إطاره الزمني والمعرفي مصحوبا بجملة من الأخلاقيات التي يجب توافرها في الناقد مثل: البعد عن مهاجمة الكاتب أو تجريحه؛ فمعيار الحكم والنقد هو جودة النصّ لا أخلاق الكاتب، وأنّ حريّة النقد كما حريّة الأدب تستلزم وسطيّة، لتلتقي كلتاهما في نقطة المنتصف التي تمثّل "القيمة الفنيّة".
حديث اللمكيّة يعيدنا للجدل الأيديولوجي حول نظرية "البرناسية" أي "الفن للفن" وهي ضرب من الفلسفة اللادينية قائم على نبذ القديم وعدم التقيّد أو الاحتكام إليه في الأدب، وهو مذهب مضاد، ثائر على "الواقعية" وكذلك "الرومانسية" التي ترى أنّ الأدب وسيلة للتعبير عن الذات، بعكس "البرناسيّة" التي ترى أنّ الفن غاية في حد ذاته ومطلوباً لذاته ليس إلا؛ وبذا تجرّد الفن من ملابسات النص كالقيم الفكريّة والفلسفيّة والدينية، وتستبدله في المطلق بالقيمة الجمالية لا غير، وحجّتها في ذلك تخليص الأدب من النفعية والغائية، وتحريره من أي قيمة عدا الجمال، وألا يُنظر إليه من منظور أخلاقي أو ديني، لأنّ أس الأدب الجمال والإبحار في عوالم التخييل لا خدمة الأخلاق، أو تجذير قيم الخير في المجتمع، وبتعبير إبراهيم حجاج: "قطع الصلة بين الأدب والمجتمع".
فعلى علاتها قدّمت نظرية "البرناسية" لعلم النقد الكثير فمن رحمها خرجت الحداثة وشكلانيّة "فلاديمير بروب" التي اعتبرت أنّ الأثر الأدبي منفصل عن السياق التاريخي الذي نشأ فيه، وكذلك تمخضت عنها البنيوية والمنهج الأسلوبي اللذان ينطلقان من منطلق الحكم على النص الأدبي من زاوية لغويةّ، وأيضًا السيميائية وتفكيكية رولان بارت وجاك دريدا؛ وإن كان ذلك لا يغمط دور هذه المناهج الأدبية في تطوير التفكير العلمي في مجال اللغة في مختلف وظائفها؛ لاسيما في فن السرد.
إنّ أدباً لا يحمل مضموناً لا يمكن أن يجد قبولاً، وكيف يُقبل كلام لا معنى له ولا فائدة من ورائه؟ فالقارئ لا يمكن أن يستمر في قراءة شيء لا يفيد أو لا يجذب. وما الفائدة من أدب يتوخى فقط القيم الجمالية دون أن يصور عذابات الإنسان وتشظّيه وحاجاته المجتمعية والحسيّة..
في كتابه "مقالات في الأدب والنقد" تساءل وليد قصاب عن (لماذا لا يجتمع في الأدب الأمران معاً؟ لماذا نُصرُّ على أن نُبعد الأدب عن أي نشاط معرفي آخر كالدين أو السياسة أو الاجتماع أو علم النفس أو ما شاكل ذلك وأن نقصره على اللغة؟ الأدب مثلما هو فن جمالي يقوم على لغة باهرة خارجة عن المألوف تتسم بالطرافة والإدهاش فهو كذلك تجربة إنسانية عميقة، تحمل للمتلقي خبرات بشرية عظيمة، والناس لا يقرأون الأدب لذاته فحسب، ولا يقرؤونه للمتعة وحدها أيضا، بل يقرؤونه للمتعة والفائدة معاً.. وماذا يمنع؟!".
كما أنّ هذا الفصل من شأنه أن يخلق فجوة ما يعرف بـ "أزمة التلقي" أي أزمة فهم النص، وجعله (متاحًا فقط أمام أولئك الذين يملكون القدرة على تحليله في سياق الإبداع البشري المجرّد فقط، وهذا كلّه سيؤول بالأدب لفئة محددّة، وعندها لن يصبح المجتمع قادرًا على التجاوب معه).