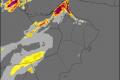أ.د/ إيمان محمد أمين الكيلاني
الجامعة الهاشمية – الأردن
يظل النص القرآني إبداعًا خاصًا، لا تفنى ديباجته، ولا تبلى دلالاته، ولا تنفد لآلئه؛ يستمد لامحدوديته وعظمته وخلوده من أن مبدعه بديع السموات والأرض الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، وأن القرآن هو كلامه – سبحانه - المتعبَّد بتلاوته بلسان عربي مبين إلى يوم الدين، اختار له أبدعَه بيانَا، وأنصعه لفظًا، وأدقه تركيبًا، وأوفاه حرفًا، وأجمله لحنًا، أودع فيه شريعته لتكون منهجَا ونبراسًا يُستضاء بها في رحلة الإنسان من الدنيا إلى الآخرة، لكل زمان ومكان؛ وأودعه من أسرار العربية ما يكشف عنه لكل أهل زمان بما ترتقي إليه عقولهم، وما يجِدُّ في حياتهم، فلا تنقضي عجائبه، ولا تمضي فرائده .
فالباحث الأسلوبيّ يبدأ تحليله للعمل الأدبي من ملاحظة تبدهه ويشعر بأهميتها، ثم يتتبع السمات اللغوية المشابهة، وبناءً على ذلك يفترض تفسيرًا داخليًا "نفسيا" لتلك الظواهر الخارجية، ثم يعود إلى النص ليرى إن كان هذا التفسير مستقيمًا مع سائر جزئياته، ويمكن أن يكرر هذه الحركة بين ظاهر النصّ وباطنه عدة مرات حتى يستقيم له التفسير، أو يصل إلى "الشمس المركزيّة" الخاصة بالعمل الأدبي ."
ولما كان النص الأدبيّ هو أهم معبر عن روح هذه الأمة، كان القرآن الكريم باعتباره مصدر التشريع الإلهيّ هو أنصع نص يعبر عن روح الأمة، ويكشف عن أحوالها ورؤاها ومنطلقاتها ومعتقداتها، ومن هنا كانت العناية بسياقات النصّ المتعددة ومن زوايا مختلفة، كل سياق يسلم إلى سياق أكبر، فالآية الأولى في (سورة النور) مثلا تنبىء بالإيضاح والإبانة، وقبل أن تبرّأَ السيدة عائشة من حادثة الإفك يأتي الحكم في الزنا؛ وفي ذلك إرهاص إلى أن لاهوادة ولامجاملة من الله لأحد، ويأتي تحريم الخطايا ووضع الحدود وهي تحوّلات بمجملها من ظلام معنوي إلى نور معنوي حتى يجتمع الاثنان: النور المعنوي ونظيره الحسيّ، وما يقابلهما في بؤرة السورة، ثم الحديث بعدهما عن آداب البيوت والاستئذان على أهلها وفيها، في دوائر كبيرة تأخذ بالتضيق شيئًا فشيئًا لتلج في داخل النواة الأولى للنور أو الظلام، إنه البيت وما فيه من أدبيات تقرب بين البيت المسجد والمسجد البيت بما يضمن الطهارة وانتصار النورعلى الظلام، وهو ما اقتضى أن تسمى بهذا الاسم، غير أن فهم دلالات النور وإيحاءاته المتعددة يرتبط بالسياق الأكبر وهو القرآن كاملًا وهو أمر شكل منهجية واضحة واعية لدى المفسرين. "قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولًا من القرآن؛ فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في مكان آخر منه, وقد ألَّف ابن الجوزي كتابًا فيما أجمل في القرآن في موضع، وفسر في موضع آخر.... فإن أعياه ذلك طلبه في السُنَّة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وقد قال الشافعيّ - رضي الله عنه - : كل ما حكم به رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فهو مما فهمه من القرآن.... فإن لم يجده في السُنَّة رجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرآن والأحوال عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التَّام والعلم الصحيح والعمل الصالح ."
"وقيل: الحكمة في تسوير القرآن سورًا تحقيق كون السورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله والإشارة إلى أن لكل سورة نمط مستقل ."
واشترطوا في المفسر: صحة الاعتقاد أولًا، ولزوم سُنَّة الدين، واعتماده على النقل عن النبي – صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه مرجحًا بعض آرائهم إن اختلفوا، واشترطوا أيضًا صحة المقصد فيما يقول ويتم له ذلك زهد في الدنيا، " وتمام هذه الشرائط: أن يكون ممتلئًا من عُدة الإعراب، لا يلتبس عليه اختلاف وجوه الكلام، فإنه إذا خرج بالبيان عن وضع اللسان، إما حقيقةً أو مجازًا، فتأويله تعطيله!....فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم، كالطب والحساب، ولا يستشرحونه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتُهم، وبه نجاتُهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ."
إن لغة النص الأدبي ليست قسرية، وإنما هي اختيارات المبدع ضمن ما تتيحه اللغة بما فيها من إمكانات متعددة ووسائل متنوعة، وإذا كان هذا من المتاح لذي الملكة الخلّاقة من البشر، فكيف إذا كان المبدع متفردًا لا محدودًا، هو خالق اللغة ومبدعها؟
ووظيفة المتلقي للنصّ تنصرف إلى الكشف عن "تجربة خاصة ذات اتجاهين متقابلين: أحدهما يذهب من الذهن إلى الأشياء الواقعية، والآخر من الأشياء الواقعية على الذهن، وفهم النصّ يتوقف على الإدراك الجيد لهذه الحركة المزدوجة التي تئول في النهاية أيضَا إلى مانسميه بـ"الشكل والمحتوى".
كما أن البنية اللغوية في النَّص القرآنيّ مقصودة في ذاتها فمن ذلك مثلًا في سورة النور، ما نجده من مجيء الشهادة الخامسة من الرجل الملاعن لزوجه بـ(والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)، ومجيئها من الدارئة (الزوجة): (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)، فلم يوحد بينهما في العقاب، فلم يأت باللعن أو الغضب وحده، فباين بينهما فقط في هذه، وقد تنبّه إلى هذا بعض المفسرين وعللوه بـأن "النساء يستعملن اللعن كثيرًا كما قال لهن النبي – صلى الله عليه وسلم: "لأنكن تُكثرن اللعن وتَكفرن العشير" فربما يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن، وسقوط وقوعه في قلوبهن، فذكر الغضب في جانبهن؛ ليكون رادعًا لهن ."
و"اللعن هو الطرد من الرحمة، والغضب هو إنزال العذاب مع المقت" ، والغضب "إذا وصف الله به فهو الانتقام دون غيره"، فلا شك بأن الغضب عقاب أشد من اللعن، فإن كان اللعن حرمانًا للعبد من رحمة الله، فإن الغضب يزيد عليه بإنزال السخط، ولسنا نرى ما ذهب إليه بعض المفسرين – آنِفًا - وأحسب أن السبب الذي يرشحه السياق هو أنه في حال ادِّعاء الرجل على زوجه كاذبًا يكون قد ارتكب خطيئة واحدة هي اليمين الكاذبة، أما في حال كونه صادقًا تكون قد ارتكبت خطيئتين:الزنا، واليمين الكاذبة، فاستحق اللعن واستحقَّتْ الغضب، ولعل الغضب أيضًا يفسر من هذا السياق على أنه ضِعْف الّلعن .