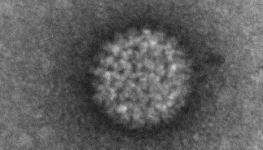نوف السعيدي
جنوسة العلم
في كتاب "أنثوية العلم" تطرح ليندا جين شيفرد فكرة أن العِلم مذكر، حيث جُعلت صفات الذكر القصوى هي الصفات المثالية للعالِم، بذلك أوجد علماء من النوع الذي يدمر الأرض بقدر ما يخدم البشرية إثر غياب المسؤلية الاجتماعية للعلم. تقول الكاتبة: "انعكس الوعي الذكوري في هذه المؤسسة -أي مؤسسة العلم- لأن الغالبية العظمى من العقول المسؤلة عن تشييد العلم كانت ذكورا... لقد رفع قيمة الموضوعية؛ فالعواطف البشرية تعرقل انتظام التفكير... إن المقاربة العاطفية للمباحث العلمية تجعل المجال مفتوحا أمام العالِم لتحريف تأويل المعطيات وتفقده ثقة الآخرين بعمله. لا يثق رجل العلم إلا بما يستطاع قياسه وإعادة إجرائه بطريقة يمكن التعويل عليها "[1]
بالمختصر فإن ليندا تقدم تصورا مفاده أن بالإمكان جعل العلم أكثر كفاءة من خلال تفعيل الخصائص الذكورية والأنثوية على السواء.
الأنوثة في الشعر
هناك فرق في الطريقة التي ينظر بها الشعراء إلى الأنوثة. ففيما يرى محمود درويش أن المرأة كاملة بحد ذاتها، على سبيل المثال هو يقول في قصيدته "لا أنام لأحلم" بلسان الأنثى:
"أنام على جسدي كاملا كاملا...
لا شيء ينقصني في غيابك...
كل ما فيّ لي"
بينما يرى نزار قباني أن الأنوثة حالة يصنعها الشعر أو الشاعر، وأنها -أي الأنوثة- بمعزل عن من يكشف هذه الصفات ويخرجها فإنها تبقى خرساء أو أنه ينتفي وجودها حتى، فهو يقول:
"كنتِ يا سيدتي خرساء قبلي.."
ويقول في قصيدته الشهيرة "كلمات":
"يسمعني حين يراقصني .. كلمات ليست كالكلمات
كلمات تقلب تاريخي .. تجعلني امرأة في لحظات"
ويبدو أن هناك شعراء آخرون يتفقون مع قباني في هذه الفكرة، يقول أحمد بخيت في سياق مشابه:
"وحين أحب سيدة أحولها لموسيقى"
هل الأنوثة إذا هي مجرد حالة مؤقتة؟ وهل سيعني ذلك أن ليس كل امرأة هي أنثى؟ وبالتالي وبطبيعة الحال فإن الطفلة والعجوز تنتفي عنهما صفة الأنوثة. فكرة أن "الأنوثة" تحددها ذائقة المجتمع نقدها عبدالله الغذامي في كتابه "المرأة واللغة" فيقول "يجري إخضاع الجسد لشروط الثقافة ويتم تنحيفه والتدخل في تكويناته الطبيعية من أجل إعادة صياغاتها حسب شروط الجمال المعتمدة ثقافيا"[2]. لكن نحن لسنا بصدد نقد الظاهرة وإنما في محاولة تسجيلها كما هي في ضمير المجتمع.
الجنوسة باعتبارها بنية ثقافية
يبدو جليا أن ثقافة المجتمع هي ما يحدد صفات تمايز الذكر والأنثى؛ لذلك نجد أن هذه الصفات تختلف من مجتمع لآخر، بل أنه يحدث أن تنعدم هذه الفوارق تقريبا في المجتمعات البدائية.
ولكن إن كان من الصعب لمس وقياس الفوراق الثقافية، فإن هناك فوارق بيولوجية لا يمكن إنكارها، وإنها قد تكون مساهمة في صنع الفوراق الثقافية، فالمجتمع تطور بطريقة تجعل الاختصاصات متلائمة والقدرة البدنية؛ لذلك كان الرجل يذهب للصيد والمرأة تبقى مع الصغار، ثم كان هو من يذهب للعمل وهي للبيت، هو للحروب وهي لرفاهية الحرير.
مع تطور الحياة العصرية أصبحت "الآلات" تلعبا دورا مهما وتقوم بمهامنا في كثير من الأحيان، وأصبحت البنية الجسدية لا تشكل ميزة مهمة -نقول "ميزة" لأنه تم استغلالها لفترات طويلة للسيطرة على الثقافة العامة وتوجيهها- وقوة الرجل البدنية لا تخدمه لأننا في عالم يحدد العقل فيه قيمة الفرد، وأصبح وجود المرأة ضروريا في تعزيز اقتصاد الدولة واقتصاد الأسرة. لماذا لم يتخلص الإنسان إذن من فكرة التمايز على أساس الجنس؟
يقول العظم: "إن عناصر الرجولة والأنوثة تشترك معا في تكوين كل إنسان (ذكرا كان أم أنثى) وتدخل في بنيانه الفيزيولوجي والسيكولوجي بنسب مختلفة، مما يبين أن الفارق بين الرجولة والأنوثة ليس فارقا نوعيا قاطعا، كما هو شائع، بل فارق كمي يتحدد بنسبة سيطرة عناصر معينة على بنيان الفرد."[3] يمكن الخروج من هذا بخلاصة أن كلاً من قيمة الذكورة والأنوثة متغيرة، وهذا التغير الدائم يستدعي محاولة المراقبة والتتبع ليسهل على الفرد فهم هويته الجنسية، هذا الفهم يحتاجه كل من الإناث والذكور على السواء، ليتماشى مع تغير أدوارهما بتغير الظروف وطراز العيش.
[1]ليندا جين شيفرد، أنثوية العلم، ترجمة يمنى طريف الخولي، الكويت 2004
[2]عبدالله الغذامي، المرأة واللغة (2)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء
[3]صادق جلال العظم، في الحب والحب العذري، دار العودة بيروت - الطبعة الثالثة 1981