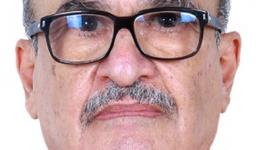د. علي بن حمدان بن محمد البلوشي **
المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مفهوم متداول أو شعار تتبناه المؤسسات؛ بل أصبحت واقعًا يفرض نفسه بوصفه أحد الأعمدة الرئيسة للتنمية المستدامة؛ فهي تعني التزام المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بالمساهمة في تحسين حياة المجتمع عبر مبادرات ومشاريع تخدم قضايا التعليم والصحة والبيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتكمن أهميتها في قدرتها على تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والقطاعات الاقتصادية من جهة، واحتياجات الأفراد والمجتمعات من جهة أخرى، لتخلق بيئة متكاملة يسودها التعاون والتكافل.
لقد أدركت الحكومات مبكرًا أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق بجهودها وحدها، وأن شراكة القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية عنصر أساسي لتعزيز برامجها الوطنية. هذا الإدراك دفعها إلى توجيه الأنظار نحو ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية باعتبارها وسيلة فعالة لتخفيف الأعباء عن الموازنات العامة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات. كما أن هذه التوجهات تمثل رسالة واضحة بأن التنمية ليست مسؤولية الدولة وحدها؛ بل هي مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، وأن سمعة الدول ومكانتها تتعزز حين ينعكس التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص على جودة حياة مواطنيها.
ولا شك أن هذا التوجه لن ينجح دون تعاون حقيقي من قبل الشركات الحكومية والخاصة في تخصيص بنود مالية صريحة ضمن ميزانياتها لدعم المشاريع المجتمعية. فالمبادرات التي تخرج من إطار التبرع العشوائي إلى إطار الدعم المنظم والمخطط تحقق أثرًا أعمق وأكثر استدامة، وتفتح آفاقًا أمام قطاعات حيوية مثل دعم رواد الأعمال، تمكين الشباب، تعزيز البحث العلمي، وحماية البيئة. فالمسؤولية المجتمعية في جوهرها استثمار طويل الأمد في الإنسان والمجتمع.
غير أن الطريق أمام الجهات المانحة ليس خاليًا من التحديات. فمن داخل المؤسسات، قد يواجه القائمون على هذا الدور ضعفًا في الحوكمة أو غياب الخطط الواضحة التي توجه الدعم نحو الأولويات الحقيقية. ومن خارجها، قد يبرز تحدٍ آخر يتمثل في غموض احتياجات الجهات المستفيدة، أو ضعف القدرة على قياس الأثر الاجتماعي للمشاريع المدعومة، مما يضعف الثقة ويؤدي أحيانًا إلى هدر الموارد. تجاوز هذه التحديات يحتاج إلى وضوح في الرؤية، وشفافية في تخصيص الموارد، وبناء شراكات قائمة على الثقة المتبادلة، فضلًا عن وجود آليات رقابية قادرة على المتابعة والتقييم.
أما فيما يتعلق بكيفية صرف الدعم المالي وضمان وصوله إلى المستحقين، فإن ذلك يتطلب آليات دقيقة تبدأ من دراسة احتياجات المجتمع وتحديد الأولويات، مرورًا بإقرار المشاريع وفق خطط واضحة، وصولًا إلى متابعة مراحل التنفيذ وتقييم النتائج. ومن أبرز الأدوات الفعالة في هذا المجال وجود لجان مستقلة تقيّم المشاريع، وإعداد تقارير مالية دورية تكشف أوجه الصرف، واستخدام مؤشرات أداء تقيس مدى تحقيق الأهداف. هذه الأدوات لا تضمن فقط الشفافية؛ بل تسهم أيضًا في تعزيز ثقة المجتمع في جدية المؤسسات الداعمة.
وإذا كان دور المؤسسات المانحة مهمًا، فإن الجهات المستفيدة من هذا الدعم لا يقل شأنًا، فهي الجهة التي يقع على عاتقها تحويل الدعم المالي إلى واقع ملموس يخدم الناس. ولتحقيق ذلك، تعتمد هذه الجهات على استراتيجيات متكاملة تقوم على التخطيط السليم، والاستفادة من الخبرات المتاحة، وإقامة شراكات مع جهات حكومية وخاصة، إضافة إلى تبني أنظمة متابعة دقيقة لقياس الأثر. فالموارد مهما كانت كبيرة لن تؤدي إلى نتائج مؤثرة ما لم تدار بكفاءة وشفافية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي النهاية، يبقى التأكيد أن المسؤولية المجتمعية ليست ترفًا أو خيارًا ثانويًا؛ بل هي التزام استراتيجي ينعكس على استقرار المجتمعات وازدهارها. إن ما تقدمه الشركات الحكومية والخاصة من مبادرات في هذا المجال يشكل إضافة نوعية لمسيرة التنمية، ويعزز مناعة المجتمعات في مواجهة التحديات. وحين تتضافر الجهود وتتسع دوائر التعاون بين جميع الأطراف، فإن النتيجة ستكون مجتمعًا أكثر قوة وتماسكًا، قادرًا على مواجهة المستقبل بثقة واستدامة.
** أستاذ مساعد بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم