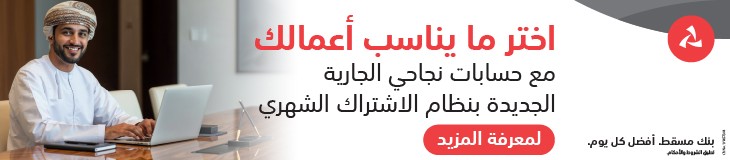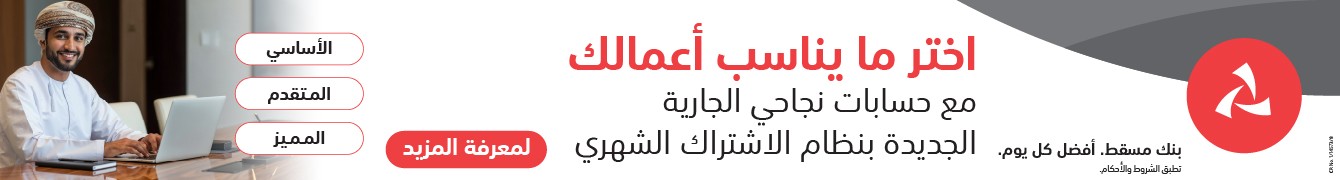تحقيق: ناصر أبوعون
- قال الشَّيخُ القاضِي الأجَلّ عِيَسى بِنْ صَالِحٍ بِنْ عَامِرٍ الطَّائِيُّ:[(ولَمَّا كَانَ السُّلْطَانُ الْمُعَظَّمُ تَيْمُور بِنْ فَيْصَل بِنْ تُرْكِي مُغْرَمًا بِالِاغْتِرَابِ وَالْأَسْفَارِ، مُوْلَعًا بِالسِّيَاحَةِ فِي الأَقْطَارِ؛ دَعَتْهُ نَفْسُهُ الْأَبِيَّة، وَهِمَّتِهِ الْعَلِيَّة، بِالسَّفَرِ إلَى مَمْلَكَتِهِ ظَفَار، - وإِنْ كَانَتْ عَاصِمَتُه نَازِحَةَ الْأَقْطَار-، فَاخْتَارَ مِنْ عَائِلَتِهِ مَنْ انَتَخَبَهُم لِصُحْبَتِهِ وأَرَادَهُمْ لِرِفْقَتِهِ مِنْ أَوْلَادِ عَمِّه وَأُخْوَتِهِ. وَكَانَ جَامِعُ هَذِهِ الرِّسَالَةِ مِمَنْ اِنْتَظَمَ فِي هَذِهِ الرِّفْقَةِ؛ فَخَطَرَ بِالْخَاطِرِ أَنْ أَجْمَعَ مَا أُشَاهِدُهُ بِهَذِهِ الرِّحْلَةِ لِتَحْصُلَ بِذَلِكَ لِقَارِئِهَا الْفَائِدَةُ؛ إِذْ كُلُّ عِلْمٍ لَيْسَ فِي الْقِرْطَاسِ ضَاعَ)].
[الوجه الشَّاذّ في (لمَّا)]
- قال الشَّيخ القاضي الأجَلّ عِيَسى بِنْ صَالِحٍ بِنْ عَامِرٍ الطَّائِيُّ [(ولَمَّا كَانَ السُّلْطَانُ الْمُعَظَّمُ.. فَاخْتَارَ مِنْ عَائِلَتِهِ)]، إنّ ابتداء الكلام بـ[(لمَّا)]، فيه توفيق وِفْق نظرية (النحو الوظيفيّ). وإذا ما نظرنا في علاقة [(لمَّا)]، بما بعدها وتوظيفها في المُركب الاسميّ أو الجملة العربية والتي هي "فعل لغوي يتميز بخصائص دلالية تداوليّة تعكسها خصائص بنيويّة صرفية تركيبية يستغلها مستعمل اللغة لتغطية احتياجات في عشيرته اللغوية(1)؛ فإذا هي على ثلاثة أوجه: الأول؛ بمعنى "لم" الجازمة الدالة على نفي المضارع وقلبه ماضيا ممتدًا إلى وقت الحدث مع توقّع حدوثه في المستقبل القريب؛ كما في قوله تعالى: {بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ}(2)، أي:(بل لم يذوقوا عذاب)، وشاهدُه الشعريّ نقرأه في قول جبلة بن الحارث:[( أَسْقِي بِهِ قَبْرَ مَنْ أَعْنِي، وَحُبَّ بِهِ* قَبْرًا إِلَيّ، وَلَمَّا يَفْدِهِ فَادِي قَبْرًا إِلَيّ، وَلَمَّا يَفْدِهِ فَادِي)](3)
وتأتي (لمَّا) في وجه آخر بمعنى "إلا"، في رواية حفص عن عاصم؛ قال تعالى: {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ}(4)، أي: أي: (إلّا عليها)، وهي لغة هذيل مع «إن» الخفيفة التي تكون بمعنى «ما»، والوجه الثالث، لها تأتي فيه (لمّا) بمعنى "حين"؛ فإذا رأيت لـ(لمّا) جوابا فهي لأمر يقع بوقوع غيره؛ كقوله تعالى:{فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ}،أي: (حين آسفونا)(5) وشاهدها الشعريّ في البيت المنسوب لمالك بن فهم الأزدِيّ:[( أُعَلِّمُهُ الرِّمَايَةَ كُلَّ يَومٍ* فَـ(لَمَّا) اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي)](6)
لكن الشيخ عيسى الطائي أتى بـ(لمّا) الشرطية التي تفيد التعليق، وتدخل على الماضي وتفيد الظرفيّة، وقرن جوابها بالفاء على شرط شاذٍّ تفرّد به "سيبويه" من بين سائر النحاة المُعتبرين فقال: [(ولَمَّا كَانَ السُّلْطَانُ الْمُعَظَّمُ... فَاخْتَارَ مِنْ عَائِلَتِهِ)]؛وشرط اقترانها بالفاء في هذا المثال، كونها اقتضت وجود جملتين وُجِدَت الثّانية:[(فَاخْتَارَ مِنْ عَائِلَتِهِ)] لوجود الأولى:[(ولَمَّا كَانَ السُّلْطَانُ الْمُعَظَّمُ)]. وهنا نلاحظ أنَّ جواب (لمّا) جاءَ فِعْلًا مَاضيًا:[(فَاخْتَارَ)]، غير أنّ "هناك حالة أخرى قد يكون جواب (لمَّا) جملة اسميّة مقترنة بـ(إذا الفجائيّة)، نحو (لمّا خرجتُ فإذا خالدٌ بالبابِ)، "وجوابها فعل ماضٍ لفظا ومعنى أو جملة اسمية مع (إذا) المفاجأة أو الفاء، وربما كان جوابها ماضيا مقرونا بالفاء وقد يكون مضارعا"(7) وهذا ما يجعل الاختصاصيين في علم النّحو يُطلقون عليها أسماءً مختلفةً مِثل "لمّا الشّرطيّة"، و"لمّا الحِيْنيّة"، و"لمّا التّوقيتيّة"، و"لمّا الظّرفيّة"، والجدير بالذِّكر أنّهم اختلفوا في كونها حرفًا أو اسمًا منصوبًا على الظّرفيّة(8).
[نسب السلطان تيمور]
- قال الشيخ القاضي الأجَلّ عِيَسى بِنْ صَالِحٍ بِنْ عَامِرٍ الطَّائِيُّ [(ولَمَّا كَانَ السُّلْطَانُ الْمُعَظَّمُ تَيْمُور بِنْ فَيْصَل بِنْ تُرْكِي)]؛ وفي هذا المقطع من مخطوطة "كَشْفِ السِّتَار عنْ حَالَةِ ظَفَار" أورد الشيخ عيسى الطائيّ اسم السلطان "تيمور" ثُلاثيًا، إلا أنَّ أقوال النَّسّابة الحاذقين تواترت على اختلاف مشاربهم، واتفقت على اسمه كاملًا بأنّه " تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي العتكي الأزدي "ابن المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سارف بن صبح بن كندة بن عمرو بن عدي بن وائل بن الحارث بن العتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو بن عامر ماء السماء"(9) بن حارثة بن امرؤ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد المعروف بـ(زاد الركب) بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود- عليه السلام- بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن نوح- عليه السلام- بن الملك بن متشولخ بن أخنوع بن الياء بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم- عليه السلام- أبو البشرية".
[نواة دولة المؤسسات]
وتذكر المصادر التاريخية أنّ (السلطان تيمور) كانت له اليد العليا في وضع النواة الأولى في بناء دولة المؤسسات بتشكيله (أول مجلس وزراء 1920 – 1932) برئاسة شقيقه السيد نادر بن فيصل بن تركي، وضَمَّ في عضويته (الشيخ محمد بن أحمد الغشّام والي مطرح وزيرًا للمالية، والشيخ القاضي راشد بن عزيّز وزيرًا للشؤون الدينيّة، والشيخ زبير بن علي وزيرًا للعدل) وسعى إلى تطوير وتنمية الإدارة المالية للدولة، بإصلاح (المنافذ الجمركية) بالاستعانة بخبراء من مصر في عشرينيات القرن الماضي؛ وهم: (عبد السلام حسين غنّام، وأحمد زكي عبده، وعبد الله أفندي مدير جمرك مسقط، وأحمد حمدي أفندي مدير جمارك مطرح)، و"السلطان تيمور أول من أصدر قانونًا للخدمة العسكرية عام 1916م اشتمل على نظام الرواتب والعلاوات والمكافآت والعقوبات والجزاءات وغيره، كما عمل على تطوير النظام الجمركي في ميناء مسقط، وتنظيم الإدارة المالية، بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي"(10).
وفي شهر شعبان سنة 1337 أنشأ السلطان تيمور بن فيصل أول نظام قانونيّ بفرعين: محكمة عدليّة، وأخرى تجاريّة، ترأسهما أخوه السيد نادر. وفي إطار بحثه عن موارد مالية لإنعاش الاقتصاد العُمانيّ وافق على منح أول امتياز قانونيّ للتنقيب عن النفط في عُمان في 25 شوال 1343 هـ الموافق 18 مايو 1925 مع شركة دارسي البريطانية المحدودة، واعتُمِدَ هذا الامتياز من قِبَل السيد نادر نيابة عن السلطان الذي كان في رحلة إلى الهند(11)، ولإيمانه بأنّ التقدّم الحضاريّ مرهون بتوظيف الموارد لتحريك عجلة الاقتصاد. ولن يتحقق ذلك الهدف إلا بالاستقرار السياسيّ للدولة لذا سعى منذ بداية حكمه إلى إيجاد نوع من التفاهم بينه وبين (الإمامة) مستعملا كافة الوسائل الممكنة لإنهاء هذا الصراع. وفي تاريخ 11 من محرّم 1339هـ الموافق 25 سبتمبر 1920م، وقّع على بنود اتفاقية السيب(12). وإبان حكمه تأسست (المدرسة السلطانية الأولى)، واستقدم مدرسين عربًا لهذه المهمّة، فتأسست في عهده أول مدرسة نظاميّة عام 1914م، واشتُهِرت بين أهل عُمان باسم مديرها ومعلمها الفلسطيني بـ(مدرسة محمد علي أبو زينة)(13) والذي عمل معلما قبلها بمدرسة (الزواويّ) غير النظاميّة التقليدية الأشبه بالكتاتيب القديمة(14)،وسرعان ما تركها وأسس مدرسة حديثة في مناهجها وخطتها الدراسيّة، لينتظم في مقاعدها البنين والبنات وجمعت في مقررها الدراسيّ بين القرآن الكريم والجغرافيا والتاريخ والعلوم الحديثة والرياضيات الأوليّة(15)، ثم في خطوة تقدميّة تالية افتُتح السلطان تيمور في أواخر أيام حكمه المدرسة (السلطانية الأولى)عام 1930م. وذلك فضلا عن دوره القوميّ التقدميّ في احتضان قائد الثورة الليبية ومؤسس أول جمهورية في طرابلس الغرب سليمان باشا البارونيّ بعد أن صار طريدا ومطلوبًا من الطليان والإنجليز والفرنسيين، وأوكل له العديد من المهام السياسية، واستقبله بوفد رسميّ وجماهيري ورسم للشيخ عيسى بن صالح الطائي قاضي القضاة بمرافقة الباروني بداية من 27 من صفر 1343هـ، الموافق 26 سبتمبر 1924م في تطوافه في ولايات مسقط وعمان، بمعيّة أخيه القاضي محمد بن صالح الطائيّ وابنا خالهم الشيخان أحمد وسليمان ابنا العلامة الشيخ سعيد بن ناصر الكنديّ .
[لا ترادف بين ألفاظ العربية]
قال الشيخ القاضي الأجَلّ عِيَسى بِنْ صَالِحٍ بِنْ عَامِرٍ الطَّائِيُّ [(ولَمَّا كَانَ السُّلْطَانُ الْمُعَظَّمُ تَيْمُور بِنْ فَيْصَل بِنْ تُرْكِي مُغْرَمًا بِالِاغْتِرَابِ وَالْأَسْفَارِ، مُوْلَعًا بِالسِّيَاحَةِ فِي الأَقْطَارِ دَعَتْهُ نَفْسُهُ الْأَبِيَّة’ وَهِمَّتِهِ الْعَلِيَّة، بِالسَّفَرِ إلَى مَمْلَكَتِهِ ظَفَار)]، في هذا المقطع لطيفتان يمكن الوقوف عليهما؛ أمّا اللطيفة الأولى، فتجلّت في توظيف الشيخ عيسى الطائيّ (الازدواج والسجع) كمُحَسِّنين لفظيّين، يتعاونان في إطار صِنْعَة جمالية تتقطّع فيها الجمل المتوالية، وتتوازن فيها الوحدات اللغوية طولا وتنغيمًا ونبرًا وموسيقى للتأثير في القراء والسامعين على السواء، وتشتغلان على إيقاع المعنى المراد في النفس قاصدا التَّخبيب بالسفر والحضّ عليه.
أمّا اللطيفة الثانية فتحصّلت بالتأمل في استعمال الشيخ عيسى الطائيّ لمفردتي [(مُغْرَم)] و[(مُولَع)] حيث لا وجود البتةَ للترادف في المعنى بين الكلمتين، ومن ثَمَّ فلا يظن واهمٌ أنَّ في العربية ترادفٌ أو مساواة بين معاني الألفاظ؛ وذلك لكونها لغة نحت واشتقاق وتجدد، حيث تتابين وتتبدّل معاني مفرداتها بتغيّر السِّياق. وعليه فـ(المُغْرَم) صفة معتادة تلازم صاحبها إذا تعلّق بشيء فلا يصبر على فراقه، وينطوي في معناه على مشقة وكلفة ونفقة. ومنه قول النَّمِر بن تَولَب الْعَلْكِيّ:[( فَظَلَّ يَشِبُّ، كَأَنَّ الْوُلُو* عَ كَانَ بِصِحَتِهِ "مُغْرَمَا")](16)
بينما (مُولَع) بفتح اللام فمقصودها مُغْرَى بالشيء، وفي المعجم الوسيط دالة على (الشغف)، ولزوم الشيء والحرص عليه دون مفارقته، ومنه حديث (أنه كان مولعا بالسواك)، وشاهدها الشعريّ قول الخنساء:[(مُوْلَعًا بِالسَّرَاةِ، مِنَّا فَمَا يَأْ*خُذُ إِلَّا المُهَذَّبُ الغِطْرِيْفَا)](17)
[الاغتراب إسقاط نفسي]
ثم قرن الشيخ عيسى الطائي بين مصدرين قد يبدوان على النقيض وهما [(الاغتراب) و(السياحة)]؛ فأمّا الاغتراب فهو فضيلة، عاشها الشيخ عيسى واقعا أيام عزلته الاختيارية إبّان اشتداد حدة الصراع بين (جيش السلطان تيمور) و(فصائل الإمامة)، وبعد أن نقضت الأخيرة غزلها من بعد قوة أنكاثا، ودانت كل عمان من أقصاها إلى أقصاها للسلطان تيمور، وإرسال أفراد من أسرة الطائي إلى غياهب السجون بعد أن تبين أنّ بعضهم شارك جيش الإمامة في المعركة التي وقعت عند بيت الفلج يوم 23 من صفر 1333هـ الموافق 9 من يناير 1915م ومن بينهم: (موسى بن صالح بن عامر الطائي أخو الشيخ عيسى، ونصر الله وسليمان وأحمد أبناء خاله)، ومن بعدها ارتأى الشيخ عيسى (الاغتراب) عن مسقط وتوجّه إلى سمائل؛ فلمّا أن قضى بها 7 سنوات رغب العودة إلى مسقط فنظم قصيدة بعنوان (لاح برق) فتأثر بها السلطان تيمور – عاشق الأدب والشعر والسياحة والسفر) فاستدعاه للعودة، وأصبح منذ ذلك اليوم صديقًا خاصا يثق به ويستشيره(18)، ولأن "المرء مخبوء تحت لسانه"(19)، ويظهر باطنه في فلتات لسانه؛ فإن المقصود – تأويلا - من مفردة (الاغتراب) التي ساقها الشيخ عيسى في قوله:[(مُغْرَمًا بِالِاغْتِرَابِ وَالْأَسْفَارِ)] إشارة وإسقاط نفسيّ وتلميح منه على سنوات عزلته الاختيارية التي قضاها في ولاية سمائل، أمّا في الاصطلاح اللغوي فتعني :"النزوح والابتعاد عن مسقط رأسه"، وعليه يكون (الاغتراب) قيمة إنسانية، وسُنَّة إسلامية مهجورة حضَّ عليها ابن القيم الجوزية في كتابه (مدارج السالكين) بقوله: "فإيّاك أن تستوحش من الاغتراب والتفرّد.. فإنّهُ والله عينُ العِزّة؛ بل الصادق كُلَّما وجدَ مسّ الاغترابِ، وذاقَ حلاوتَه، وتنسّم رُوحه؛ قال: اللّهم زِدْني اغتراباً، ووحشةً مِنَ العالَم، وأُنساً بِك"، وشاهدها في قول العنبر بن عمرو التَّميميّ:[(قَدْ رَابَنِي مِنْ دَلْوِيَ اضْطِرَابُها*والنَّأْيُ فِي بَهْرَاءَ واغْتِرَابُها* إِنْ لا تَجِيء مَلْأَى تَجِيءُ قِرَابُهَا)](20)
[رفقاء الرحلة]
- قال الشيخ القاضي الأجَلّ عِيَسى بِنْ صَالِحٍ بِنْ عَامِرٍ الطَّائِيُّ [(فَاخْتَارَ مِنْ عَائِلَتِهِ مَنْ انَتَخَبَهُم لِصُحْبَتِهِ وأَرَادَهُمْ لِرِفْقَتِهِ مِنْ أَوْلَادِ عَمِّه وَأُخْوَتِهِ)]، وبالبحث عمن رافق السلطان تيمور في رحلته إلى ظفار هذه السنة عثرنا في الوثائق على بعضٍ منهم؛ تمّ ذكرهم والإشارة إليهم خارج مخطوطة "كشف الستار عن حالة ظفار" فكان منهم: وزير العدلية الشيخ الحاج الزبير بن علي(21)، والميجر وينجيت wingate القنصل والمقيم السياسي العام في مسقط وماك كولوم Mac Collum المعين كوزير من قِبَل السلطان تيمور، ولعب الاثنان بالتشاور مع الشيخ عيسى الحارثي ووساطة العلامة الشيخ سعيد بن ناصر الكندي دورا محوريا في إبرام اتفاقية السيب 1920(22)، أمّا الشخصية الثالثة فكان بروترام توماس وزير مالية للسلطان تيمور من 1925 -1932م(23)، ورابعهم الشاعر سعيد بن مسلم بن سالم الجابري المجيزي السمائلي (1281هـ -1370هـ) المُكنّى بـ(أبي الصوفيّ) والمُلقَب من جهة السلطان تيمور بـ(شاعر الأسرة المالكة)(24) ، وفي ظفار أنشد قصيدة في قال فيه:[(تيهي ظفار فقد شُرفت كمثلما* تيمور قد شرفت به الأيام/ أصبحت في روض السعادة ترتعي* والناس في أمن المليك نيام/ والعز في مثواكِ أضحى راتعا* وعلى حصونكِ تُنشر الأعلام/ أمسيتِ في وجه الممالكِ غرة* وذوُوْكِ في فلكِ السُّعود قيام/ فالقِ الزمامَ بكف أروع باسلٍ* فيمينه لك حارسٌ وزمام/ قد كنتِ كالرعديد مرتعد القوى* ينتاشكِ الضيؤون والضرغام/ حتى أتاك أبو سعيد فاستوت* بأمانه الأوهادُ والآكام/ فظباك في أنسِ الكناس أوانسٌ* والطيرُ في وكناتهن نيام/ فليهنَ قطرك يا ظفار بمربعٍ* لأبي سعيد طال فيه مقام/ ملكٌ أرق من النسيم خلائقا* وَأشدّ خُلقا إذ يكون خصام/ لا يحذرنَ من المخاوف جارُه* أبدا وليس أخو الجوارِ يُضَام/ أندى من المطرِ الملثّ نداؤه* وَأجل مهما عدَّتْ الأوهام/ وأحدّ من نظر العليم ذكاؤُه* فتحار من تخمينه الأفهام)].
[لا يخالف نصّ القرآن]
- قال الشيخ القاضي الأجَلّ عِيَسى بِنْ صَالِحٍ بِنْ عَامِرٍ الطَّائِيُّ [(فَخَطَرَ بِالْخَاطِرِ أَنْ أَجْمَعَ مَا أُشَاهِدُهُ بِهَذِهِ الرِّحْلَةِ لِتَحْصُلَ بِذَلِكَ لِقَارِئِهَا الْفَائِدَةُ؛ إِذْ كُلُّ عِلْمٍ لَيْسَ فِي الْقِرْطَاسِ ضَاعَ)]. وهنا لطيفتان استوجب المقام الإشارة إليهما؛ أمّا الأولى فتستبين بفهم التركيب والبناء اللغوي للجملة العربيّة؛ وإذا ما احتجّ البعضُ بأنّ عبارة [(كُلُّ عِلْمٍ لَيْسَ فِي الْقِرْطَاسِ ضَاعَ)] لاتصحُّ لمخالفتها صريح الآية 49 من سورة العنكبوت في قوله تعالى: {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ}. نقول: إنّ مقصود الشيخ عيسى الطائيّ، وهو العارف باللغة وعلومها بجملة (كُلُّ عِلْمٍ) فيها (استثناء محذوف) تقديره: (غير القرآنِ)، أو (باستثناء القرآن)، أو (خلافا للقرآن). ويدعم حُجّتنا أنّ جملة [(كُلُّ عِلْمٍ لَيْسَ فِي الْقِرْطَاسِ ضَاعَ)] جاءت خالية من التوكيد (اللفظيّ) و(المعنوي)، فلو كان أصلها: (كل العلوم جميعها أو جُلّها، أو كلها) لخالفت صريح الآية القرآنية وليس من الجائز تأويلها أو تخريجها نحويًّا.
أمّا اللطيفة الثانية فإن كلمة [الْقِرْطَاسِ] مُثَلَّثة بكسر القاف (قِرْطاس)، و(قُرطاس) بضمّها، و(قَرطاس) بفتحها، والجمع: (قَرَاطِيس) ليست عربية قِحّة، بل أصلها يونانيّ (χάρτης)((khártē(25)واستعملها القرآن في موضعين من سورة الأنعام: {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَـٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ}(26){تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ}(27)، ومن شواهده قول عصام الكنديّة تصف امرأةً لمَن همّ بخطبتها:" مِنْ تَحْتِ ذَلِكَ بَطْنٌ طُوِيَ كَطَيّ القَبَاطِي المُدْمَجَة، كُسِيَ عُكَنًا كَـ(القَرَاطِيسِ) الْمُدْرَجَة"(28)
...............
المصادر والمراجع والهوامش:
(1) يحيى بعيطيش، العقل اللغوي بين الفلسفة والنحو (عرض تأصيل لمفهوم العقل اللغويّ لدى فلاسفة اللغة ونظرية النحو الوظيفيّ)، ضمن كتاب: حافظ إسماعيل علويّ، التداوليات (علم استعمال اللغة)، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط 1، 2011
(2) سورة ص، الآية: 8
(3)الأمالي لأبي علي القالي(ت،356هـ)، تحقيق: محمد عبد الجواد الأصمعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1975، 2/360
(4) سورة الطارق، الآية: 4
(5) تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوريّ(ت ٢٧٦هـ)، باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف، حرف (لمَّا)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ص: 290
(6) شعراء عُمان في الجاهلية وصدر الإسلام، جمع وتحقيق: أحمد محمد عبيد، المجمع الثقافي، أبو ظبي(1420هـ 2000م)، ص:86
(7) التسهيل: 241، وانظر أيضا: الرضى: 2/ 119
(8) أنواع "لما" في القرآن الكريم، نزار عطا الله أحمد صالح (2014)، دراسات- علوم الشريعة والقانون، العدد:3، المجلد:14، ص ص: 919/930، وأدوات الإعراب، شوكت البياتي، ص: 212
(9) السادة السلاطين البوسعيديون، وفي القلب منهم (آل سعيد)" الذين حكموا عُمان ومازالوا يتوارثون حُكمها يشتركون جميعًا في جدِّهم الأعلى (المُهلّب بن أبي صفرة)، وهذا ما أجمعت عليه كتب الأنساب جُلّها وأجملها الدكتور سعيد بن محمد الهاشميّ، أُستاذ التاريخ بجامعة السلطان قابوس، في بحث له بعنوان: (أصول المهالبة نسبًا ومكانًا) استنار فيه بالكتب المعتبرة في علم الأنساب من أمثال: (نسب معد واليمن) لابن الكلبيّ ج2، ص:466، و(الاشتقاق) لابن دريد، ص:482، و(جمهرة أنساب العرب) لابن حزم، ص:366، و(الفتح المبين) لابن رزيق، ص:33،21.
(10) ملامح من تطور النظام الإداري في سلطنة عمان، صالح الفارسيّ، ط 1، نسخة إلكترونية مطابقة للمطبوع، مكتبة: طريق العلم، ص ص: 71،70، 2013
(11) شخصية عمانية بارزة: تعرف على أول رئيس مجلس وزراء في السلطنة، إعداد: د. محمد بن حمد العريمي، صحيفة أثير الإلكترونية، السبت , 25 سبتمبر 2021م
(12) كتاب: (الشيخ عيسى بن صالح الطائي، قاضي قُضاة مسقط)، د. محمد بن حمد العريميّ، مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر، ط1، 2024م، ص: 109.
(13) ذكر الموقع الإلكترونيّ "للمتحف الوطنيّ العُماني" إشرافه على إعادة تأهيل وترميم (مدرسة أبو ذينة)، ضمن مخطط ثلاثي يضم بجانبها (بيت السيد نادر)، وبيت (السيدة مُزْنة بنت السيد نادر آل سعيد)، في إطار الهدف الذي أعلنت عنه إدارة المتحف ويتمثل في تطوير منطقة مسقط التاريخية وتحويلها إلى "مزار ثقافي يبرز أنماط معيشة أسرة البوسعيد الحاكمة الكريمة قبل بزوغ فجر النهضة الحديثة".
(14) ينتمي المعلم محمد علي أبو زينة إلى عائلة فلسطينية كريمة تعيش الأجيال الجديدة منها الآن في (مدينة الخليل)، وتعود أصولهم إلى قرية (قطنة) المشتقة من الفعل (قطن) أي استوطن، وتمّ بناؤها فوق أطلال (الكفيرة) التي كانت من مدن كنعان وقد ورد ذكر (الكفيرة) أربع مرات في التوراة، ولقد قامت قطنة الحديثة في العام 1000 هجرية، ويحيط بـ(قطنة) كثير من الخرب (جمع خِربة وهي القرية الصغيرة) القديمة ومنها (خربة البويرة) التي تعود إلى عائلة أبو زينة والتي تضم معصرة زيتون قديمة، ما زالت بعض آثارها باقية إلى اليوم، وتفرعت القبيلة إلى بطون وأفخاذ كثيرة رحلت إلى مصر وليبيا وتونس.
(15) نشرت مبادرة (قلعة التاريخ التطوعية) في صفحتها على (الفيسبوك) بتاريخ 17 من ديسمبر 2014 صورة المدرسة وذكرت أنّ مدرسة (أبوذينة) اشتملت على خطة دراسية كاملة تكونت من ست حصص يوميا، وكان اليوم الدراسي يبدأ من الصباح إلى الظهر، وبلغ عدد طلابها (120) طالبا وطالبة يدرسون جميعا في غرفة واسعة، ومن الطلاب الذين درسوا في هذه المدرسة السلطان السيد سعيد بن تيمور، والسيد شهاب بن فيصل. وفي عام 1930 انتقل (أبوذينة) بتلاميذه إلى (المدرسة السلطانية الأولى) التي أنشأتها الحكومة آنذاك. وأبو زينة.
(16) ديوان النَّمِر بن تَلَب العلكيّ، جمع وشرح وتحقيق: محمد نبيل طريفيّ، دار صادر، بيروت، ط1، 2000، ص: 120
(17) أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء، اعتنى بضبطه ووتصحيحه وجمع رواياته والتعليق على حواشيه وفهارسه لويس شيخو، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 1986، ص: 168.
(18) كتاب قاضي قضاة مسقط، محمد العريمي، مرجع سابق، ص ص: 113، 115.
(19) الإمام علي بن أبي طالب، نهج البلاغة، ج2، ص: 181.
(20) شعر بني تميم في العصر الجاهلي، جمع وتحقيق: عبد الحمديد المعيني، منشورات نادي القصيم الأدبي، بريدة، 1982/472
(21) وزير العدلية في أول مجلس وزراء عُماني وأول شخص مُنح وسام حكومة سلطان مسقط وعُمان، وكان الكاتب الأول للسلطان تركي بن فيصل، وكان مرافقاً للسلطانين فيصل بن تركي وولده السلطان تيمور بن فيصل.
(22) الدور البريطاني في عقد اتفاقية السيب، د. فاضل محمد الحسيني، عدد19، 1996م
(23) عبر الربع الخالي سنه 1930-1931م، انطلاقًا من ظفار وصولا إلى إلى الدوحة، ودونها في كتابه Arabia Felix المنشور سنة 1932م، وسبقه بكتاب آخر بعنوان The Arabs سنة 1930م. وفي 2002 أصدرت مؤسسة العارف للمطبوعات "مذكرات برترام توماس" بترجمة: كامل سلمان الجبوري وعبد الهادي فنجان.
(24) ديوان أبي الصوفيّ، حققه الدكتور حسين نصّار، ط 1، وزارة التراث القومي والثقافة 1982.
(25) راجع كتاب (المعرّب من الكلام الأعجميّ) للجواليقي، ص: 324
(26) سورة الأنعام، الآية: 7
(27) سورة الأنعام، الآية: 91
(28) العقد الفريد، ابن عبد ربّه الأنلسيّ (ت، 328)، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتَّبَ فهارسه: أحمد أمين وآخرون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط3، 1973، 6/111